يبدأ حسن حنفي مشروعه الفكري برفض الفكر الديني التقليدي شكلاً ، ويقوم بنقد طريقة القدامى في البناء النصوصي لمؤلفاتهم ، فيقول :
(في هذه المقدمات الإيمانية تتحددُ علاقة الإنسان بأنه فقط ليس فقط على مستوى المعرفة والنظر بل أيضاً على مستوى السلوك والعمل ، فالإنسان يحمد الله على نعمه ويشكره ، على فضله ، مما يجعل العلاقة أحادية الطرف ، من واهب (إلى) موهوب ، ومن معطى إلى معط إلى ، وتجعل الإنسان مجرد وعاء للنعم ، ومستقبل للعطايا (…) وإن كثيراً من مآسي عصرنا لهو انتظار الكرم والجود ، والتشوق إلى الهدايا والعطايا ، والتزلف من أجل هبات السلطان حتى أصبح العصر كله عصر تعايش وارتزاق . .)، (1).
إن أي فقرة لدى حسن حنفي تعطينا طريقة التفكير ، حيث يجري الدخول إلى عصر ما واقتطاع فكرة أو عبارة ، ثم رؤيتها بطريقةٍ ذاتية ، أي من خلال وعي الكاتب المنفصل عن البنية الاجتماعية ، ثم الحكم عليها عبر ذلك الشعور ، ومن ثم الانطلاق بها إلى عصر آخر مغايرٍ وذي حيثيات مختلفة ، وإسقاط المعنى المستلِ على العصر الجديد المختلف .
فطريقة المؤلفين العرب والمسلمين في الثناء على الله وحمد رسوله والسلف الصالح الخ . . ذات نسق مرتبط بعصر تكرست فيه مثل هذه اللغة والمعاني الدينية التي هي مقدمة لأي بحث ، سواء لدى جماعة أهل الحكم أو جماعة المعارضة لأهل الحكم ، وهذه الطريقة التأليفية قام المؤلفون العرب والمسلمون بتجاوزها في زمن النهضة بدءً من القرن التاسع عشر لكن حسن حنفي يعيدنا إليها ، موجعاً القارئ بالهجوم على طريقةٍ غدت في ذمة التاريخ ، لكن الكتاب ليس بحثاً في طرق تأليف الكتب ومقدماتها ولا يعتبر طرق التأليف كبؤرة لمؤلفه بل هو يريد أن يناقش التراث والعصر.
ولهذا نجد الفقرة تقفز من نقد طريقة المؤلفين القدامى ولا تقوم بدرس أسباب هذا الإنشاء إلى أن تعمم قائلة إن هذه الطريقة هي باب للكثير من المشكلات ، (وإن كثيراً من معاني عصرنا لهو انتظار الكرم والجود).
فهو يقفز من قضية طرق التأليف القديمة قبل عشرة قرون إلى الزمن الحالي مصوراً بأن طريقة المؤلفين القدامى في الثناء على الله هي من أسباب النفاق المعاصر!
إنه استلالٌ لعنصر تراثي من بين شبكته الواسعة وتعليقه في فضاء لاتاريخي مجرد ، ثم سحبه إلى بُنى اجتماعية أخرى لها سيرورات مختلفة وقوانين متغيرة ، عبر شحنٍ عاطفي وتدفق لغوي.
إن المؤلفين القدامى حين يحمدون الله على طريقتهم فلا يعني هذا بأنها طريقة لتكريس السلبي ومدح السلاطين ، فهي طريقة تقليدية يقوم بها المنتمي للسلطة والمعارض لها ، وهي جزءٌ من بناءٍ ديني ثقافي خاص بالعصر السابق ، لكن طريقة المؤلف تقوم على الاستفزاز والنفخ العاطفي والاستعراض .
وثمة جمل في هذه المقدمة التي تقدم المشروع الفكري لحسن حنفي تنسف المشروع كله مثل هذه العبارة :
(كانت تجارب القدماء في أغلبها صوفية وفي أقلها علمية نظرية ، وبالتالي خلت من أي مضمون اجتماعي ، وكيف يهتز العالم كله من مجرد تجربة ذوقية شخصية تعتلجُ في صدر صاحبها ، ويموج بها قلبه ، ويهتز لها وجدانه ؟ ..(. .) انما تجاربنا نحن فهي اجتماعية بالأصالة ، تجارب ذات مضمون ، وضعناها في التراث . .) ،(2).
تعطينا هذه العبارة تعميماً عن الصوفية والنتاج الثقافي بنسبة غير دقيقة ، ثم أن وجود نتاج بلا مضمون اجتماعي ، هو كلام غير علمي . ثم يقوم بسحب الصوفية إلى عصرنا ويجري التدفق اللغوي العاطفي والمليء بالاستطرادات التي تحاول النفخ في تلك الفكرة.
إن العبارة هنا تكرس تناقضات مطلقة غير جدلية : صوفية بلا مضمون ، صوفية معاصرة ذات مضمون ، فكر غير اجتماعي ، فكر اجتماعي .
سوف نجد إن هذه الطريقة التعبيرية – الفكرية هي منهج المؤلف ، فهو وعي يعيش التضادات المطلقة ولا يستطيع أن يجمع بينها ويدرسها بشكل جدلي .
يقوم بعد ذلك بدرس التراث الإسلامي بمناقشة مصطلحاتها كمصطلح (علم الكلام). لنأخذ عبارة من حديثه عن نشأة علم الكلام هذا:
(أما السؤال الذي من أجله تطايرت الرقاب وقضى على الحريات ، وقاسى المفكرون بسببه أشنع أنواع الاضطهاد وهو : هل الكلام قديم أم محدث؟ فإنه ينطبق على سائر الصفات)، (كما وصل الخلاف إلى حد القتال وشق الأمة إلى فرق متنازعة متحاربة في موضوع الإمامة ، آخر موضوع في السمعيات)،(3).
يقومُ المؤلفُ هنا بالقفز على نمو علم الكلام ، حيث استغرق الأمر في ذلك قرناً كاملاً نمت هذه المسألةُ من بذورٍ صغيرة حتى غدت بؤرةً للصراع الفكري والسياسي ، ففي البداية لم يكن هناك شق(للأمة) ، ثم مع تفاقم الصراع الاجتماعي فإن الطبقات والأمم الإسلامية راحت تعبرُ عن نفسها من خلال المقولات الدينية المختلفة ، وهنا نجدُ في طريقة حسن حنفي عدم القدرة على بحث المسألة بتأنٍ ورؤيتها وهي تتداخل مع العناصر الأخرى ، فهو سرعان ما يقفز إلى النتائج بدون تحليل بنيوي،(4).
أي أنه لا يقوم بتتبع المسائل النظرية وهي تتشكلُ في بناها الاجتماعية ، فنجد تعبير (وصل الخلاف إلى حد القتال وشق الأمة) وهي تعبيرات تختزل التاريخ المعقد الطويل وتجوهر الأمم الإسلامية في تعبير (الأمة) وكأن الصراعات لم تبدأ منذ البداية وذات مخاض اجتماعي قبلي – قومي – طبقي ، ولكن هذا لا يحدث في بناء حسن حنفي لأنه لم يقم بوضع مقدمات لمثل هذا الدرس ، فهو يقفز فوراً إلى علم الكلام ، ثم إلى صراعات الأمة المقدسة بلا تمهيد تاريخي وبلا درس اجتماعي .
يقدم لنا حسن حنفي بعد ذلك النتائج التالية عن علم كلام:
(الكلام الأول (كلام الله) لا يمكن معرفته معرفة مباشرة إلا من خلال الكلام الثاني (القرآن).
(وفي هذه الحالة يمكن للكلام باعتباره الوحي الموجود أمامنا . .). ( يمكن لهذا الكلام أن يكون موضوعاً للعلم بل لعدة علوم . .)، ص 59.
إن المؤلف هنا يدخلنا في علم الكلام وهو مقطوع الجذور ، ثم يستنتج بأنه خلاف حول علم الله والقرآن وأن الأول لا نعرفه والثاني هو تجسيد للأول ، وكل هذا اقتطاع لسيرورة التاريخ أي لعمليات درس المصطلحات : الله ، الإله الواحد ، اللغة الإلهية وتاريخها ، القرآن ، الفرق ، تأويلات القرآن عند الفرق الخ . .
إن مسألة علم الكلام تــُطرح وهي مقطوعة السياقات ، ولا يتم بحثها كتطورٍ فكري طويل متداخل مع الصراعات الاجتماعية بل كجوهر نصوصي بلا سياق تاريخي ، وإذا جرت الإشارة للخارج فهي إشارة طيفية ، فالداخل أو المبنى الفكري ، أي علم الكلام هنا ، يجري تطوره من داخله وليس باعتباره جزءً من كل هو البنية الاجتماعية التي ينمو داخلها .
ثم يستنتج علوماً ينبغي أن تدرس علم الكلام ومنها علم السياسة:
(ويمكن لعلم السياسة البحث عن نشأة علم الكلام في ظروف سياسية خاصة ، واستعمال الوحي لإفراز أما تراث السلطة أو تراث للمعارضة كما هو واضح في أدبيات الفرق ، ومدى استمرار ذلك حتى الآن في علاقة السلطة بالمعارضة واعتماد كل منهما ، خاصة السلطة على الموروث العقائدي القديم)، ص60.
ونستغرب لماذا لم يقم الباحث بقراءة ذلك وهو موجود حتى في المراجع الفكرية المعاصرة ككتب أحمد أمين وحسين مروة ومحمود إسماعيل وبالتالي أن يقوم بالدرس السياسي لعلم الكلام؟
فمثل هذا الدرس سيجعله يقرأُ علمَ الكلام بصورة عميقة كلية وليس بطريقة تفتيتية تزيح دلالاته العامة ، ولهذا فهو يعتذر للقارئ عن عدم قيامه بهذا الدرس الاجتماعي والسياسي فيقول في الهامش (تقـتصر مهمة التراث والتجديد على وضع (علم الكلام) داخل (تاريخ الأفكار) . أما وضع (تاريخ الأفكار) في (التاريخ الاجتماعي) وتطبيق كل نتائج ونظريات ومناهج (علم اجتماع المعرفة) فتلك مهمة مجموعة من الباحثين تضم المفكرين وعلماء الاجتماع معاً ، وينؤُ بها باحثٌ واحد . فهذا ميدان للبحث وليس موضوعاً للبحث ، وقد بدأ كثيرون في المساهمة في ذلك فيه مثل د . محمود إسماعيل (سوسيولوجيا الفكر الإسلامي، جزءان . .)، ص 61. (سوسيولوجيا الفكر الإسلام من أربعة أجزاء، ملاحظة مني ع. خ).
والواقع إن الحجة هنا شكلية فهذا المؤلف الضخم الذي يدخل تفاصيل علم الكلام والفلسفة والمذاهب المختلفة كيف يعجز عن رؤية الأبعاد الاجتماعية التي يتشكلُ داخلها علمُ الكلام وغيره؟!
إن المسألةَ إذن ليست مهمةً ينؤ عنها باحثٌ بمفرده بل مسألة منهج ، ولكن المؤلف يعرض ذلك السبب العرضي لأنه سيستفيد في بعض الفقرات من المنهج الاجتماعي في قراءة التراث ، ولكن بشكلٍ وامض وبلا قيمة فكرية .
إن استخدام هذا المنهج بشكل عرضي والإيمان الغائر به داخلياً وغير المتبلور نظرياً هو صلب الإشكاليات الكبرى التي يعاني منها المبنى الفكري لحسن حنفي .
إذن هناك منهج آخر لم يصرح به المؤلف وعلينا أن نقرأ هذه المبنى وكيف تجسد في حيثيات الدراسة المختلفة .
ولنلاحظ كلمة (الوحي) في العبارات السابقة فهي مفتاح فهم هذا العالم ، فالوحي وصورة الإله التي تخلقه هما شيئان تجريديان مضيئان متجوهران في هذا النقاء الغيبي ، وهما منطلقا المشروع وأساسه لكن الباحث لا يقول لنا لماذا هذا النقاء التجريدي والتجوهر؟
أي أن حسن حنفي لا يقول لنا بأن هذا العنصر المثالي ، أي الفكري التجريدي هو الذي يخلق المادة ، فهو لا يوضح مصدر فلسفته وانتماءها وهل هي مادية أم مثالية ؟ لكن طريقة الطرح المتوارية التي تأتي في فيض لغوي هي جزء من المنهج الحربائي الذي يستخدمه كذلك .
وإذا كان العنصران التجريدان النقيان المضيئان يخلقان العالم ، وهو هنا الإسلام ، فلماذا يدخل التناقض في العالم المخلوق من مصدر لاتناقضي ؟ أي كيف يخلق ما هو نقي ما هو ملوث؟ وكيف يصدر الشر عن الخير والمظلم عن المضيء؟
وبطبيعة الحال في عالم حسن حنفي لا تــُطرح مثل هذه الأسئلة ، بل هي تنبث مقطعة مفتتة ، في ثنايا ذلك الفيض اللغوي – الفكري – الاجتماعي – القديم – المعاصر .
ولكن بما أن الوحي يخلقُ العالمَ فهو يتجسد في نص هو القرآن ، وحسن حنفي يقطعُ هنا بين سيرورة التشكل بين الاثنين : الوحي والقرآن ، كما يقطع بين الإله والوحي ، ولهذا نجد أنفسنا عابرين الهوة التجريدية بين الوحي والواقع ، بين عالم الضياء وعالم الفساد ، بين عالم النقاء المتجوهر وعالم الحس والحركة والنقص .
تنقلب العلاقةُ بين الفكرة والواقع هنا ، فبدلاً أن يكون الواقعُ هو الذي أنتج النص ، نجد أنفسنا أمام النص الذي أنتج الواقع ، ولكن التناقض يتفجر هنا ، لأن النص المضيء يخلق واقعاً غير مضيء ، والكامل يخلق الناقص ، وهذه التناقضات الجوهرية الماهوية التي لم تـُحل في بداية البحث سوف تتواصلُ وتتراكب في القادم ، فما بُنى على منهج ميتافيزيقي غيبي في السابق سوف يواصل عرض تناقضاته في اللاحق .
ولهذا فإن قراءة النص داخل تطور الواقع ليست مهمة باحث واحد ، كما يقول حسن حنفي متأسفاً على عدم قيامه بمثل هذه القراءة ، بل المسألة تعود لمنهج مثالي غير قادر على ذلك!(5).
فالعالم المادي ، أو تشكل التاريخ الإسلامي والعالمي ، سيغدو إذن من صنع الوحي ، أي هو مخلوق من عنصر لا مادي ، لكن هذا التشكل لا ينتقل إلينا بصورة تقليدية ، بل بطريقة غير تقليدية ، ورفض كتابة المقدمات في الكتب القديمة هو بداية هذه الطريقة غير التقليدية في صناعة عالٍم ديني إسلامي بذات الرؤى المثالية لدى القدماء .
ومن هنا فحسن حنفي لا يقدم الطريقة التطورية الفكرية – الاجتماعية لقراءة النص والتاريخ الديني ، بل يهجمُ مرةً واحدة على النصوص ، وقد صارت بلا جذور ، وبلا لوحة تاريخية واجتماعية تضعُ الأساسَ لها .
وهي طريقة بحثية متطابقة مع الرؤية المثالية المفارقة ، فلو قام بذلك لكشف الأساس المادي للفكر الديني ، ولكنه لا يريد أن يقوم بذلك .
هذه المنهجية تتيحُ جوهرةَ الوحي ومساراته التالية ، أي جعلَ الوعيَّ الإسلامي متجوهراً في (ذات مطلقة) خارج التاريخ عملياً .
وسيكون كلُ اللاحق متشكلاً بهذه الرؤية المتجوهرة ، فالتاريخُ الإسلامي هنا وقد خرجَ من البنية الاجتماعية التي تشكلَّ فيها ، لن يكون نتاج الصراع الطبقي ، وبالتالي فإننا لن نفهمَ المنتجاتِ الفكريةَ المختلفة التي تشكلتْ في مجرى هذا الصراع الطبقي .
هنا سيحاول حسن حنفي أن يقدم مصادر لهذا التجوهر ، أي كيف يتشكلُ الدينُ وما هو مصدر فكرة الإله ، وفكرة الوحي ، لكن باعتبارها خارج البنية الاجتماعية ، وكمطلقات وكتجريدات خارج التاريخ .
سوف يعتمد في ذلك على المصادر الفكرية الأوربية خاصة الألمانية والفرنسية ، في زمنية خاصة ، هي زمنية الوعي البرجوازي قبيل انفكاكه من هيمنة الإقطاع ، أي وهو في محالةِ مخاضٍ لم يكون بنيةً فكرية مستقلة ، أي توظيف أفكار فورباخ وبرجسون خاصة ، والمنهج الظاهراتي لدى هوسرل .
يقول حسن حنفي وهو يعرض أفكار فورباخ عن الإله باعتبارها أفكاره هو نفسه :
(ليس أمام الإنسان إذن ، إذا ما أراد الحديث عن (ذات) الله إلا التشبيه والقياس ، التشبيه بنفسه والقياس على العالم ، وإثبات أوصاف الإنسان الإيجابية كصفات ثبوتية لله ، ونفي أوصاف الإنسان السلبية كصفاتٍ سلوبية عن الله . وبالتالي يكونُ كلُ حديثٍ عن الإنسان. يتوهمُ الإنسان إنه يتحدثُ عن الله في حين إنه يتحدثُ عن نفسه.)،(5).
وفي الهامش يدعونا حسن حنفي لقراءة بحثه (الاغتراب الديني عند فورباخ) مؤكداً منبع أفكاره .
وهكذا فإن مصدرَ المنتجات الدينية عبر هذه العبارة هو من الإنسان نفسه ، فليس ثمة هنا غيبٌ منتجٌ لهذه المصنفات ، لكنه الإنسان ، ولكن هنا يغدو الإنسان كائناً تجريدياً ، فهو يخلقُ هذه التشكلات الدينية عبر فضاء لا تاريخي ، فتتحول هذه التشكلاتُ الدينية إلى كائنات تجريدية مطلقة كذلك .
وعمليات إضفاء الجوانب الإيجابية من داخل الإنسان على الإله الذي يتصوره ، ونفي الصفات السلبية عن نفسه ، هي كلها عملياتٌ تجريديةٌ غيرُ تاريخية . أي أن حسن حنفي يستوردُ الُمنتجَ الفورباخي ليفسر به الأزقةَ المسدودةَ في منهجه ، فهذا الاستيراد لا يفسرُ السيرورةَ الخاصةَ لتشكلِ صور الإلهة في المشرق في الوعي ، لا من حيث الأنساق ولا من حيث الدلالات،(6).
وهذا بالتالي يطرح إشكالية منهج حسن حنفي في الانقطاع عن دراسة السيرورة التاريخية لفهم فكرة الإله ، كما جرت في المنطقة العربية .
ومن جهة أخرى هذا يتسقُ مع تجوهر المفردات الدينية لديه ، وهي الوحي ، وصورة الإله، اللتان كما رأينا غدتا مجردتين منذ البداية ، ولكنه أضاف هنا تجريدية مطلقة جديدة هي: الإنسان .
فجعلَ هذه المجردةَ المطلقة تفسر المجردتين السابقـتين ، وهذه الطريقة تغدو أنسنة مجردة ، أي أنه يعيد مصدر المنتجات الدينية إلى الأرض ، والإنسان ، ولكن في عالمٍ مجرد ، أي أنه يواصلُ جوهرةَ الوعي الإسلامي وجعله مطلقاً ، غير معبرٍ عن صراعٍ طبقي .
إن العنصرَ الفورباخي المستوردَ هنا يقومُ بقطعِ توجهِ حسن حنفي لقراءة تطور البنية الاجتماعية ، من أجل استكمال فكرته الإيديولوجية التي ستنمو كما سنرى . فهو يعطيهِ وسيلةً لاستمرار التجريد ولتشكيلِ الماهيةِ المتجوهرةِ للوعي الإسلامي النقي .
يعرضُ حسن حنفي عنصراً آخر استيرادياً هو عنصر من برغسون ، فيقول :
(الله إذن ليس موضوعاً للمعرفةِ أو للتصور أو للإدراك أو للتصديق أو للتعبير بل هو باعثٌ على السلوك ، ودافع للممارسة ، وقصد للاتجاه ، وغاية للتحقيق . الله طاقةٌ حالةٌ في الإنسان من أجل أن يحيا ويسلك ويعمل ، ويحس ويشعر ويتخيل وينفعل أيضاً . الله طاقة حيوية يحولها الإنسان إلى فعل)،(7).
علينا هنا أولاً أن نرى التناقضات بين المصدرين الفورباخي والبرغسوني ، ففكرةُ فورباخ عن كونِ الأفكارِ الدينية هي منتجاتٌ إنسانية اغترابية تــُنسف هنا ، وتغدو الأفكار الدينية نتاجٌ خارجيٌ غيبٌي صوفيٌ ، أي تغدو هنا هي أساسُ الاغترابِ غيرِ الُمدرَّكِ وغير المعروف .
إن لحظةَ فورباخ حيث يقومُ هذا الفيلسوفُ بدحضِ الهيغليةِ الدينية الاغترابية بإعادةِ فكرةِ (المطلق) إلى الإنسانِ في تاريخٍ تجريديٍّ ، هي غيرُ لحظةِ برغسون الفرنسي المحافظ ، الذي يقاومُ الفكرَ المادي الفرنسي ، نافخاً في فكرةِ (الطاقة الحيوية) القادمةِ من الغيب والتي لا تتشكلُ في قوانين موضوعية ولا في بُنى اجتماعية!
لكن المنهجيةَ التي يشكلها حسن حنفي جامعاً بين النقائض ومخترقاً الحواجز التاريخية والجمركية السياسية والروحية ، تتشكلُ من غائيةٍ إيديولوجية مضطربةٍ ، بعدم الرجوع إلى قانونيةِ التشكلِ الموضوعي للمنتجاتِ الدينية ، سواءً كانت فورباخيةً ألمانية تنويريةً بروتستانتية مقاومةً للإقطاع ، أم برغسونية كاثوليكية مكرسةً لها ، أم برجماتيةً أمريكية نفعيةً ، فالوعي العملي التوظيفي للأفكار المُنتزَّعةِ من سياقاتها ، يتوجهُ إلى سدِ الثغرات في ثقوبِ ثيابه الإيديولوجية بالرقع المناسبة .
فهو إذ يعيدُ الدينَ إلى منتجهِ الإنسان يستعينُ بفورباخ ، وإذ يعيدهُ مرةً أخرى إلى السماء يستعينُ ببرغسون ، ويحوله إلى طاقةٍ حيوية مجردةٍ ضائعةِ الملامح الطبقية مرةً أخرى ليشكلَ مشروعَهُ المتجوهرَ حول الذاتِ الدينية غير المتكونةِ داخلَ سيرورةِ البنى الاجتماعيةِ وقوانينها .
فالهيكلُ الإيديولوجي السياسي العائدُ للباحثِ يقومُ بتوظيفِ مختلفِ العناصر لذاته ، غير مراعٍ للخصائص المتضادةِ للعناصر التي يركبها حول نفسه .
وبطبيعةِ الحال فالمصادرُ تختلفُ من حيثِ نموها في المشروع ، فالعنصر البرغسوني يغدو مجردَ دافعٍ عام ، تتمظهرُ فيه عمليةُ تدفقِ اللغة ، أي أن العنصرَ الحيوي التجريدي الصوفي البرغسوني يغدو لدى حسن حنفي طاقةً عاطفيةً ضخمةً تنهالُ فيها الجملُ والأفكار بسيلٍ جارف . لكن نحو الواقع ونحو رؤية التجسيدات الإسلامية المختلفة .
في حين يلعبُ المصدرُ الفورباخي عملياتٍ كثيرةً في المشروع برفضِ التجريدات الدينية الغيبية فتجري أنسنتها في الكثيرِ من المجالات . فعملياتُ الاغترابِ يجري دحضها في الرموزِ الدينية المختلفة ، ولهذا حين يتوجهُ إلى فصلِ أي عنصرٍ ديني مفارقٍ لا يقرأهُ في بنيتهِ الاجتماعية وسيرورتها بل يدحضهُ من خلالِ الأنسنةِ العامة ، أي عبر منهج فورباخ، مع أدلجة سياسية مباشرة تأتي في خاتمة الفقرة عادةً تحضُ على النضال المباشر بذلك الوعي المتجوهر المطلق ، ولكنه الآن فقدَ انفصالَهُ عن العمل لكن لن يُــكشف محتواه الطبقي .
وإذا كانت هذه المصادرُ تلعبُ دوراً في تشكيل المنهج فلا بد أن الظاهراتية والبنيوية النصوصية تكملان المنهجية ، فقراءة الظاهر والنص المحدد ، تتداخلان و تكتملان .
فالوعي الديني يغدو ظاهراتيةً مباشرةً تــُرصدُ بمباشرتها فيتمُ الوصول إلى أنساقٍ في نصوصها ، المقطوعة الجذور عن الصراع الاجتماعي ، فعلمُ الكلام الإسلامي مثلاً يُؤخذ بكتبه وموضوعاته ، بأسمائها وفصولها وتطور هذه الموضوعات عبر الزمن ولماذا ازدادت الإلهيات على الطبيعيات أو كيف نمت الموضوعات السماعية الخ . . .
يقول في إحدى خلاصاته عن علم الكلام :
(علم الكلام إذن هو تاريخ الأهواء والأغراض والمصالح أكثر منه تاريخاً للعقل ، ثم ورث الهوى العداوة والبغضاء في النفوس وضاعت وحدة العقل في تكثر الأهواء ، وتلاشت وحدة الوحي في تضارب الرغبات والمصالح). (قضى علم الكلام على بساطة الوحي ووضوحه)،(8).
على الرغم من الدخولِ الوثيقِ البالغ التفاصيل والجهدِ في كتبِ علم الكلام فإن حسن حنفي يأخذهُ كنصوصٍ ذاتِ موضوعات ، وليس كتاريخٍ من الصراعِ الفكري الاجتماعي المتداخل.
ليس ثمة عقلٌ مجردٌ في هذا التاريخ ، بل هنا نجدُ العقولَ الدينيةَ في صراعاتها المختلفة، فقد أسس علمُ الكلام دوراً تحضيرياً تمهيدياً للفلسفة الدينية ، وعبَّر عن نضال الفئات الوسطى في تشكيلِ سببية دينية للحرية الفردية ، وبهذا فإن علمَ الكلام الاعتزالي هو مشكلٌ لهذه النضالية المحدودة ، وعلم الكلام الأشعري هو هادمها ورابط تلك الفئات الوسطى بالنظام الإقطاعي المذهبي المسيطر .
وهكذا فإن العقلَ الديني المنقسمَ ليس مقسوماً بشكلٍ تجريدي بل هو مقسومٌ لأسباب اجتماعية صراعية ، أي متشكل في تيارين رئيسين ، يعبران عن منحيي النضال ثم التبعية في هذه الفئات الوسطى وتاريختيها الخاصة في المنظومة وبسببِ سيرورةٍ خاصة للمنظومةِ الاجتماعية التاريخية غير القادرة على تجاوز تناقضاتها ، فنمو وسيطرة الأشعرية ليس هو لأسبابٍ تجريدية ، بل هو لأسبابٍ طبقية وفكرية متداخلة .
إذن هو تاريخٌ للعقل ، ولكن في سيرورتهِ الدينية ، في زمنيةِ الإقطاع ، وثمة عناصر مقاومة وثمة عناصر استسلام ، ثمة عناصر كفاح للإرادة تنتمي لتلك الفئات لم تصل أن تربط نفسها بالجمهور العريض لأسباب عميقة وخطيرة ، هي النظام الاجتماعي غير المدروس عند حسن حنفي ، وحتى العناصر السلبية فيها كذلك جوانب معينة إيجابية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انظر عبـــــــدالله خلــــــــيفة: الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية ، الجزء الرابع ، تطور الفكر العربي الحديث , وهو يتناول تكون الفلسفة العربية الحديثة في مصر خاصة والبلدان العربية عامة، منذ الإمام محمد عبده وبقية النهضويين والمجددين ووقوفاً عند زكي نجيب محمود ويوسف كرم وغيرهما من منتجي الخطابات الفلسفية العربية المعاصرة ، 2015.
(المصادر) :
(1) : (التراث والتجديد ، المجلد الأول ، حسن حنفي ، مكتبة مدبولي ، بدون تاريخ أو رقم للطبعة ، ص 10) .
(2) : (المصدر السابق ، ص 49) .
(3) : (المصدر السابق ، ص 58) .
(4) : (المصدر السابق ، ص 59) .
(5) : (يوضح حسن حنفي رفضه للقراءة المادية للتراث في كتيب أصدره بعنوان (دعوة للحوا) ، يقول في إحدى مقالاته فيه : فالماركسية مثلاً ما زالت تعتبر الدين مثل الثقافة والفن وسائر النشاط الذهني الإنساني أبنية فوقية تعبر عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية لشعبٍ ما في لحظة تاريخية معينة . يمكن تغييرها بتغير ملكية وسائل الإنتاج، من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة ، وبنقل نمط الإنتاج من الزراعة إلى الصناعة . بهذا التحول تتغير الثقافة آلياً وتنشأ مفاهيم أخرى لزمان والعمل والإنسان والعلاقات الاجتماعية أكثر تطوراً وحداثةً) ، (دعوة للحوار ، الهيئة العامة للكتاب 1993 ، ص 119 ، لنلاحظ هنا أن أفكار حسن حنفي بعد (غربلة) التراث لم تختلف عن أفكار محمد باقر الصدر برفض وجود قوانين لتطور البُنى الاجتماعية وفهمها بشكل تقني ، واختزال فهم مستويات البناء وطرح الآلية كشكل وحيد للتغيرات وبدون عوامل نضالية وتداخلات معقدة!
(5) : (المصدر السابق ، ص 87) .
(6) : (راجع عملية تحلينا لتطور المسار الديني في المشرق في الفصل الأول من الجزء الأول من الاتجاهات المثالية) .
(7) : (من العقيدة إلى الثورة ، المصدر السابق ، ص 88) .
(8) :(المصدر السابق ، ص 118) .


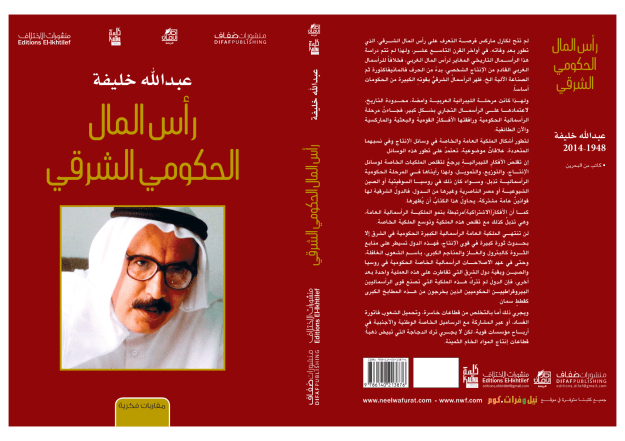


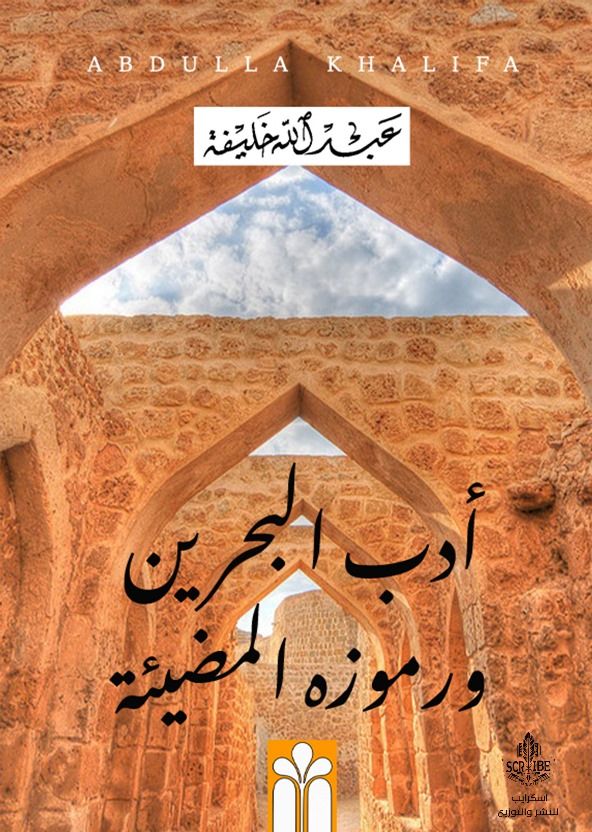













لا يقرأون . . ويتعاظمون! : كتب ـ عبدالله خليفة

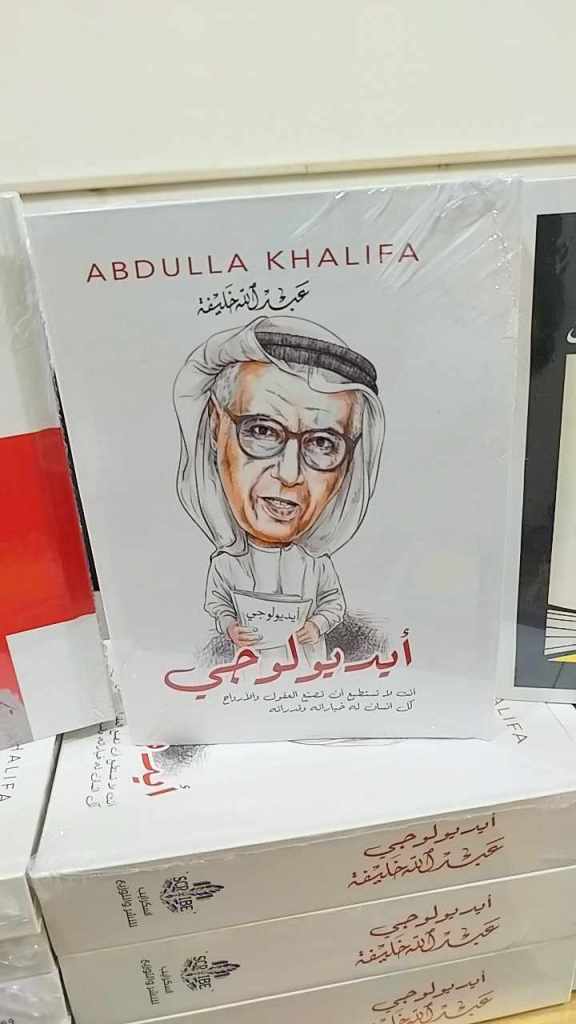



isa.albuflasa@gmail.com

العقل عند طه حسين
إن اقتراب طه حسين من الفكر الفلسفي نجده في الصفحات الأولى من كتابه: (مستقبل الثقافة في مصر) الذي يقدمُ فيه خطةً عامة لتغييرِ نظام التعليم في مصر، والجمعُ بين هذا الفكرِ النظري العام وقضيةِ التعليم تحديداً، هو قمةُ عمل النهضويين (العلمانيين)، الذين اقتصروا على البثِ الثقافي وليس العمل السياسي والاجتماعي المباشر، حيث صعّد طه حسين تدريجياً التنويرَ الأدبي ليغدو نضالاً سياسياً تبلور عند التعليم، وذلك بسبب تصور التنويريين المثالي عموماً بكونِ الثقافةِ هي أداةُ تغيير التخلف، لكن هذه الثقافة مصاغةٌ داخل آليات بنية الإقطاع المذهبي وليس لاجتثاث هذه البــُنية مما يؤدي بهذه الثقافة نفسها أن تكرس تلك البنية لا أن تهدمها كما كانوا يتصورون.
ولهذا فإن منطلقات عميدِ الأدب طه حسين شبهِ الفلسفية في مقدمة هذا الكتاب تتطابقُ وخطته لتغيير التعليم في مصر التي أعلنها في هذا الكتاب سنة 1938 ثم طبق أساسياتها حين صار وزيراً للتعليم في حكومة الوفد بعد ذلك.
وفي هذه المنطلقات فإن مسألة (العقل) تغدو بؤرةً مركزيةً في عمليةِ إنتاجِ المفاهيم وتطبيقها، ولهذا يقول :
(فهل العقل المصري شرقي التصور والإدراك والفهم والحكم على الأشياء، أم هل هو غربي التصور والإدراك والفهم والحكم على الأشياء؟ وبعبارة موجزةٍ جلية أيهما أيسر على العقل المصري : أن يفهمَ الرجلَ الصيني أو الياباني، أو أن يفهم الرجلَ الفرنسي أو الإنجليزي؟)، (31).
يعممُ طه حسين الوعيَّ المصري وتياراته في أزمنته المختلفة في تعبيرٍ متجوهر هو (العقل) مما يُعطي لهذا العقل خصائصَ عامةً مجردةً خارجَ الزمان والمكان. فالعقلُ المصري يغدو بهذا الوعي واحداً سواء كان في زمنِ التاريخ المصري القديم في زمن الفراعنة أم كان في زمن التبعية لليونان والرومان أو زمن الدخول في السيطرة العربية أو في زمنه الحديث، فكل هذه التشكيلات التاريخية والسيرورة الاجتماعية لا تغير من طبيعة العقل المصري الواقف فوق الوجود.
ولهذا فإن (العقلَ) المصري وهو يشتبكُ مع الغزاة والعقول الأخرى يظل محتفظاً بهويته الجوهرية حسب منطق طه حسين المثالي المفارق، وهذا العقلُ الذي يجعله حضارياً بشكلٍ ميتافزيقي منذ أن ظهر في الوجود، يصطدمُ مع التأثيرات الشرقية غير العقلانية مثلما غزا الفرسُ مصرَ رغم أنهم كانوا تعددين بخلافِ ما يعرضُ طه حسين هنا أي لم يفرضوا ديناً : (ومعنى هذا كله واضح جداً : وهو أن العقل المصري لم يتصل بعقل الشرق الأقصى اتصالاً ذا خطر، ولم يعش عيشة سلم وتعاون مع العقل الفارسي، وإنما عاش عيشة حرب وخصام) (32).
إذن إذا كان هذا العقلُ متجوهراً على نفسه وخارج الشرق وهو فيه، كيف يستمدُ مقوماتِهِ وكيف ينتجُ عقلانيتَه؟
يقول الدكتور طه حسين بأن بناءَ العقل يتمُ من خارجه عبر المحيط الجغرافي فيقول: (أن العقل المصري منذ عصوره الأولى عقل إن تأثر بشيء فإنما يتأثر بالبحر الأبيض المتوسط)، (33).
ومن هنا فهو يجعلُ العقلَ المصري (أوربياً) قبل أن تظهر أوربا الرأسمالية الحديثة، لكن عبر نموذجها الأولي المتمثل في حضارة اليونان، التي قام العقلُ المصري نفسه بتغذيتها بالعلوم والفنون، ولكن هذه التغذيةَ الثقافية تظهرُ في شريطِ طه حسين التاريخي بلا سببيات وبشكلٍ مجردٍ، ولكنه وهو في هذا التجريد يستدركُ قائلاً بأنه من الحق (أن نعترف بأن مصر لم تنفردْ بالتأثير في حياة اليونان، ولا في تكوين الحضارة اليونانية والعقل اليوناني، وإنما شاركتها أممٌ أخرى، كان لها حظٌ موفورٌ من الحضارة والرقي..)، (34).
إن العقلَ الحضاري إذن هو من نصيبِ جماعاتٍ تعيشُ على ضفافِ البحر الأبيض المتوسط، وكأن في هذا البحر خصائصَ سحريةً تعطيه قدرةَ جعل الشعوب العائشة على ضفافه أن يكونَ لها عقلٌ وحضارة، وليس أن هذه الحضارات نتاج أساليب الإنتاج المتقدمة والمتباينة فيما بينها، ولهذا فإن طه حسين لا يعرضُ أسبابَ الديمقراطية اليونانية وانتفاء هذه الديمقراطية من أساليب الحكم الشرقية (الحضارية)، ولا مظاهر كون الثقافة اليونانية متعددة من مادية ودينية في حين كان الشرق دينياً شمولياً، ولهذا فإن ميزات هذا العقل المصري أو الشرقي الحضاري عامةً، الشمولي الديني يُطَّابقُ بالعقلِ اليوناني المتعدد الأفكار، وهو أمرٌ يقودُ إلى إخفاءِ التباين العميق بين الثقافة في ظل أنظمة العبودية العامة كما في مصر والعراق والشام، التي سادتها الأديانُ الحكوميةُ المستبدة، وبين اليونان التي عرفت الاتجاهات الفلسفيةَ المادية المتنوعة ثم الاتجاهات المثاليةَ المتعددة بعد ذلك، بسبب تعدديةِ المدن والسلطات وظهور برجوازية حرة.
وخلافاً لرأي طه حسين البحري فإن ظهورَ العقل الديمقراطي في اليونان نتاجُ تطور الصناعات والتجارة الحرة غير المحكومة بإدارة الدولة، وهي الظروف التي أتاحت التعليم الحر والثقافة الحرة، بعكس ما فعلته المنشآتُ التعليمية الكهنوتية المصرية والعراقية والشامية الخ، ولهذا فإن الموادَ الثقافيةَ المشرقية المقدمة إلى اليونان المفيدة والمؤدية للتطور لم تؤخذ في زنازينها الحكومية الغيبية المشرقية، بل أُدرجت في أبنيةِ مدنٍ يونانية مختلفةِ الاتجاهات، وفي المدن الديمقراطية أدى ذلك إلى فلسفات مادية ومثالية موضوعية كفلسفتي ديمقراطيس وأرسطو، وفي مدن استبدادية وعبر نمو الاستبداد في المجتمع اليوناني عامةً أدى ذلك إلى ظهور فلسفات مثالية دينية معادية للعقل الخ..
إن فصلَ طه حسين العقلَ المصري عن منطقتهِ العربية – الإسلامية – المسيحية الشرقية وتعليقه في فضاءٍ جغرافي لا تاريخي، أي وضعَهُ داخلَ إطار ما أسماه (أسرة الشعوب التي عاشت حول بحر الروم) ص 14، يستهدفُ غايات تحويلية شمولية تحديثية، أي بمعنى إن عمليةَ الفصلِ هذه التي تــُشكَّل بمنهجيةٍ لا تاريخية تجريدية، تسحبُ مصرَ من سيرورةِ تكونها الاجتماعية التاريخية الموضوعية الحقيقية، وتعلقها في وعي مُسقطٍ على التاريخ وهو وعيٌ شموليٌ إداري حكومي، وليس بمنهجية ديمقراطية شعبية، فتقومُ هذه المنهجيةُ بفصلها عن تكونها الحقيقي، وتوجدُ لها رابطةً موهومة، هي رابطةٌ إيديولوجية مُسقطة من مثقفٍ تنويري يستهدفُ غايةً جيدة لكن بشروطِ وعي غير علمية.
ومن هنا يهاجمُ الشكلَ العادي الموضوعي المبسَّط من الوعي العام مصراً على قطعهِ لمصرَ عن نسيجِها العربي الإسلامي المسيحي الشرقي: (فأما المصريون أنفسهم فيرون أنهم شرقيون، وهم لا يفهمون من الشرق معناه الجغرافي اليسير وحده، بل معناه العقلي والثقافي)، ( ولكني لم أستطع قط، ولن أستطيع في يومٍ من الأيام، أن أفهمَ هذا الخطأ الشنيع أو أسيغ هذا الوهم الغريب.) (35).
إن طه حسين وهو يستهدفُ غايةً نبيلةً وهي ربطُ مصر بأوربا النهضوية الحديثة يستخدمُ منهجاً إيديولوجياً يحطمُ فيه أسسَ التاريخ ويشكلُ تاريخه الإيديولوجي الخاصَ الموظفَ لخدمةِ تلك الغاية السابقة الذكر.
يقول: (ومن المحقق أن تطور الحياة الإنسانية قد قضى منذ عهد بعيد بأن وحدة الدين، ووحدة اللغة، لا تصلحان أساساً للوحدة السياسية ولا قواماً لتكوين الدول) ويضيف: فالمسلمون أنفسهم منذ عهد بعيد قد عدلوا عن اتخاذ الوحدة الدينية واللغوية أساساً للملك وقواماً للدولة.)، (36).
إن طه حسين هنا يرفض بديهيات التاريخ، فعلى العكس كانت الوحدةُ الدينية – اللغوية أساسَ تكونِ الدول القديمة، فالإمبراطوريةُ الإسلامية قامتْ على تلك الوحدة المزدوجة، وكانت تلك الوحدة في بدايتها عملية نهضوية واسعة، وبهذا فإن الإسلامَ واللغةَ العربية وضعا أساسين لتشكلِ ولنهضةِ أممٍ متعددة، ولكن نظراً لسيطرةِ طبقةٍ استغلالية في مركز هذه الإمبراطورية ورفضها عمليات الإصلاح من قبل الفئات الوسطى المدنية، فإن هذه الإمبراطوريةَ تفككت، وبالتالي بدأت اللغاتُ القوميةُ في الظهور وإزاحة اللغةِ العربية في بعض الأقطار، في حين احتفظت أقطارٌ أخرى بهذين الأساسين، فيما عُرف بالدول العربية الإسلامية. وظل هذان الأساسان فيها، حتى حاولت الإمبراطوريةُ التركيةُ تغييرَ الأساس اللغوي العربي لحضارةِ المنطقة فلم تستطع.
والغريب في منطق طه حسين أنه ينقلبُ عن هذا الرأي حين يمنهجُ التعليمَ في مصر معتبراً الإسلامَ واللغة العربيةَ أساس هذه المناهج التربوية حتى في المدارس الأجنبية!
وفي رؤية طه حسين هنا نقرأ تعميمات تجريدية خاصة في تعبيري (الدين) و (اللغة)، فالدين، الإسلام، لم يعدْ هو أساس وحدة الإمبراطورية الإسلامية أو الدولة الإسلامية، بل المذهب، فالأساسُ الإسلامي العام التوحيدي زال، وغدت الدولة مذهبيةً، والمذهبُ الديني الموظفُ حكومياً صار أداةَ السيطرة للطبقة الإقطاعية، مُفرغَّـاً من طابعهِ الإصلاحي ومحوَّلاً إلى أشكالٍ مُفرَّغةٍ من دلالاتها الشعبية النهضوية الأولى، كما أن (اللغة) العربية الفصحى تيبست ثم أصبحت محصورةً في دوائر ضيقة بسببِ سياسةِ تلك الطبقات الإقطاعية في تقليصِ الثقافة والتعليم وحياة المنتجين المادية وبالتالي أدى هذا إلى تكونِ وصعودِ اللهجات العامية الخ..
ولكن هذين الأساسين – أي الدين واللغة – تشكلا في زمنِ الدول التقليدية، أي في زمن سيطرة الإقطاع، وبالتالي فإن مسار التعميم لدى طه حسين، كما هو سائد كذلك في الوعي العربي التقليدي عامةً، ليس دقيقاً فالانتقال من الإسلام العام إلى المذاهب هو أمر مختلف، بمعنى أن انتقاله من شكلٍ إلى شكلٍ آخر، هو بسببِ جملةٍ من التغيرات والصراعات التي انعكست على البنية الداخلية في الدين. أي بسبب انتقال الإسلام من دين شعبي إلى دين حكومي مُسيَّطرٍ عليه من قبل الأقليات الاستغلالية.
ولهذا فطه حسين بعد أن أنتزعَ مصرَ من سياقها العربي الإسلامي وعلقها في فضاءِ بحرِ الروم حيث تنتمي إلى دائرة الأمم الأوربية، عاد وأفرغ التاريخَ العربي الإسلامي من دلالاته الموضوعية وتطوره الحقيقي، يقول :
(فأما نحن فقد عصمنا الله من هذا المحظور ووقانا شروره التي شقيت بها أوربا. فالإسلام لا يعرف الأكليروس ولا يميز طبقة رجال الدين من سائر الطبقات. والإسلام قد ارتفع من أن يجعل واسطة بين العبد وربه. فهذه السيئات التي جنتها أوربا من دفاع رجال الدين عن سلطانهم لن نجنيها نحن إلا إذا أدخلنا على الإسلام ما ليس فيه وحملناه ما لا يحتمل.)، (37).
إن هذه لغةً تجريدية لم تدرس المسار الفعلي لتطور الدولة العربية الإسلامية، فعبر تحول الدولة الإسلامية من دولة (شعبية) إلى دولة للأشراف تم إعادة تشكيل الوعي الديني المسيطر، وكذلك غُيرت طبيعة رجال الدين حيث قــُرب الموالون وصارت الأحكام تراعي دول الاستغلال، وأُضطهد المعارضون، ونـُحيت مسألة الملكية العامة العائدة للمجتمع وتم تشكيل أشكال مذهبية معارضة متعددة، ولكن عموماً لم يستطع المدافعون عن الجمهور أن يشكلوا فقهاً مسيطراً، في حين سيطر الفقهُ الموالي لدول الاستغلال على تعدد أوجهها المذهبية.
وبهذا نشأ لدينا أكليروس من طبيعة مختلفة عن الأكليروس الأوربي، الذي كان وحده على السلطة في العصر الوسيط، في حين كان الأكليروس الديني لدينا مجردَ تابعٍ ومشاركٍ للسلطةِ السياسية، لكنه كان اكليروس كذلك!
لقد صارت السلطة دينيةً وصار المذهب سياسياً وكلاهما مشكلان من قبل طبقات الأقلية الحاكمة، ولهذا فإن أوجه النهضة الفقهية والأدبية والفكرية المضيئة هي من إنتاج الفئات الوسطى التي حاولت أن تقاومَ ذلك التكريس المحافظ ولكنها لم تستطع أن تحيلها إلى ثقافة سائدة، وقامت قوى الأقلية بإعادة صهر النتاج الديني الثقافي ليصير على ما هو عليه في القرون الأخيرة من تكلس وتبعية للهيمنة الحكومية.
ولهذا فإن خلاصةَ طه حسين تبدو مضادةً للواقع: (فالمسلمون إذن قد فطنوا منذ عهد بعيد إلى أصل من أصول الحياة الحديثة، وهو: أن السياسة شيء والدين شيء آخر، وأن نظام الحكم وتكوين الدول إنما يقومان على المنافع العملية قبل أن يقوما على أي شيء آخر.)،(38).
ولننتبه هنا إلى كلمة (أصل من أصول الحياة الحديثة) وهي كلمةٌ لم يصرح بها طه حسين وهي كلمة (العلمانية) أي فصل الدين عن السياسة، ولكن هذا الفصل لم يحدث إلا بشكلٍ جزئي، فالحكامُ كانوا سياسيين ولكنهم مذهبيون كذلك، أي أن سيطرتهم على المنافع العامة جعلتهم يسيسون الدين بشكل معين، إلا أن عملية الفصل الشاملة بإعطاء الإسلام حريته لم تحدث، وظلوا مهيمنين على إنتاج الدين وإنتاج الثروة معاً، واستمر ذلك حتى زمن طه حسين وهو يكتب كتابه.
إن عدم تحليل طه حسين لسيرورة الإسلام بشكل موضوعي، أي تعليقه في فضاء مجرد من الصراع الاجتماعي، في الماضي، يقوده إلى إنتاج نفس الخريطة المجردة في العصر الحديث. أي على إبقاءِ الدينِ خاضعاً للأقليةِ الغنية المسيطرة على الثروة والسلطة.
ولهذا فإن طه حسين وهو يكتب كتابه السابق الذكر (مستقبل الثقافة في مصر) كان يتصور عملية الفصل بين الدين والسياسة قد تمت لدى المسلمين وليس ثمة حاجة للنضال من أجلها، وأن مصر الدينية الإقطاعية في عصره مماثلة في وجودها الاجتماعي لأوربا الرأسمالية العلمانية، وهذا التصور قد تشكل بسبب عدم قراءته للتطور الاجتماعي المختلفِ بين المشرق وأوربا، فهو أولاً يعزلُ مصرَ عن نسيجها الجغرافي الاجتماعي، معلقاً إياها في فضاءٍ إيديولوجي تنويري مثالي، جاعلاً إياها متجوهرةً مرتفعةً عن بُنى التاريخ الموضوعية، ثم ينقل هذا التجوهر إلى مفردات الدين والعصر. فتنتفي الفروقُ النوعية بين تطورِ مصر الإقطاعية المذهبية وتطور أوربا الرأسمالية العلمانية. فكلاهما سواء ولا تحتاج مصر لتكون أوربية كاملةً سوى إلى اندماج ثقافي حداثي وليس إلى تغيير سياسي واجتماعي كبيرين. أي أنه يقفزُ على مهمةٍ كبرى لم تنجز.
إن كتاب (مستقبل الثقافة في مصر) الذي كتبه طه حسين هو محاولة لإنتاج عقل حديث، ولكنه يعجز عن إنتاج مثل هذا العقل، كما فعل ديكارت في فجر التحديث الأوربي. فديكارت الذي توجه نحو الفلسفة أنتج معرفة لادينية، أي معرفة تفتحُ الطريق لنمو التجريبية الخالصة ولتحرير العلوم الطبيعية من أسر الكهنوت. في حين توجه طه حسين للأدب، وشكل عقلاً مجرداً لا تاريخياً، كرس المحافظة الدينية الميهمنة على المناهج التربوية.
فصياغته لعقلٍ مجردٍ لا تاريخي ولا طبقي، جعله يجردُ الدين واللغة والثقافة عموماً من كونها أدوات في الصراع الاجتماعي، فالفكر الديني المحافظ الذي كرسه الإقطاع المذهبي عبر القرون السابقة، ليس هو منتجٌ إسلاميٌ عام، بل هو منتجُ الأشراف والقوى العليا التي هيمنتْ على المسلمين والمؤمنين عموماً. ولهذا فبدون فحصِ ونقد هذا المُنتَّج المتنوع وتقديمه خاماً مسيطراً على العقول عبر التعليم، لا يؤدي ذلك إلى خلق عقل (تنويري) بل يؤدي إلى توسيع المحافظة الدينية اليمينية، وحين يخطط ثم يبني طه حسين تعليماً متوسعاً ديمقراطياً في امتدادته، ثم يقدمُ نفسَ المادة الدينية المحافظة فهو يقوي الاتجاهات غير التنويرية التي أراد تغييرها. إنه يوسعُ التعليمَ لكي تسيطر عليه القوى الشمولية خلافاً لأمنيته.
يقول:
(ولا يخطر لأحدٍ من أشد الناس محافظةً أن يحظر درس بشار وأبي نواس ولا أن يطلب من السلطان تحريق ما ورثنا من آثار الفلاسفة والزنادقة والمجان الذين لا يرضى عنهم الدين..)، (39).
إن هذا الذي يستبعدُ طه حسين في زمنه وقوعه قد حدث فعلاً في زمن تالٍ، وهذا يعودُ لأن قادةَ الفئات الوسطى الفكريين والسياسيين، طرحوا مفاهيمَ مجردةً كمسائل العقل والدين واللغة والثقافة عموماً، ولم يدرسوها كمنتجات في بُنى اجتماعية متضادة القوى والطبقات، وبالتالي قاموا بالترويج لفكر العصر الوسيط المحافظ، وكانوا يقولون بأنهم يعيدون إنتاج أوربا الحديثة مصرياً وعربياً.
إن طه حسين يجعلُ طبيعةَ الدولة المصرية المعاصرة وطنية عامةً مجردةً : (أول واجبات الدولة أن تحمي بعض المصريين من بعض)، فتغدو الدولة هنا جهازاً فوق الطبقات، مثلما جعل الثقافةَ وعياً فوق الطبقات، وجعل فلسفةَ ديكارت والفلسفة الأوربية الحديثة عموماً شكلاً إنشائياً: أنظر قوله (إن الذين يزعمون أن ديكارت كان خلواً من الروح إنما يقولون سخفاً ويهذون بما لا يعلمون)، ص 67. فهل هي قضية ديكارت الروح أم قضيته فصل الفلسفة عن الدين وخلق اتجاه تجريبي علماني؟
وتغدو الديمقراطيةُ لدى طه حسين كذلك تنويراً ثقافياً وليس بنيةً حديثة ذات قوانين مختلفة عن قوانين بنى العصر الوسيط.
إن هذه اللغةَ الإنشائيةَ الخطابية غير التحليليةِ غير الفلسفيةِ، لن يكون بإمكانها أن تناقشَ القضايا المحورية في البنية الاجتماعية المعاصرة، أي أن تربط مسائل الثقافة وعلاقتها بالتشكيلات التاريخية، وأن تقرأ أنواعَ الوعي المرتبطة بالطبقات، وأن تحدد مسارَ التحول ونشاط القوى الفاعلة الثورية، وبهذا فإن هذه الرؤية لا تصل إلى المفاهيم المجردة الفلسفية العامة كالضرورة والسببية والحرية والقانون الاجتماعي والطبيعي الخ.. وهي عبر وعيها الأدبي تريد أن تقيمَ استراتيجية اجتماعية كبرى، ويترافق هذا مع فئات وسطى متداخلة مع الإقطاع، فتغدو الحداثة متداخلةً مع المحافظة الدينية، وتصير العلمانية في نسيجٍ كهنوتي، وتعجزُ الفئاتُ الوسطى عن التحول إلى طبقة وسطى قادرة على تجاوز التشكيلة الإقطاعية المذهبية.
وفيما بعد يضيفُ النظامُ العسكري الوطني الشمولي مشكلات أخرى إلى هذا التصدع الداخلي لتطور الفئات الوسطى باتجاه الحداثة والديمقراطية، فهو يزعزع فئاتها الصناعيةَ ويخلقُ بيروقراطيةً اقتصادية كبيرة تتوجه إلى الفساد، مما يكرس المحافظة الدينية ويؤدي إلى ضمور العقل النقدي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انظر عبـــــــدالله خلــــــــيفة: الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية ، الجزء الرابع ، تطور الفكر العربي الحديث , وهو يتناول تكون الفلسفة العربية الحديثة في مصر خاصة والبلدان العربية عامة، منذ الإمام محمد عبده وبقية النهضويين والمجددين ووقوفاً عند زكي نجيب محمود ويوسف كرم وغيرهما من منتجي الخطابات الفلسفية العربية المعاصرة ، 2015.


عبـــــــدالله خلـــــــيفة: عرضٌ ونـقـدٌ لأعماله القصصية





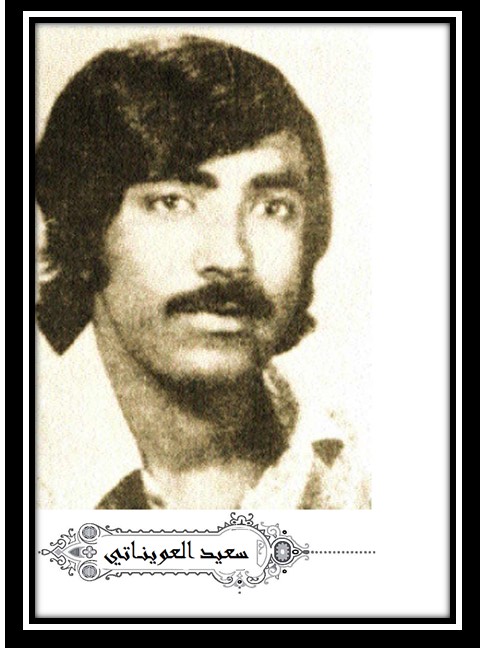


قانون الإنتاج المطلق ــ كتب: عبـــــــدالله خلـــــــيفة













الثورةُ السوريةُ.. بطولةُ شعبٍ: كتب ـ عبدالله خليفة





isa.albuflasa@gmail.com

بداية المثالية الموضوعية
إن تشكلَ المثاليةِ الموضوعية الفلسفية الدينية المعاصرة في البدء كانت لدى بعض الدارسين والمتخصصين في الجامعات أو الحوزات الدينية مثل يوسف كرم المصري ومحمد باقر الصدر العراقي، وفي نصوصهما الفلسفية تتشكلُ حالة مواجهةٍ مع الفلسفاتِ التجريبية الذاتية أو مع المادية الجدلية.
فهما يرفضان التصورية أو المثالية الذاتية حين ترفضُ هذه المثاليةُ الاعترافَ بأساسياتِ الوجودِ العامةِ فقومُ بحصر مركز الوعي في الذات المفصولة عن الوجود الموضوعي، ويقوم المفكران المسيحي والمسلم، كلٌ من جهته، بربطِ الوعي بالوجودِ والاعتراف بموضوعة المعرفة، وهذا يفتحُ البابَ لقراءة المجتمع ونقده والمطالبة بإصلاحهِ بهذا الشكل أو ذاك.
وإذا كان يوسف كرم لا يدخل في عملية التحليل والنقد الاجتماعية، أي لا يربط بين هذه المثالية الموضوعية وقوانين الوجود الطبيعية والاجتماعية، فإن محمد باقر الصدر يتوسع في هذه العملية ويبحث عن سببياتِ الوجودِ الطبيعية والاجتماعية، دون تحديد مدى قانونية المثالية الموضوعية هذه، وهذا اللاتحديد أو التحديد الإصلاحي المحدود يرتبط بالهياكل السياسية والاجتماعية التقليدية هنا، فلم تقدر المثالية الموضوعية أن تتصف بقدر نقدي مهم، أي أن انتماءها الاجتماعي لم يتحول إلى الطبقة الصناعية المالكة الحديثة كقائدة لعملية تحولٍ منتظرة.
علينا أن نرى في ظهور المثالية الموضوعية لدى يوسف كرم المسيحي؛ ومحمد باقر الصدر الاثناعشري، ليس فقط تجلياً شخصياً للفلسفة الدينية، المشرقية القديمة وهي تستعيدُ نشاطها في المشرق العربى – الإسلامي – المسيحي مرة أخرى، بل هي تجلٍ عام كذلك، لكنها الآن فقدت الوسائط النجومية الكوكبية التي كانت ترافقُ فكرة الإله أو صورته في عملية صنع الوجود.
ولهذا فإن عملية الفقه النقدي لدى محمد باقر الصدر مهمة في تدشين حفر تحليلي للواقع يترابط والمنظومة المثالية، لكن من موقعِ الخصام العنيف مع المادية الجدلية، وهو أمر قاد إلى عدم تطوير لحظته الفلسفية المهمة فيما بعد اغتياله . وقامت القوى المذهبية بالتراجع عن حيوية أفكاره، ولكن هذا أيضاً لن يكون أبدياً، فهناك مخاضٌ يدفعها لإجراء تحولات عميقة في بناها التقليدية.
فباقر الصدر نا يواجهُ فلسفةَ المادية الجدلية الاستيرادية في مرحلة الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين حيث تتقابلُ على أرض العراق هذه المعسكرات المتضادة بشكلٍ حاد، وتقودهُ عمليةُ (تفنيدِ) المادية الجدلية إلى الاعتراف بموضوعيةِ الوجود وسببياته، لكن قانونيةَ الوجود الاجتماعي تصيرُ مرفوضةٍ لديه، فالبُنى الاجتماعية بقوانيتها الموضوعيةِ تتحول إلى سببيات جزئية مثالية، أي أن تغيرات المجتمع تعود لديه إلى أسبابٍ تربوية وفكرية ذات أساسٍ غيبي في نهاية العطاف.
وبهذا فإن قانونية الوجود راحت تتكسر فى الوعي الديني عامةٍ، وأخذت المثاليةُ الموضوعية عموماً تتوقف أو تترجع إلى أشكالٍ فلسفية مثالية ذاتية أو تعود للتصوف، وهوشكلٌ مثالي ذاتي كذلك . لكن نمو المثالية الموضوعية من منطلق ديني، لن يتوقف فسنجد اشعاعاً فيها عبر المذاهب السنية هذه المرة، وبشكلٍ موسوعي، خاصة في أعمال محمد عابد الجابري وحسن حنفى.
لكن بعد أعمال يوسف كرم نجد ظهور واتساع البرجماتية والتجريبية المنطقية والوجودية، خلافاً للبواكير المشجعة لنهوضِ المثالية الموضوعية، ويعود ذلك لعدم قدرةِ المثاليات الموضوعية على التطور، فالشكلُ الديني المحافظ سياسياً حبسها عن النمو، فيوسف كرم عبر مسيحيته ومحمد باقر الصدر عبر اثناعشريته، كانا يجعلان المثالية الموضوعية تابعةٍ للوعي الديني المهيمن والشمولي، وإذا كان الاعترافُ بقانونية الوجود الموضوعية تحت عدة أقواس، مهماً في الوجود الطبيعي فإنه في الوجود الاجتماعي أكثر أهمية ولكن أكثر صعوبة وخطورة.
ولكن هنا لا تظهر عمليةٌ نقديةٌ جذرية للمجتمع عبر المثالية الموضوعية، فهي سوف تعيدُ سببيات الحياة الاجتماعية إلى التربية والوعي، وليس إلى بنية المجتمع الطبقية الحاسمة. رغم اتفاق مثالية محمد باقر الصدر مع المادية الجدلية على أهمية وجود قطاع عام في إسناد الطبقات الفقيرة وعلى دورهِ في عمليةِ التنمية والقبول بالإصلاح الزراعي في حدود.
isa.albuflasa@gmail.com

الأيديولوجيات العربية والعلم
هناك بعض أوجه التشابه بين التجربة الماركسية — اللينينية والتجارب العربية الفكرية والاجتماعية القومية والدينية، فهناك جوانب عميقة متقاربة، فالمنهجية الماركسية التقليدية لم تتشكل كحفرٍ علمي في العلوم عربياً وإسلامياً ، فهي جاءت كمقولاتٍ ناجزةٍ، فليس ثمة هنا أبحاث واسعة في العلوم، ولا تشكيل لطبقة فكرية موضوعية على سطح الوعي، وبالتالي فإن تطبيقها على ميدان التاريخ والبنى الاجتماعية كان يجري بالطريقة ذاتها، أي كعمليةِ نقلٍ من المصادر، بالسياق السياسي ـ الإيديولوجي ذاته، فكان على العرب القفز من الإقطاع إلى الاشتراكية.
إن السياق السياسي هذا سيطر على المنهج وأخضعه لغاياته بدلاً من أن يكون بحثاً في الواقع والتشكيلات في مسارها العربي، وقد تم نقل المخطط التاريخي الخماسي القائل بوجود خمسة تشكيلات هي المشاعية، والعبودية، والإقطاع، والرأسمالية، والاشتراكية، ثم تم خرقه بالقول بضرورة القفز على التشكيلة الرأسمالية.
فهنا تغدو مقولاتُ المادية التاريخية غيرَ قادرةٍ على النفاذِ إلى البُنى الاجتماعية العربية، حيث تدعو للقفز من الإقطاع إلى (الاشتراكية) وفي هذا القفز إنكار للمادية التاريخية، فهنا أيضاً لا توجد أمة عربية ذات سيرورة تاريخية خاصة، بل موديلات جاهزة، أي أن المادية الجدلية لم تتحول إلى مادية تاريخية، لأن كلا الماديتين لم تتشكل في مادةٍ بحثية عربية.
هنا يقومُ الوعي بإسقاط ذاته على الواقع الموضوعي، فيتم خرق القوانين الموضوعية باسم ذات القوانين، فموضوعيةُ التشكيلات التي تُلقى تتحدد أساساً بعملية الانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية، فهاتان البنيتان بحاجة إلى درسٍ عميق، وحين تضيع قوانين كلا التشكيلتين لا يتشكل وعيٌ موضوعي.
إن (الأنا) تسقطُ معايير النفعية والفائدة المباشرة هنا ويقودُ هذا إلى عدمِ رؤية القوانين الموضوعية للمادة، سواء كانت طبيعية عبر العجز عن قراءة العلوم الطبيعية معرفياً، أو اجتماعية بالعجز عن اكتشاف قوانين تطور المادة الاجتماعية بسبب الإسقاط السياسي، فتتآكل الفلسفةُ المادية على جانبيها الجدلي والتاريخي، ومن هنا لا تغدو لها حفرياتٌ مميزة في الحياة الاجتماعية.
إن الإسقاط السياسي يقودُ إلى عدمِ قراءة سيرورة التشكيلات الحقيقية ويكون لهذا نتائجه بعدمِ رؤيةِ خيطِ التطور الموضوعي، مما يفتحُ الطريقَ للعودة إلى المثاليات.
إن تحولَ النظرية الموضوعية إلى أفكارٍ تستهدفُ منفعةَ الذات الجماعية، وليس إلى وعي جماعي يكتشف القوانين الاجتماعيةَ ويسيطر عليها، تقود إلى تآكل النظرية وتحولها إلى مجموعات من الشعارات والأفكار النفعية المتقلبة، وهو أمر يفتحُ البابَ لمجموعةٍ من المناهج المتناقضة المضطربة، من المادية الميكانيكية والجدلية مع اشكالٍ من المثالية الذاتية في خليطٍ يتجهُ في خاتمة المطاف إلى عدم الصمود ونفي تناقضاته الداخلية إلى مركب جديد.
فتسيطر فكرة نقل الموديل ولكن هذا الموديل غير صالح للسكة التاريخية التي يفترض أن يمشي عليها، إن المادية الميكانيكية هنا تتفكك وتتحطم، ففكرة إزالة الدين كما جرت في الاتحاد السوفيتي أو الصين التي تنُقل ميكانيكاً هنا تتحول إلى رفض كلي للدين، أو تتحول إلى استغلاله سياسياً، أي دون دراسته وفهمه واتخاذ مواقف دقيقة من عمق هذه الدراسات.
وتقود عمليةُ القفز على التشكيلة إلى القفز على مفرداتها الموضوعية كالدين والملكية الخاصة والرأسمالية ، أي تقود إلى عدم تنمية تطوير العناصر الديمقراطية الجنينية وتحويلها إلى انعطاف سياسي في البنية.
إن كفة التيارات السياسية العربية ستقوم بإعادة إنتاج هذه الطريقة سواء أكانت قومية أم بعثية أم دينية أم وطنية إقليمية شمولية أم قوى مذهبية سياسية.
إن إسقاط أهمية الرموز الدينية التي خلقت البنى الاجتماعية الإسلامية، يقود إلى عدم القدرة على تفكيك علاقة الإقطاع بالدين والتحكم في السلطتين السياسية والدينية، وبالتالي يقود إلى عدم القدرة على تكوين جبهات سياسية عريضة للتحول الديمقراطي .
فهذه الرموز نتاج تطور طويل للبنى، بحيث تغلغلت في مستوياتها السياسية الفكرية — الاجتماعية والاقتصادية، فهي تقوم بإعادة إنتاجها، ومن هنا يتطلب التغيير إعادة بنائها.
تتكونُ في التجربة (الشيوعية العربية) كما هي في التجربة القومية – البعثية والمذهبيات السياسية المختلفة، (الذات) المتجوهرة حول الطبقة القائدة التاريخية أو(الأمة) العربية أو(الأمة) الإسلامية أو الطائفة، وإذا كانت الذاتُ الشيوعية مرتبطةٍ بالواقع وعمليات تحليله الطبقة والتاريخية فإن المفهوم الذاتي الجوهري لا يتغير نوعياً، فهذه الذاتُ ستخرقُ قانونَ تحليل الواقع الموضوعي وستطرح برنامجها القادم من الذات العالمية المتجوهرة، ذات الطبقة العاملة العالمية، كما ستتمظهرُ فى كيان رأسمالية الدولة الشمولية في الاتحاد السوفيتي أو الصين الخ.. أي كما تتصور الطبقة العمالية، أقسامٌ من الفئات الوسطى تُسقطُ أفكارَها ومصالحها على حركة هذه الطبقة، أي تقوم بأدلجتها.
وسيدورُ العالمُ حول هذه الذات، ولهذا فإن درسَ التاريخ يغدو إسقاطاً منها عليه، فهى لا تقرأهُ بموضوعيةٍ بل تُسقطُ عليه برنامَجَها السياسي، فتغدو هي مركزه؛ بدلاً من أن تقرأهٌ مستقلاً عنها.
ومن هنا سيغدو تغيير الواقع المعاصر كذلك مرتبطاً بهذه الذات، فسترى تطبيق برنامجها هو الحقيقة الاجتماعية الموضوعية، أي كل ما يجعل الطبقة العاملة تسود، وهذا ما يكرسُ نموذجَ رأسمالية الدولة الشمولية كما في مصر والعراق والجزائر وسوريا واليمن (الجنوبية) الخ.. وبدلاً من برنامج الحياة الموضوعية وهو برنامج هدم النظام الإقطاعي الديني، وتشكيلِ نضالٍ طويل متدرج لتغييره، بتصعيد مختلف العناصر الديمقراطية والتحديثية، سيجري القفز على ذلك، وسيجري تقوية أجهزة الدول المركزية، وثقافة الشمولية المختلفة، وبقاء النظام التقليدي في خاتمة المطاف.
إن الذاتَ هنا غير قادرةٍ على إنتاجِ مقولاتٍ فلسفيةٍ بسببِ هذه المثالية الذاتية، المثالية المتقوقعةُ حول (الأنا)، ولهذا لا تستطيع أن تحل معضلات فهم التشكيلات التاريخية رغم اقترابها من درس الواقع الموضوعي بشكل كبير، لكن هذه الدرس يهدمهُ تصور ذاتي عن الوجود، وهو تصور (طبقي) يعود لفئات وسطى شمولية.
وكل التصورات البحثية والقومية والمذهبية السياسية صادرة عن مفهوم طبقي، ولكن هذه التصورات سترفض مفهوم الأنا الطبقي، وتحل محله مفهوم الأنا القومي أو الديني أو المذهبي، ومن الناحية التاريخية الكبرى، أي عبر المصير المتوقع في مسار التشكيلة، سيكون الأمر متقارباً، أي لن يكون ثمة فروق كلية بل فروق جزئية.
فالأنا القومية هنا كذلك تقومُ بإسقاط ذاتها على الوجود كما رأينا في آراء المفكرين القوميين، فالأنا العربيةُ تقفزُ خارجَ الزمان والمكان، ولهذا تغدو مقولاتها شعرية لا فلسفية، خطابية لا مفاهيمية موضوعية، ولهذا فإن الفئات الوسطى المنتجة لهذه الدعوات، ستتقاربُ مع الفئات الوسطى المنتجة للشيوعية العربية عبر تصعيد دور الدولة كجهازٍ تقني لحل معضلات القفزة الحضارية، نحو الحداثة، وإذا كانت الأنا القومية ستعملُ للحفاظ على جوهر الأمة وبقائها الميتافيزيقي، الخارج عن التاريخ، فإن الذاتَ الشيوعية العربية سترى تصعيدَ دور الدولة وتضخيم الطبقة العاملة مؤشرات نحو تحقيق الذات بشكل آخر.
إن الذاتين الشيوعية والقومية تتصادمان أو تترافقان عبر تصعيد دور الدولة المركزية وهو أمر يقودُ إلى تصعيد دور المنظومات التقليدية السياسية القديمة، أي تصعيد الدولتين السنية أو الشيعية الرابضتين تحت القشرة السياسية الهشة للحداثة، وهنا يجري القيام بطلاءٍ تحديثي، مترافق كذلك مع إنجازات اقتصادية واجتماعية تدفع ملايين من السكان للالتحاق بالتجربة، والتظاهر معها، ولكن نظام رأسمالية الدولة شكل انتقالي بين التشكيلات، وهو في الدول الشرقية المتخلفة، يغدو شكلاً انتقالياً بين تجديد نظام الإقطاع وتشكيل رأسمالية بأدوات بيروقراطية.
وهذا الأمر يتعلق بتجربة كل دولة وتقاليدها السياسية والاجتماعية، فالعراق توجه عبر البعث نحو استعادة نظام الإقطاع المذهبي بصورة قمعية شديدة، في حين اقتربت تجارب أخرى من الرأسمالية المُكونَّةً بشكلٍ إداري شمولي كمصر دون أن تخرج من نظام الإقطاع المذهبي بعد.
إن الفارق يتحدد بمدى ظهور فئات وسطى صناعية حرة، تبدأ في الحفر لتشكيل نظام رأسمالي حديث. أي بمدى القدرة على إنتاج وعي وطني ديمقراطي يتجاوز الشموليات بأنواعها: الشيوعية، القومية التعصبية، المذهبية والدينية التقليدية الخ.
وبهذا فإن المذهبَ السائد وسيطرة الارستقراطية والذكور والشمولية السياسية والفكرية كلها يُعاد إنتاجها، وسيغدو المذهب الديني السياسي المهيمن الشكل الإيديولوجي للخروج من الأزمة الفكرية الناتجة عن فشل الطريق (الاشتراكي) المزعوم.
أي أن القوى المسيطرةَ على الجهاز السياسي والاقتصادي والعسكري الشمولي تواصل تاريخ الاستغلال السابق، لكنها في الدول العربية والإسلامية لم تستطع الخروج من التشكيلة الإقطاعية، فظلت أسئلةُ الحداثة حارقةٍ في جسمها السياسى والاجتماعى.
إن هذه أيضاً عدم قراءة موضوعية وتطبيقية لـ(القوانين)، فقوانين المادية الجدلية بقراءة الطبيعة تخرق على مستوى قراءة تطور المجتمع، فتنفك العلاقة بين جدل الطبيعة وجدل التاريخ، ويغدو المجتمع مرهوناً بمخطط ذاتي لدى القيادات، فتحل الإرادةُ الفرديةُ نفسها محل القوانين الموضوعية للصراع الاجتماعي، وتهيمنُ الأرادةُ الفوقية على الأحزاب؛ وتهيمنُ على الدول، وعلى الملكية العامة المُصادرة، فتتشكل فئاتٌ بيروقراطية استقلالية، تهدرُ الثروةَ العامة.
وبدلاً من تصعيد فئات وسطى وعاملة حديثة ديمقراطية، يقوم الهيكلُ البيروقراطي بنخر الحداثة الاجتماعية الضعيفة، وبدلاً من تصعيد فردية وتحررية اجتماعية وعقلانية، يتم القفز إلى هياكل إيديولوجية عامة فارغة، مثل (ضرورة هدم الطبقات) أو (هدم الأديان)، لكن في المحتوى الاجتماعي العميق تبقى الذكورية المتسيدة والقبلية والبيروقراطية المتحكمة في الثروة والأطر الإقطاعية المذهبية.
ويصل نظام رأسمالية الدولة الشمولية الشرقي إلى أزمته، فتتفكك المنظومة، وتوابعها داخل المعسكر (الاشتراكى) أو خارجه. مثلما تحدث أزمة الأنظمة الأخرى العربية المحافظة ذات الجوهر (الستاليني)؛ ملكية عامة بيروقراطية مسيطر؛ وهي فاسدة.
وقد لعبت التحولاتُ الاقتصادية النفطية دورها في تصعيد قوى الإقطاع المذهبية بشكل أكبر من السابق، وبدلاً من تصعيد دور الرأسمالية (الحرة) انتشرت القوى التقليدية والشمولية القديمة. فهذه التحولات جرت في البلدان الصحراوية والريفية متدنية التطور، فساهمت في تأخير المدن العربية السائرة سابقاً في طريق التطور الحديث. وهكذا فإن أنظمة الإقطاع المذهبية حصلت على دفعة قوية.
هذا أدى إلى صدمة لمركزية الذات الشيوعية والقومية، فالتصور السائد بحدوث القفزة، انقلب إلى حدوث الارتداد، وهو أمر قاد إلى تآكل الوعي والتنظيمات وأعطى دفعة للصعود المحافظ كذلك.
فإذا كان مثل هذا الوعي لم يستطع أن يصلَ إلى فهمِ أساسيات التاريخ، ووضع إرادته الذاتية بديلاً عنها، فإن الطوابقِ التحتية في ذاته مليئه بأشكال الغيبيات والمثالية، ولهذا فإنه حتى مفاهيم المثالية الموضوعية التي لم تتشكل هياكلها لم تستطع الحضور النقدي الاجتماعي، ولهذا فإن شتى أشكال المثاليات الذاتية تتفاقم وتتصاعد في مرحلة الانهيار
والاضطراب.
فمع مرحلة انهيار أسلوب ملكية الدولة المركزية الشمولية، على الصعيد العربي بسقوط الأنظمة الوطنية ذات الملكية العامة السائدة، أو بأزمات الأنظمة العربية المحافظة، تصاعدت موجةُ المذاهب النصوصية، كتعبير عن غياب بحث وتجسيد القانون نظرياً واجتماعياً.
فتصاعدُ الغيبيات المتطرفة كانتشار خرافات القبور وتحضير الأرواح الخ..
كان إعلاناً عن هجمة المناطق الرعوية والريفية، وبلدان الجزيرة العربية الصحراوية على المدن، النهضوية المتآكلة، وظهور زمن الثروة اللاقانوني، المستند إلى الصدف المحضة، وهكذا فزمن النهضة الأول المستند إلى اكتشاف وتجسيد القانون والصناعة الشخصية، تم القفز عليه عبر الانقلابات العسكرية ثم المناطقية المحافظة، وبهذا فإن الحكام المطلقين ظلوا في السلطة الأرضية كما ظلت صور الإله المطلقة الخارقة للقانون، أي أن الثروات وتوزيعها ظلت لدى أهل السلطة المتحولين والناتجين من تبدلات سياسية خارج الوعي والإرادة البشرية، وبهذا فإن النصوصيات الدينية المعادية للعقل صعدت بقوة، بدلاً من تراكم الفكر الموضوعي والعلوم.
إن الأفكار الدينية النصوصية المحافظة تقوم على صور الإله المتدخلة في كل شيء، تعبيراً عن ضعف الإرادة البشرية الشعبية تجاه التسلط الديني والحكومي، فتتوارى سببيات الثروة والأمراض والحروب وتدهور المدن الخ. . ويغدو كل شيء بـ(بإذن الله+ وأنشاء الله) وليس بإرادة العصابات الحاكمة في الحكم والدين.
وهذا يوسع انتشار اللاعقلانيات والغيبيات المتطرفة والصوفيات، وينهض الموتى للتحكم في الأحياء، وتسيطر الأرواحُ على الأجساد المفرغة من العقول. ويدير اللصوص المسرحين السياسي والاجتماعي.
isa.albuflasa@gmail.com

التطور الفلسفي العربي الحديث المبكر
إذا أخذنا سلسلةَ التطورات التي حدثت خلال القرنين الأخيرين ، فسنجد ثلاثة فترات كبرى: الأولى تمثلت في استيعاب المنجزات الغربية ، الثانية : في تشكيل تجارب لرأسمالية دولة شمولية، توهمت إمكانية تجاوز العصر الرأسمالي، الثالثة عودة متدهورة للفترة الليبرالية الأولى مع عودة كذلك للإقطاعين السياسي والديني الشموليين.
كان النهضويون الأوائل في القرنين الــ 19 والــ 20 يتصورون أن التماثل مع الغرب هو كفيل بخلق النهضة، وحين تزعزع هذا الوهم راح الدينيون يتصورون وهماً آخر هو استرجاع الفترة الأولى من العصر الإسلامى.
أي أن دراسة العصرين العربيين السابقين ورؤية تضادهما والخروج بتركيب منهما، وفي ظل ثقافة الحداثة المسيطرة، كان يمكن أن يكشف للعقول قوانين التطور الاجتماعي، وبالتالي يؤدي إلى التحكم فيها.
إن عصرنا العربي الإسلامي الراهن هو عصر التركيب، للعصرين العربيين السابقين، تداخل معهما ونفي لهما معاً. إنه عصر نفي النفي. وهو لهذا عصر التمثل العميق للحداثة العربية على مر الزمن والصعود بها إلى لحظة نوعية جديدة مقاربة لمستوياتها العالمية.
فأخذ إنجازات الثورة المحمدية، والجوانب الإيجابية من نضال الفئات الوسطى التحديثية في العصر النهضوي الأموي – العباسي السابق، وتشكيل نضال نهضوي للفئات الوسطى المتحالفة مع العاملين بشروط الحداثة المعاصرة.
وهكذا فإن إنجازات التحالف الشعبي الديمقراطي الإسلامي النهضوي الجريء في اقتحامه العالم، يضاف إلى تراكمية الثقافة الفكرية الموسوعية والانفتاح وعقلنة الفقه وعصرنته، وقد تم كل ذلك بوعي ديني مثالي مسيطر على أجهزة الحكم، تعبيراً عن القوى العليا مرة في تحالفها مع العاملين ومرة في انقطاعها عن التحالف مع العاملين.
وبهذا فإن طيفاً اجتماعياً واسعاً لابد أن يتشكل ليعيد إنتاج الحضارة العربية المستقلة الحديثة، وهذا التحالف الذي في جوهره تحالف الفئات الوسطى والعاملين، له مضمون اجتماعي هو إعادة تغيير طابع الدولة، في ملكيتها الاقتصادية الشاملة، وفي مذهبيتها السائدة المتحكمة، وفي تحرير كافة هذه الجموع من الدولة الإقطاعية – المذهبية، وفي خلق طبقات وسطى وطبقات عاملة حرة، تتداول السلطة حسب برامجها المقبولة للجمهور.
وعملية إجراء الإصلاحات في جسم الدولة – المجتمع الاقتصادي والديني والاجتماعي والسياسي، يعتمدُ على سلسلة من الإصلاحات في ظاهرات الوعي المختلفة.
إن جسم الدولة – المجتمع الذي يعيش النظام الإقطاعي المذهبي، يعيش المفردات الدينية الشمولية، كخلفية متحكمة فيه عبر القرون.
وإذا كانت صورة الإله الواحد المتدخلة في كل شيء التي زرعتها الأنظمة الاستغلالية فتلك صناعة الحاكم الواحد الذي يهيمن على السلطة – المجتمع زاعماً أنه شبه إله!
وقد قامت الفلسفات في العصر الوسيط الإسلامي بخلق وسائط غيبية متعددة في المشرق الإسلامي، ثم في المغرب أخذت نتخلصُ من هذه الوسائط بحيث غدت فلسفة ابن باجة — ابن رشد تشق الطريق نحو مثالية موضوعية.
لقد استغرقت العملية بين التكوين الديني الصوري القصصي الميثولوجي الحكمي، وبين تكون الفلسفة المثالية بمعمارها التعددي المفاهيمي عدة قرون، ثم إلى أن تكون مثالية موضوعية جنينية في الأندلس على بضعة قرون أخرى. وهذه المثالية الموضوعية الجنينية ترحلت إلى أوروبا لتبدأ رحلة جديدة في بُنى اجتماعية مختلفة مشكلة الرشدية المقاتلة المرفوضة من قبل الكنيسة ولكن التي وضعت الأساس لهدم هذه الكنيسة الشمولي.
فكأن الانتصار العربي الإسلامي في أوروبا!
وحين وصلت الفلسفةُ من أوروبا إلى العالم الإسلامي محملةٍ بكل هذا الزخم التحولي المتضافر الداخلي، فإنها لم تُفهم من قبل الجيل الأدبي، جيل التنوير الأول؛ فقد كان تاريخ أوروبا الوسيط والنهضوي والمعاصر معروضاً أمامه، بشكلٍ غامض، بحيثيات سياسية واجتماعية واقتصادية وفكرية، فكانت الوقائع الاجتماعية المباشرة كمظاهر التقدم في مختلف جوانب الحياة هي الطافحة على سطح الوعي النخبوي، وهذا ما كان يمثل له صدمة على صعيد أنه كان عبر موروثه يعتبرُ نفسَه محورَ العالم والبقعةَ الأكثرَ حضارةٍ فيها، ودينه يمثل أرقى تكون فكري عرفه الإنسان.
ومن هنا كان وعيه ينقلُ وقائعَ الحياة والثقافة بعناصرها المشتتة متقبلاً المظاهر الحديثة الأكثر وظيفيةٍ ونفعيةٍ والتي تغدو عبر التجارة مستخدمةٍ في حياته، محتفظاً ببنائه التقليدي المحافظ، حيث يعبرُ هذا الاحتفاظ عن جانبي الاستخدام الوظيفي وبقاء أسس النظام التقليدي التي تسيطر عليه القوى العليا، ومهما كانت التغيرات السياسية التبدلية في هذه القمة فإنها لم تغير هذا البناء، إن لم تحافظ عليه بقوة أشد.
من هنا كان الوعي التنويري أدبياً ثقافياً تقنياً عاماً، لا يستطيع أن يطرح المنظور الفلسفي، وأن يشكل نظرات عامة إلى الوجود، حيث ان وجوده الاجتماعي هو ذاته مقلق وغير مفهوم.
فكان عليه أن يعي أساسيات وجوده الوطني أولاً، أي أن يقوم بخلقِ لحمةٍ في بنائه السياسي التابع والمتخلف، وهو أمرٌ يجعل البنى العربية والإسلامية المفتتة تقومُ ولهذا فإن الاحتكاك بأوروبا كان يتيحُ استخدام بعض الأسس السياسية الاجتماعية الأوروبية في العمل لتشكيل هذه البنى، وكل بنية عربية وإسلامية لها ظروفها وسيرورتها الخاصة، والمتداخلة مع السيرورات الأخرى كذلك.
إذن كان الوعى وهو يشكلُ البنية التقليدية – المحدثة، يمر بمرحلة التأثر الأوروبى – والعودة إلى الماضي، عبر استخدام مفهوم النهضة، وهو الذي كان يتيح استعارة الأشكال الأوروبية وتركيبها فوق الجسد القديم، مع الزعم بأنه يتحدث، فهو يغرف من الماضي المجيد، وكذلك يستفيد من الخبرة الأوروبية، التي كانت (وليدة التأثير العربي).
ولكن لم يكن يدرس هذا التداخل العربي – الغربي في سيرورته التاريخية المعقدة والمتوارية، أي أن يدرس رحلة المثالية الموضوعية وتبدلاتها العميقة في أوروبا، من الرشدية المُلاحقة إلى الديكارتية المنفصلة كثيراً عن تقاليد الفلسفة الدينية للعصر الوسيط.
إن ثمة عدة قرون أخرى بين الرشدية الملاحقة وبين الديكارتية، وهذه السيرورة لن تُدرس عبر هذا الوعي الأدبي – الفني وهو يقابل أمثاله في الإنتاجين الأوروبي والعربي القديم، لكن هذا الدرس المتعدد الأشكال سوف يضع مادة ثقافية كبيرة للمرحلة التالية وهي مرحلة الوعي الفلسفي.
وهناك عناصرٌ فلسفية مشتتة في داخل هذه المرحلة، فكان التأكيد على الخلق الإلهي للعالم، يتداخل مع الإيمان بالضرورات الموضوعية للوجود، وهو أمر يشير إلى هذه الثنائية بين الجذور المتواصلة الحضور، أي بين النظام المحافظ بألوهيته المطلقة، وبحكامه المطلقين، وببنائه الاجتماعي الذكوري – الأرستقراطي وثقافته السحرية – الدينية، وبين ضرورات التحديث التقنية.
فكان التقنيون فوق الجسد المحافظ يستوردون المنجزات البنائية والتقنية والأدبية والديكورية الخ.. إن فكرة الخلق الإلهي والسببية المحدودة، تتماثل وعملية التداخل العربي – الغربي في مرحلة الاستعمار والتجارة وإنتاج المواد الخام، فهما تتيحان الحفاظ على النظام التقليدي بأسسه الدينية، وأيضاً تطوير بعض الجوانب في الحياة الأكثر إلحاحاً كتغيير الحرف ونمط المدن والإدارة ونظم التعليم الخ.. لكن عمليات التغيير تتجه إلى جوانب أكثر عمقاً بطبيعة تطور الحياة، وسواء بسبب من اهتراء القديم، أم من هجوم الجديد، وهذا يمكن ملاحظته في تعمق الأشكال الأدبية كالقصة والرواية والمسرح، وتوجهها نحو عمليات تحليل الواقع بصورٍ متزايدة، وكذلك عمليات اتساع العلوم ونمو تخصصاتها، والتبدل المستمر بين حجم الزراعة وحجم الصناعة، واستعادة المدن العربيةِ دورها النهضوي، وبدء إلحاق الريف والبادية بتحولاتها.
ومن هنا فالسببية سوف تتزايد عملياتها في الوعي، وتصبح الظواهرُ المشتتة في الوعى التنويري الأولي أكثر ترابطاً؛ فلم تعد العملية استلال عنصر وحيد من التراث، أو من الغرب، بل أخذت عمليات النظرة التركيبية بين الثقافة والوجود الاجتماعي والتاريخي، تتشكل في العقل النهضوي الجديد، وأصبح العالم العربي الإسلامي بتطوراته الكبرى مرئياً في هذا العقل، ولكن في ظاهراته الفكرية الروحية المستقلة عن البنى الاجتماعية التي يتشكل فيها.
يمكن هنا أن تتشكل لمحاتٌ من العرض الاجتماعي، لكن الوعي يظل مستقلاً، وبه سبيياته الداخلية المترابطة الأعمق، والمنفصلة عن البنى الاجتماعية.
هنا علينا أن ندرس الصراع بين المثالية الموضوعية الدينية والمادية الجدلية، كتعبير عن طفولية الوعي الفلسفي في الجانبين. من جانب عجز المثالية الموضوعية عن النمو وكشف الواقع، وقفزة المادية الجدلية للريادة الكشفية، وإخفاقها في ذلك، عبر حدوث فجوة كبيرة بين المادية الجدلية والمادية التاريخية.
isa.albuflasa@gmail.com
مكونان لا يلتقيان

لأن البحرين تكونت صغيرةً منفصلةً عن ثدي أمها الكبيرة الجزيرة العربية، مرةً بشكلٍ جيولوجي، حين اندفعتْ من خليج سلوى، ومرةً بشكل سياسي اجتماعي عندما انفصلتْ عن الصحراء العربية وصارتْ لؤلؤةً غيرَ مخطوفةٍ لفارس، فغدت هذا الكيان الصغير المتوتر الحاد العواطف، السريع التأثر، الشديد الهبوط العنيف على الأرض.
من الناحيةِ الاجتماعيةِ لم تؤهلها الظروفُ الاقتصاديةُ لأن تشكلَ طبقةً وسطى التي تم غياب طلائعها أكثر من مرة، حين قفزتْ على السير الصبور السياسي في منتصف الخمسينيات من القرن العشرين، وحين خطف اليسارُ دورها، بدواعٍ تعجيليةٍ خاصةً مع غيابِها عن الساحة وقد أفاد إلى حين، لكنه واصل هذا الدور حتى عندما بدأت تتحرك وتستعيد نشاطها الاقتصادي الاجتماعي السياسي، وهذا التنطعُ لدورٍ أصبح ليس بقدرتهِ، جعله يخسر الكثير، فوجد نفسه مُلحقاً بالقوى الطائفية المحافظة.
من اليسار بكل طموحهِ إلى أن يكون مُلحقاً بقوى محافظة رجعية هوة توضحُ حجم الانهيار في عظامهِ الداخلية التي خوتْ من الدم الشعبي والعقلانية والتراكم الديمقراطي، وتوضح كذلك هيمنة شعارية المغامرة وكيف تنتصر في بضعة أيام مع غيابِ الثقافة الديمقراطية.
عاد المجتمعُ لمكونيه الطائفيين، وضد أكثر من نصف قرن من جهودِ هيئةِ الاتحاد الوطني لتكوين ثقافةٍ وطنية، ومع كل الثيمات السياسية التي كلها تصيحُ بمعزوفة (الوطني) من جبهةِ التحرير الوطني حتى بنك البحرين الوطني، لكن لم يظهرْ هذا الوطني مكتملاً متجسداً في مجتمع.
كلُ جماعةٍ تأتي وكلُ سياسةٍ تنأى عن التوحيد التراكمي في الثقافة والعمل. كلُ فصيلٍ يريدُ أن يكون هو كل شيء، والمقاربة الديمقراطية لا تحصل على فرصها، وتنفضُ بحالاتٍ من الرعب والاجتثاث.
ثم برز المكونان الطائفيان أخيراً واضحين جليين، كشفا عن نفسيهما، ألقيا الثيابَ والأقنعةَ والمكياج وتقدما لكي يشطرا البلدَ وبقي من الزمان خطوة، وعن المجزرة شعرة.
حين تجلس على طاولة الكلام أو طاولة الشرب أو حتى تراب الجنازة، سوف تسألُ: من أي طائفةٍ هؤلاء؟ هل سوف أستطيع أن أتكلم معهم؟ هل هم معنا؟ هل من… أم هم من…؟
استطاعَ الطائفيون اختراقَنا بشكلٍ مرير.
هدموا بذوراً ومظلات صغيرةً لكي نقفَ معاً.
صار الفمُ يغص بمسامير وشظايا من زجاجٍ وهو يتكلم.
أنشأوا تنظيماتهم السياسية وهي كما يُفترض ذروة الوعي.
التنظيمُ السياسي قمةُ الوعي البشري، يحددُ الخطوطَ الأساسية لمسيرة أي مجتمع، ويعبئ الجهود من أجل تحقيقها.
لكن حين يكون التنظيم طائفياً فأي أهداف أساسية سوف يحققها؟
التنظيمُ الطائفي يعني أن يحققَ دولةً لطائفته. لا يوجد معنى آخر. أي أن يغدو شكلاً دكتاتورياً يمنعُ الطائفةَ التي يحكمُها من الامتزاجِ في طائفةٍ أخرى، يمنعُ تكونَ الشعب، وتحديث النساء وصيرورتهن مواطنات، يرفضُ ظهورَ الأحزاب المنافسة في منطقته فيقومُ بافتراسِها دينياً سياسياً، يمنعُ تكونَ الدولة الموحدة، وكلَ قيمها من عقلانية وديمقراطية وعلمانية ووطنية.
التنظيمُ الطائفي لا يعترفْ بمنجزات الحداثة، هو نتاجُ العصور الوسطى، ودول الطوائف والجماعات الدينية المنفصلة، وعالم النصوص الدينية المطلقة، وهذا التنظيم الرجعي يتفجرُ بسيطرتهِ وغلوائه في زمن الانفجار المعرفي وتوحد الدول والقارات والشعوب!
التنظيمُ الطائفي قمةُ الدكتاتورية ويطلبُ ديمقراطية!
يمنع حرية النساء واستقلال العمال والمثقفين ويقيم هيمنةً عنيفة متوارية داخلية في طائفته ويتقدم من أجل الحوار الديمقراطي والملَكية الدستورية والجمهورية الإسلامية، يلغي الآخرين في كيانه الخاص ويمنع التعددية ويريد أن يوسع حجم هذا الكيان لكي يفرض سيطرة القرون الوسطى على العصر الحديث، ويريد من الآخرين التنازل فيما يبقى في عليائه يرفض أن يتقدم لعالم الحداثة والحرية.
البحرين لم تستطع أن تَكون المستوى المتقدم من الديمقراطية وهي محاطة بجبالٍ من دولٍ تُصدر أعنف أشكال الدكتاتورية، وتريدُ أن تكونَها في زمن الاستقطاب الطائفي!
لا ديمقراطية مع تكوينات طائفية، لابد أن يُطلق سراح الأمهات والزوجات المستعبدات في الغيتو الطائفي، لابد أن يكون العقل هو السيد، لابد أن يُحرر الأطفال من الشحن المدروس الطائفي المؤسساتي، لابد أن تتحرر النصوص الإسلامية من هيمنة الخرافة، لابد أن تكون القبلة السياسية موجهة للوطن لا خارجه.
الأمل في الشباب يتطور لا تبعاً لضرورات العيش المتدني بل لتطور رؤاه العلمية ومواقفه الوطنية.
isa.albuflasa@gmail.com
بيع كتب ومؤلفات عبـــــــدالله خلــــــــيفة

أزمة اليمن
≣ اليمن والخليج بين المبادرةِ والمغامرةِ
≣ صراع الإقطاع في اليمن
≣ صراع الطوائف والطبقات في اليمن
≣ غياب الجدل من تاريخ اليمن
≣ أزمة اليمن
≣ اليمن من القبليةِ إلى الديمقراطية
≣ اليمن: أصراعٌ قبلي أم تحديثي؟
كتب: عبـــــــدالله خلـــــــيفة
≣ اليمن والخليج بين المبادرةِ والمغامرةِ
27 /2/ 2013
اليمن والخليج والجزيرة العربية في محاولاتها الدؤوب للتوحد والنهضة والتعاون تصطدم بقوى التفكيك والرجعية الطائفية، وقد اتخذت لها الآن أنياباً ذرية.
الكيانات المدعوة للتقارب المستمر وتنفيذ مشروعات التصنيع والتعليم والتغيير تزيحُ الأسلاكَ الشائكة الحدودية وتصطدمُ بإمبراطورية الشر وقوى المحافظة المتخلفة غير القادرة على إنتاج مشروعات التعاون والعلاقات السلمية المتكافئة بين الدول، شعارُها أما أن أُهيمنَ أو أُخرب.
واليمنُ ساحةٌ مستمرة للصراع، مثل بقية الدول التي تعاني من نفس الثيمة السرطانية.
قوى الفئاتِ الصغيرة الفوضوية المغامرة تلاعبتْ طويلاً بشعاراتِ الوطنية والقومية والاشتراكية، ركضتْ فوق جسد اليمن الجنوبي تقفز به من إستقلال هشٍّ متواضعٍ إلى الاشتراكية العسكرية الحكومية التي تعجزُ عن تطوير التنمية وإنهاضِ مختلفِ الطبقات، فلا تبقى سوى قواها الصغيرة المترجرجة بين الطبقات، لا تمتلكُ رؤيةً للواقع والتاريخ والمستقبل، حتى صحّرتْ الجنوبَ من قدراته المادية وسلمتهُ لقوى الهيمنة العسكرية الرجعية في الشمال، ثم لما تقلصتْ سيطرتُها وضاعتْ بين قوى الشمال المحافظة الواسعة التي دهستها بإرهابها أرادتْ أن تعودَ لدولة الجنوب المستقلة، فانتهزها الرئيس السابق فرصةً ليثأر من عدن مدينة التقدم.
كأن الأرضَ هي ورقةٌ لهذه الفئاتِ الصغيرة على مائدة القمار السياسية، فواصلت إرثَ السلاطين والإقطاعيين وعجزتْ حتى عن سمات الحداثة الديمقراطية الوطنية الأولية.
تلاقي هذه الفئاتِ الصغيرة الفوضوية مع الدكتاتورية الإيرانية الممسكة بنفس الرقعة الجغرافية السياسية المضادة لأبسط سمات الحداثة الديمقراطية التوحيدية، يبرزُ الشخصيةَ الحكوميةَ الإيرانية الانفصامية، ففي الداخل الإيراني هيمنةٌ قسرية على كل المكونات الاجتماعية الإيرانية ومنعها من التعبير المستقل، وفي الخارج تفتيتٌ للبُنى والأنظمة الموحِّدة وعمليات التعاون والوحدات الديمقراطية النهضوية العربية.
وتلاقي المجموعات البرجوازية الصغيرة الفوضوية المغامرة مع الاستراتيجية الإيرانية ليس صدفة ولا هو مثير للعجب. وكانت المجموعاتُ المراهقةُ في الحزب الاشتراكي اليمني السابقة الذكر نموذجاً راكم الحماقةَ على مدى عقود.
لقد عملتْ على عدم خلق التراكمات النهضوية والديمقراطية البسيطة في اليمن وتصعيدها بصبر سياسي، وبتعاون اقتصادي مع كافة الطبقات، وهو البرنامج الذي لايزالُ مطروحاً ويتعرض لمناجل الثوريين الزائفين والمحافظين المتخلفين معاً.
مجموعاتٌ منتفخةٌ بذاوتِها ولا يهمها سوى مقاعدها السياسية المتآكلة، وهي تستغلُ التناقضات في تطور الحياة الاجتماعية السياسية اليمنية لكي تكونَ في المركز المسيطر، لكن دولةَ الوحدة اليمنية تجاوزت كتل الإقطاعيين والقبليين والطائفيين المُفتتين، وهي تصارعُ بقوةٍ رهيبة الإقطاعيين العسكريين في السلطة والذين يخرجون منها عبر المذابح التي يصيبون بها الآخرين.
هذه الكتل التي تحيا على دم المجتمع والبشر تتصارع ثم تتلاقى!
كانت الثورة اليمنية الشعبية قد فككتْ الدكتاتوريةَ وفرشتْ بساطاً جديداً على الأرض الموحدة بتضحيات العامة وليس بقُطّاع الطرق السياسية الطائفيين في الشمال ولا بالمهاجرين الارستقراطيين المتاجرين بالدم، المتلاقين مع الشبكة الإيرانية التي تصطادُ الحشرات السياسية السامة في كل أرضٍ عربية.
لقد مثلت القوى الشعبية البسيطة المتحركة بعفوية وأحياناً بسذاجة، وليس ثمة من تبلور طبقي سياسي تحديثي يطورها ويحدد خطواتها المستقبلية في الديمقراطية والعلمانية والتحديث وحريات النساء وتقدم العمال والتصنيع، ولهذا فإن القوى المحافظة ذات العامة غير الواعية السائرة وراءها تسيطرت عليها في الانتخابات والمجالس النيابية، لكن الجماهير تتعلم.
اليمن وهو يقتربُ من المعافاة السياسية يصيب القوى الإيرانية الخائفة من تقدم الشعوب النهضوي الديمقراطي بالرعب، فتساهم بقوة في تأجيج الصراعات، وتحرك بعض العوام الجهلة بأبعاد الواقع لكي يضربوا عجلات التقدم التي تتحرك بصعوبة، ويرفعون شعارات ثورية زائفة بغرض تمرير الأجسام السامة.
وإذا كان قائد من الحزب الاشتراكي يتعاون مع الفاشية الإيرانية فليس بغريب ذلك ما دامت الانتهازية والمغامرة التي دمرت التنظيم والماركسية الجنينية اليمنية هي عادات أمثال هؤلاء الخونة الطبقيين والوطنيين.
≣ صراع الإقطاع في اليمن
2004/5/25
تابعت ندوةً بين ممثلين للقوى السياسية والفكرية في اليمن على إحدى المحطات الفضائية، التي تركز فيها النقد على احتكار حزب المؤتمر الشعبي العام للسلطة السياسية.
يركز المتحدثون في الندوة على الظاهرات السياسية المفصولة عن البنية الاجتماعية، وإذا استطاعوا ربطها فإنهم يربطونها بالتفرد في القرار الرئاسي أو بحكم الفرد.
ومن الواضح أن مثقفي كل بلد عربي يتمترسون داخل تجربة بلدهم الخاصة، فيعزلون تسارها عن مسار الأمة العربية والأمم الإسلامية عامة، وهو أمر يمثل خصيصة أساسية من خصائص الوعي السياسي العربي، الذي يعزل تجربة البلد والشعب المعنيين عن تجربة الأمة، كما يقوم بعزل المستوى السياسي في بلده عن جذوره الاجتماعية والتاريخية.
أي هم لا يدركون بأن تجربة اليمن في صراعها السياسي مماثلة لتجارب البلدان العربية الأخرى، حيث إن مستوى البنية وتناقضاتها الأساسية متماثلة، والاختلاف هو في أحجام وتمثلات وخصوصيات هذه البنية.
فالصراع بين الإقطاع السياسي والإقطاع الديني، أي بين حزبي المؤتمر الشعبي العام، وحزب الإصلاح، هو ذاته الصراع الذي يجري فى الأقطار العربية الأخرى.
أما لماذا يكون هذا الصراع متجسداً كذلك في مصر بين الحزب الوطنى والأخوان، أو فى الجزائر بين حزب جبهة التحرير والإدارة الحكومية والجماعات الدينية الخ.. فهو أمر لا يرى من قبل ممثلي التيارات السياسية العربية.
إن الإقطاع السياسي الحاكم يقوم بسرقة المال العام عبر آلة الدولة، أما الإقطاع الديني فهو يقوم بسرقة المال العام عبر الدين، وكلا النمطين من الاستغلال يمثلان استغلالاً تقليدياً أي يمثلان استغلالاً يعود لنمط متخلف من الإنتاج.
ولهذا فإن كلا الإقطاعين بحاجة إلى تكريسِ أنماطٍ معينة من الدكتاتورية، قد تتباين، لكنها تعود لجوهر اجتماعي وسياسي واحد. فحزب المؤتمر الشعبي يعتمد على آلة الدولة وهيمنتها، لكنه أيضاً يستند على القبلية والذكورية، بدرجة أقل من حزب الإصلاح، غير إنه لا يختلف عنه نوعاً.
ومن هنا فحزب المؤتمر الشعبي يتشكل على أساس الفئات البيروقراطية والعسكرية العليا المهيمنة من المركز. وجعل المناطق القروية والقبلية الفقيرة تابعة لاستغلال المركز.
ورغم انتماء بعض ممثلي حزب الإصلاح القياديين إلى الفئات الوسطى عموماً، إلى أنه جعل المذهب أساس السيطرة السياسية وهذا يكرس الحزب معبراً عن قوى الإقطاع الديني التي كرست سيطرتها داخل النص الديني بشكل تقليدي، أي التي جعلت الدين حصالةً مالية لعملها.
إن الآلة السياسية الحاكمة والآلة الدينية الحاكمة في مستويات العلاقات الاجتماعية والتقاليد، هما آلتان ضخمتان وكبيرتان، وزحزحة مثل هاتين الآلتين تحتاج إلى نمو كبير للقوى المتوسطة والعاملة الحرة.
وكما أشار المتحدثون فإن نمو المؤسسات التشريعية وانتقال سلطة القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إليها، هو الحال المؤدي إلى تفكيك الإقطاع بقسميه السياسي والديني، وانتقال السلطة إلى الشعب.
لكن هذا الانتقال ليس آلياً ولن تقع ثمار الديمقراطية بسهولة في حضن الشعب، في وجود بنية اجتماعية متخلفة، ستجعل السلطة التشريعية إلى زمن طويل في ذيل الحياة السياسية، وتابعة للسلطة التنفيذية.
ولهذا فإن قوانين الانتقال الديمقراطي العربي هي كذلك قوانين عربية شاملة، أي متماثلة نسبياً، تعتمد على مدى نمو الفئات الوسطى والعاملة وتفكيك التخلف الفكري والاجتماعي في البناء الاجتماعي.
أي أن القفز على مثل هذه الظروف الموضوعية ستجعلها مجرد مغامرات سياسية، ولهذا تحتاج إلى تراكم طويل.
≣ صراع الطوائف والطبقات في اليمن
2008/11/8
كبقية الدول العربية عملت القوى المحافظة على تفكيك العلاقة التحالفية بين قوى الحداثة التي تصارعت مع بعضها بعضا في اليمن، فكان يُفترض لمؤسسي وحدة اليمن: حزب الوحدة الشعبية الشمالي والحزب الاشتراكي في الجنوب أن يمتنا دعائم العلاقة بينهما، وينشرا التنوير والديمقراطية والحداثة.
ولكنهما لم يفعلا ذلك بل انجرا لتأثيرات القوى المعادية للوحدة اليمنية وللتقدم في اليمن، واستدرجا لصراع ضار مدمر.
في البدء عنت الوحدة قبول الجنوب بسيطرة الشمال القوية، وكانت تضحية من الجنوبيين، وتمثل ذلك في سيطرة مؤسسة الرئاسة في صنعاء وجيش الشمال، وقبل الحزب الاشتراكي بدور الشريك، لكن تم تفكيك عرى العلاقة بينهما.
علينا من البداية أن نقرأ أخطاء الحزب الاشتراكي اليمني، لقد كان حزبا جنوبيا بامتياز، ولم يكن قادراً على التغلغل في الشمال، ولم يفهم ظروف اليمن بدقة، وضرورة النضال الديمقراطي الطويل والتحالف مع كل القوى الديمقراطية بدلاً من الركون للقوى العسكرية، وللمؤسسات الحكومية المخترقة من قبل قوى التخلف والاستبداد في الشمال، وبالتالي جاءت موافقته على مسألة “الوحدة اليمنية” غير متبصرة وسريعة، وألقى بنفسه في ساحة هائلة، كما أن قياداته كانت ذات مواقع قبلية مناطقية ولم تستطع أن تخلق تنظيما وطنيا ديمقراطيا واسعا، فقد قادت شعارات التأميم للملكيات الصغيرة والتطرف اليساري والقفز على ظروف اليمن وعدم فهم مرحلته السياسية إلى وجود شلل شمولية داخل التنظيم، قادت إلى مغامرات وصراعات ضارية.
إن فكره “الاشتراكي” كان طفوليا، ولم يشكل ثقافة ديمقراطية وطنية تلائم ظروف اليمن القبلي والأمي، ثم قفز إلى وضع سياسي هائل هو وضع الوحدة التي ذوبته وسط الشمال الكبير عليه.
في حين كان حزب الوحدة الشمالي الحاكم حزبا قبليا بامتياز لقبيلة حاشد، التي هيمنت على السلطة، وأورثت جماعاتها هياكل الدولة، وكان خيار الوحدة لها ليس خيارا ديمقراطيا وطنيا بل سيطرة قبلية كاملة، ولا شك أن دغدغة مشاعر الرئيس للهيمنة وأن يكون الشخصية الأولى والوحيدة والتي تورث حكمها لابنها وتحويل النظام الجمهوري إلى نظام ملكي أسوة ببقية الجمهوريات العربية، كانت تتلاقى وتتوحد في تيار شمولي شمالي قوي.
ووجد حزب الإصلاح المذهبي السياسي (السني) في هذا التحالف الشمالي في أول الوحدة وسيلته لضرب الحزب الاشتراكي اليمني، خوفاً من توجيه الوحدة نحو الاشتراكية والحداثة.
وهكذا فإن قوى تحديثية عديدة وجدت نفسها في خنادق متضادة، وراحت دولة الشمال وجيش الشمال يذوبان القوى الجنوبية التي توحدت معهما وأعطتهما السلطة، وغدت المعركة سياسية وشخصية، ثم تحولت إلى معركة حربية شرسة مخيفة، هجم فيها الجيش على الجنوب، واتضح فيها أن الشمال يفترسُ الجنوب لا أن يتوحد معه.
“وعلى الرغم من أن أصعب الأزمات التي تواجه الرئيس صالح هو صراعه مع القوى المتضررة من الحرب الأهلية في 1994، والتي كان الاخوان المسلمون شركاء الرئيس صالح فيها، حيث كانوا من أشد التيارات تحمسا لها، معزولة عن سياق الصراع الراهن بين النخبة الحاكمة والإخوان، فإن أغلب الكتاب المؤيدين لنظام صالح يرون أن تجمع الإصلاح الإسلامي متورط في تأجيج مشاعر أبناء الجنوب ويعمل بذكاء شديد على استثمار الوضع لتشتيت طاقة النظام وإضعافه.”، (الشرق الأوسط، اليمن صراع السياسة بين الرئيس والاخوان، 29 اكتوبر، 2007).
لقد دمرت القوى التحديثية الوطنية: المؤتمر الشعبي، الاشتراكي، الإصلاح، أنفسها في صراعها الجانبي، المدمر، وكانت الحصيلة هي ظهور مؤسسة الفرد الواحد الحاكم المطلق، وهشاشة وضع القوى التحديثية التي أسهمت في صعود دولة الوحدة ونخرها بالصراعات الفئوية.
لقد كان هذا من أخطر إفرازات الحرب، فليس رئيس السلطة كفرد هو القضية، بل صعود الفرد المطلق مع قبيلته. لقد أدت نتائجُ الحرب إلى رجوع اليمن خطوات كبيرة للوراء، إضافة إلى فقد عشرات الألوف من القتلى والخسائر المادية الجسيمة.
وبدلاً من انتقال اليمن للحداثة والوطنية والديمقراطية عاد اليمن كلية للقرون الوسطى سياسيا، لقد نزع قشرة الحداثة الهشة من فوق جسده القبلي المحافظ وبان على طبيعته.
ومع ذلك فإن البقية الباقية من عناصر الوعي الديمقراطي الوطني في الحزب الاشتراكي اليمني حاولت أن تخرجَ من هذه الثنائية القاتلة، ثنائية الجنوب والشمال، ثنائية الاشتراكي والرأسمالي الخيالية، ثنائية الحياة والموت، بالتوجه إلى أساس المشروع التوحيدي وإلى عناصره الديمقراطية الصغيرة وإعادة إحيائها.
لكن الشمال القبلي المسيطر عاد إلى عصره الإقطاعي الشامل، لقد افترس الجنوبَ وتركهُ ينزفُ ويلعقُ جراحَه.
لقد استولى كلية على السلطة ولم يعد أحدٌ ينافسه من الجنوب، فقادة الاشتراكي الأقوياء الذين حرروا الجنوب من الاستعمار البريطاني إما قتلى وإما هاربون، ومن رفض الحرب وصراعاتها وتهميش ما بعدها لم يُترك ليعيش بل انقضت عليه عصاباتٌ تعددت أقنعتها ولها مضمون واحد.
لم تكن حرب الانفصال والوحدة سوى حرب الجنون القبلي، فكأن الشمال كان يثأر من تقدم الجنوب، وينشر قبليته الكاملة في الفضاء اليمني لتسود، وما يدري ان هذا التسويد سيكون خرابا قادما واسعا للشمال.
لقد اتفقت القوتان السياسيتان الشماليتان حزبا المؤتمر الشعبي والإصلاح على تحطيم المعارضة اليسارية التي كانت جزءاً من الحكم، عبر حرب لبست قناع الدفاع عن الوحدة، ولم تكن سوى عملية ثأر متخلفة ضد التحديث الجنوبي، الذي كان يمضي بخطى صغيرة نحو صهر الشعب في كيان تحديثي موحد، وجاءتْ عملية الثأر من منطلقات مختلفة، من قبل كراهية اليسار والاشتراكية، وإقصاء المنافسين في الحكم، وتوسيع حصيلة أنصبتها في السلطة.
لكن السلطة كانت تعود للوراء.
كانت تغرق في العالم السعيد الإقطاعي، عالم القبائل المتصارعة، عالم شيوخ الدين الحالمين بسلطة مطلقة، عالم المناطق التي راحت ترفع رؤوسها مطالبة بالحكم الذاتي، عالم القبائل التي تعتبر أراضيها من سلطتها، فتعتدي على السياح وتتدخل في امتيازات النفط، وتلجأ إلى خطف البشر والمطالبة بفدى.
لقد عاد اليمن للوراء.
لماذا لم تؤد ما سُمي في عاصمة الوحدة صنعاء بحرب (الدفاع عن الوحدة) إلى مزيد من الوحدة والتقدم والإصلاح؟
لماذا أخذت الخريطة اليمنية في التمزق المستمر بدلاً من نجاح المنتصر ونشره للسلام والتقدم؟
لماذا عادت الأمور إلى الوراء بشكلٍ رهيبٍ وعلى نحو متسارع؟
لقد بدا للوهلة الأولى أن المنتصرين الشماليين حزبي المؤتمر الشعبي والإصلاح قد شكلا علاقة تحالفية وثيقة، وأنهما قادران على تجاوز غياب الحزب الاشتراكي اليمني المؤسس الثاني لهذه الوحدة العتيدة، ولكن ذلك لم يحصل بل دب نزاعٌ كبيرٌ وواسعٌ بين الطرفين المنتصرين.
كان هذا أيضاً حدثاً مؤسفاً، فقوى التحديث الوطني اليمنية ككل تمزقت على نحو مروع في المرحلة السابقة،
وقوى كثيرة أُقصيت عن السلطة والمشاركة، في اليمن الموحد غير السعيد، المتقاتل، ثم الآن دب الخلافُ الواسع في الشمال، وانتقل المتحالفان إلى حرب سياسية متأججة لم تـُستعمل فيها بينهما لحسن الحظ أدواتُ العنف.
لنقل إن المشكلات تفاقمت في البلد الفقير، والدولة حين تنتقل من التنوع والتعددية الحاكمة الشخصية إلى التفرد الشخصي – القبلي، تكون قد عبرتْ عصر الحداثة باتجاه عصر ملوك الطوائف.
إن الدولة التي تقودها قبيلة حاشدة ضخمة، تتوارث الامتيازات والنفوذ والخيرات، لا تريد أحداً آخر ينافسها ويشاركها في الحكم، وبالتالي كان عليها أن تلتف حول الرئيس وتضخم من صورته وتوسع من سلطاته وإمتيازاته.
“وبينما يتهم الحزب الحاكم بأن خطابها المشكك في شرعية الحكم والقائم على التعاطف مع تلك الحركات قد أضعف الدولة وهيبتها ومكن لتلك الحركات من تهديد مستقبل اليمن، فإن المعارضة بدورها تحمل الحاكم المسؤولية وتعتقد أن استحواذ الحزب الحاكم على مفاصل السلطة واستبعاد القوى السياسية الفاعلة من المشاركة في السلطة والثروة وعدم اهتمامه بمشاكل الواقع هي من يسهل الطريق أمام الفوضى”، (اليمن يغرق في عاصفة الانفصال والارهاب وإيران)، (الشرق الأوسط، 14 أبريل 2008).
نستطيع القول إن شهية الشمولية تكون عادة مفتوحة حين تهضم أي خصم سياسي كبير، فتنتقل لالتهام الخصم التالي وهكذا دواليك، فتلغي سمات التحضر الحديث، خاصة مع فواتح الشهية مثل ظهور النفط وتصاعد ثروات التنمية التي تـُحتكر من قبل الحكم وتتسع بعد تصفية الخصوم والرقابة.
فصار حزب الإصلاح المذهبي السياسي، لأنه يقتصر على جماعة سكانية مذهبية واحدة، ومحاولة تسييسها، خصماً لأنه يريد حصة أكبر في السلطة، بل يتطلع إلى الهيمنة عليها ما استطاع إلى ذلك سبيلاً.
لكن حزب الإصلاح يمثل عقلية تقليدية محافظة، ففقهها يعود لمرحلة الإمامة وربما أبعد من ذلك، وحزب المؤتمر الشعبي الحاكم حزب (وطني)، مقارب للعلمانية الحديثة، رغم انه حزب ديني كذلك وينتمي إلى الطائفة نفسها، فكان عليه أن يركز في نقد الوعي المذهبي المحافظ وخطره على التقدم، بعد أن كان شريكاً في معركة النضال المشترك ضد الخطر الاشتراكي الانفصالي الملحد.
«… فحزب الإصلاح الذي كان يمثل الشريك الأبرز لنظام صالح، أصبح يمثل العدو اللدود المهدد لمستقبل النخبة السياسية المرتبطة بالرئيس صالح، فقد قاد الإصلاح منذ انتخابات 2003 النيابية معارضة شرسة، دفعت بعض قياداته في عام 2006 إلى المطالبة بثورة شعبية للقضاء على نظام الرئيس صالح باعتباره السبب الرئيس لتخلف اليمن، هذه المواجهة بدأت بعد أن تبنى نظام صالح سياسة إخراجهم من منظومة الحكم، وشكلت الانتخابات النيابية عام 1997 المدخل الرئيس لإخراجهم من الحكم، ومن ذلك الحين والرئيس صالح يعمل على إعادة بناء تحالفات جديدة لدعم قوة النظام، حيث عمل على تمكين القوى ذات الاتجاهات الليبرالية من منظومة الحكم، وقام بتصفية العناصر التي كان لها تاريخ اخواني من المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم لصالح قيادات سياسية ليبرالية وتقليدية مشهورة بمواقفها العدائية لحركة الإخوان المسلمين، وعمل أيضا على إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية ورفدها بالقيادات الجديدة من أبناء النخبة الحاكمة التي تلقت تعليما حديثا في الجامعات الغربية، وتمتاز بولائها المطلق للرئيس صالح، كما عمل على بناء تحالفات قبلية داعمة للنظام من خارج قبيلة حاشد»، (اليمن صراع السياسة بين الرئيس والاخوان، سابق ذكره).
وإذا كان ذلك قد أدى إلى تمركز قبلي شخصي في السلطة، وكرسها في حزب واحد، فإن الديمقراطية تتحول إلى ديكور، ولا تستطيع أحزاب المعارضة اختراقها، لأن الحزب الحاكم حزب المؤتمر صارت بيديه ثروة البلد يوزعها على أنصاره ومحبيه، فكانت قسمات الليبرالية والديمقراطية والوطنية الجميلة تخفي تحتها السمات القبيحة للقبلية والفساد والمحسوبية.
فلجأت أحزاب المعارضة التي تقاتلت سابقاً إلى العمل المشترك، فكان لقاء الحزب الاشتراكي وحزب الإصلاح طريفاً بعد دعوات الكراهية الطويلة واستئصال الإلحاد والاشتراكية من اليمن المسلم.
لكن هل هذا التوحد للمعارضة تم على أسس فكرية ديمقراطية وطنية؟
لا، بل تم على مناوأة حزب المؤتمر ومناكفاته، وإحراجه ونقده وتعريته بأي شكل، بالباطل وبالحق.
فوجدنا بعض قادة الاشتراكي يؤيدون القاعدة.
ووجدنا بعض أنصار الإصلاح يوسعون الخلاف بين الشمال والجنوب ويريدون عودة الانفصال وقد كانوا مقاتلين أشداء لدوس الجنوب المتمرد المنفصل.
ووجدنا مناصرة للحوثيين المتمردين العسكريين من داخل قوى المعارضة.
لقد كان انزلاق اليمن لصراعات العصور الوسطى نتيجة طبيعية لضعف قوى الحداثة، وعدم نمو عناصرها الديمقراطية الداخلية، وبدا ذلك في الحزب الاشتراكي والمؤتمر الشعبي اللذين أرادا قيادة اليمن إلى الاشتراكية والرأسمالية معاً!
وكان اليمن يواجه ظروفاً صعبة، فقراً وتضخماً في البطالة ونزيفاً سكانياً مستمراً للخارج، ومواقف خاطئة في الحروب الداخلية والخارجية، فتدحرج مشروع النهضة على صخرة القبلية والمناطقية والمصالح الخاصة المتحكمة!
لقد أدى ذلك إلى التفكك المناطقي، وبدء انفصال الجنوب عن الشمال بطريقة سلمية فسادت المظاهرات والاحتجاجات على سوء توزيع الثروة بين الأقاليم وعلى اقتصار الجيش على منطقة واحدة وقبيلة، وعلى سوء الإدارة.
(واجه النظام السياسي الحاكم في اليمن في الآونة الأخيرة عاصفة من الأزمات السياسية، من الواضح أنها مع اعتصام المتقاعدين العسكريين في المحافظات الجنوبية، والمظاهرات التي شملت معظم أنحاء البلاد والمعترضة على غلاء أسعار المواد الغذائية، بدأت تهز عرش السلطة المكين ولم يجد الرئيس صالح في ظل هذه الوضعية الصعبة إلا أن يعلن مبادرة سياسية، كمحاولة للحد من تصاعد وتيرة الاعتراضات الشعبية على سوء أوضاع الحياة الاقتصادية، وعجز الدولة عن القيام بوظائفها نتيجة تفشي الفساد في مؤسساتها، ومن جانب آخر محاصرة القوى السياسية المعارضة المهددة لحكمه، وتجاوز مشروعها السياسي بمبادرة تحمل في مضمونها إصلاحات سياسية جذرية.)، (العربية، أكتوبر 2007).
إن بعض المطالب الشعبية كان صحيحاً ومهما إذا أُخذ في إطار وطني توحيدي وليس من أجل استثمار النزعات القبلية والمناطقية لزعزعة الدولة، ولكن إذا كان جهاز الدولة متصلباً في مركزيته، وشمولياً في قرارته، فإن قوى المعارضة المتخلفة سوف تستفيد من أخطائه وتطرح شعارات مضيئة جميلة بمضمون طائفي متوار، وهذا ما حصل خاصة في أخطر تمرد واجهه اليمنُ الموحد فيما بعد وهو تمرد الحوثيين.
(أما فيما يخص الحكم المحلي في ظل التركيبة الاجتماعية فإن النخب القبلية ستهيمن على الحكم المحلي، وهي قوى اجتماعية في معظمها مؤيدة للرئيس ومرتبطة بالحزب الحاكم، وحتى في حال إفراز الحكم المحلي لنخب سياسية جديدة فلن يكون للإسلاميين نصيب فيها، على الأقل في المستقبل المنظور، فالانتخابات المحلية السابقة أثبتت قدرة الحزب الحاكم على تشكيل تحالفات تتناقض مصالحها مع الفئات الاجتماعية التي تمثل الإسلاميين)، (العربية، المصدر السابق).
لكن النظام وجد ان قطب المعارضة تحول من الجنوب للشمال وتجسد في شريكه السابق حزب الإصلاح، فعمل على زعزعة وجوده وإنتاج مشكلات سياسية جديدة.
ونجد هنا كيف أن المذهبية السنية المحافظة تنتج شكلين متنافسين، أحدهما يجثم في السلطة ويحاول أن يمكيج نفسه ببعض الشعارات الليبرالية لكي يعطي لنفسه التمايز السياسي عن حزب الإصلاح المذهبي المحافظ الذي يقوم بالاستعانة بقوى مضادة لا لشيء سوى هزيمة غريمه حزب المؤتمر!
أخطر ورقة استعملها حزب المؤتمر الشعبي الحاكم كانت ورقة (الزيديين)، فهذه كانت فرقة إمامية معتدلة تقارب أهل السنة في الكثير من الأطروحات الدينية، وقد حركها الحكم لكي تناوئ حركة الإصلاح، فغذى ونمى الصراع الطائفي.
ولكن تفجر ورقة الحوثيين بيّن المدى الرهيب الذي يمكن أن تؤدي إليه الصراعات المذهبية السياسية واستغلالها من قبل أطراف محلية وإقليمية، وكم الخسائر الذي تسببه لبلد شديد الفقر!
وتغذية الصراعات الطائفية المتزايد في اليمن يعاكس ويناقض إخفاء وتحجيم الصراع الاجتماعي، فالقوى السياسية الحاكمة والمعارضة تلجأ، مع فشل سياستها ولعدم سيطرتها على الحراك الاجتماعي المنفلت بسبب هذه المرجعيات القروسطية، إلى استثمار الصراعات المذهبية وتأجيجها لعجزها عن تنمية الصراع الاجتماعي بشكل سلمي حضاري، اتجاهاً لحل مشكلات الناس.
وقد استفاد زعماء الزيدية من هذه الانتهازية الوطنية المتصاعدة، فتحولوا إلى لاعب أساسي في الساحة.
هناك من يربط نشاط الزيدية وتصاعدها بالسياسة الإيرانية ودورها في اختراق الدول الإسلامية والتأثير في سياساتها لكي تغدو اللاعب الأكبر في المنطقة.
وهذا لا ينفصل عن استغلال تنظيم القاعدة من قبل أطراف أخرى لضرب السياسة الأمريكية التي يتعاون معها النظام اليمني في السنوات الأخيرة، وبدا انه يربط مصيره بها.
وعموماً صار النظام اليمني ساحة صراعات وطنية وإقليمية كثيرة، وجدت من تفكك العلاقات السياسية الداخلية، ومن تفكك خريطة البلد الجغرافية، ومن تفاقم مشكلات الفقر والبطالة والكوارث الطبيعية فرصاً لاستثمار النقد الشعبي في مخططاتها السياسية، التي تتراوح بين النضج المسئول والحماقات بل الجرائم العسكرية.
وضاعت الخيارات التحديثية الديمقراطية الوطنية المتوحدة التي كانت باكورتها تعاون حزب المؤتمر والحزب الاشتراكي، والتي لم تعد مطروحة تماماً، وصار خيار الانفصال يتعمق في الجنوب، وتستغله قوى متضررة من الوحدة وحربها، كما يتعمق خيار الانفصال في محافظة صعدة. لكن كل هذه الخيارات غير سليمة، ومضرة، وخطرة على التطور السياسي اليمني، الذي يجب أن يعود إلى الوحدة وحوار القوى الوطنية من أجل انقاذ البلد من مسلسل الانزلاق الكلي للحرب الأهلية الواسعة.
لابد أن يعيد كل طرف الرؤية تجاه ما جرى وأن يبدأ الجميع من النقطة التي تمت مغادرتها وهي صراع قوى اجتماعية سياسية متحضرة وليست صراع قوى دينية وطائفية ومناطقية.
≣ غياب الجدل من تاريخ اليمن
2010/1/22
تشكلت الجمهوريات العربية بطرق غير ديمقراطية وعبر انقلابات عسكرية، وتم تغييب التراكم الديمقراطي البسيط من الحياة العربية عبر قفزات الضباط العسكريين للاستيلاء على السلطات.
وكلما ذهبت الجمهوريات إلى المناطق المذهبية والبدوية والقروية ازدادات تخلفاً، وهي هنا تستعيدُ المواريثَ المحافظة في بناء السلطات، وفي العلاقات الدولية، إما مشاكسةً للغرب وإما تبعية وانحناءً له، وإما هتافات ورقصات واستعراضات بين الجمهور الفرح وإما فتح أبواب الزنزانات لقياداته وجمهوره المساند، فالعلاقات الجدلية بين السلطات الجمهورية ومختلف المفردات الاجتماعية العربية تتلون من خلال القبضة العسكرية.
ولهذا رأينا جمهوريتي اليمن وهما تعانيان أشد المعاناة في سبيل تكوين نظام، أي نظامٍ مستقر! ليس لأن الأنظمة الجمهورية فاسدة بشكلٍ مطلق، ولكن لأن اليمنيين وقبلهم عرب آخرون، استعاروا هياكل جمهورية ليس فيها اسم للجمهور، وهي عبارة عن سيطراتِ أقلياتٍ سياسية وعسكرية، عجزت عن إنشاء علاقات ديمقراطية مع الجمهور الذي تحكمُ باسمه.
حين يتخلى النظامُ الجمهوري الذي يظهر فجأة عن المواريث السياسية والاجتماعية السابقة ويقفز للسلطة، لا يكونُ ميراثاً تراكمياً ويلغي استقراراً ونظاماً استمرا قرونا، وكأنه يبدأ من الصفر.
بلا شك إن الأنظمة السابقة متخلفة وبعضها شديد التخلف كنظام الإمامة في اليمن، وبعضها غير مقبول تماماً كالسيطرة البريطانية في الجنوب، لكن لا يمكن القفز على هذين النظامين وإنتاج نظامين من خلال التأملات الشخصية للثوار والضباط.
لابد من مراعاة النظام السابق والعمل على تطوير منجزاته ورفض سلبياته، أي أن قفزات السياسيين والضباط على كراسي الحكم، تقود للقطع مع الماضي، وليس للجدل الديمقراطي مع الماضي.
مهما كان سوء نظام الإمامة لكن لابد من ترك الشعب هو الذي يختارُ نمطَ الحكم، وأن تتشكل من هذا الجدل مؤسسات، مهما طالت الفترة الانتقالية، بحيث تنبثق التجربة الجديدة من الناس، ومن تعلمهم ومن مستويات مناطقهم ومن الإصلاحات التي سوف تتشكل من وجودهم الشرعي في مؤسسات الحكم الجديد.
لقد عرف السياسيون والضباط بأن ثمة شكلاً سياسياً غربياً اسمه النظام الجمهوري، ولكنهم لم يدرسوه! بل استعاروا شكله الخارجي، وشبحه السياسي، وظنوا بأنهم يؤسسون حكماً جمهورياً!
جاء سياسيو الجبهة القومية التي حكمت جنوب اليمن من جمل سياسية مضطربة وتحررية وفوضوية وأنجزوا الاستقلال المهم في حياة اليمن، ثم صاروا اشتراكيين وأمموا وخلقوا طبقة بيروقراطية عسكرية مسيطرة على وسائل إنتاج فقيرة.
كان التوجه لنظام رأسمالي ديمقراطي وتحريك عجلة الاقتصاد وتوسيع نطاق الثروة الوطنية، وغيرها من المهمات الأولية لنظام وطني أولي هي المطلوبة في ذلك الحين، لكن الجملة الثورية عصفتْ بالموضوعية السياسية، وقادت اليمن لطريق مسدود، ثم ألقتْ بها في أحضان العسكرية الشمالية التي لا ترحم، والتي عنونت نظامها باسم الجمهورية وليس له علاقة بالجمهورية.
إن النمو الطائفي لنظام صنعاء، ترافق مع نمو البيروقراطية العسكرية السياسية الشمالية، فدخلتْ في تمزيق شتى مفردات النظام، فهي مَلكيةٌ فرديةٌ متضخمة، وهي مقتصرة على نشاط النخبة المهيمنة الشمالية، وبهذا فهي قادت مفردات النظام السياسي للتفكك، بدلاً من تطوير أقاليمه ومذاهبه كافة.
لم يكن التوحد اليمني قائماً على أسس موضوعية، فهي وحدة عاطفية ومضت إليها قيادة الجنوب لتتخلص من الفواتير المرتفعة لنظام قصير النظر، توجه لـ (الاشتراكية) وهي رأسمالية دولة عسكرية قبلية، ليس لها علاقة بالاشتراكية، وراحت هذه القيادات تأكل نفسها، بسبب رفض تشكيل دولة رأسمالية ديمقراطية تعددية، ثم كانت الوحدة في تصورها حلاً لكل مشكلاتها التي لم تستطع أن تقرأها وتعيدُ النظر فيها، لأن كل زعيم استغل مشكلات البلد لكي يهيمن على السلطة فدخلوا في حرب تدميرية للبلد وللتجربة.
واستغل نظام الشمال العسكري القبلي هذه العملية ليسيطر على كل شيء. فقامت قيادة الجنوب بخطأ أكبر بإعلان الانفصال!
كان من الممكن أن تتلاقى قوى الليبرالية الوطنية المحدودة الشاحبة في الشمال والجنوب على برنامج إنقاذ والعودة لأسس النظام الحديث، الذي طرحه بعض زعماء الحزب الاشتراكي حين عركتهم التجارب وأدركوا سراب التسميات السياسية الكبيرة في واقع اليمن الفقير اقتصادياً وفكرياً، لكن قيادة الشمال رفضت تشكيل نظام ديمقراطي.
ومن ذلك الحين تفكك اليمن إلى أقاليم وقبائل مسيطرة على المناطق وإرهاب مستورد وانفصال وتدخلات أجنبية خطرة.
≣ أزمة اليمن
2010/8/7
تكونت أزمة اليمن الراهنة من قيام حكومة صنعاء بفرضِ نظامٍ شمولي عسكري على اليمن ككل، متخليةً بهذا عن مواثيق الوحدة اليمنية وعن تشكيل نظام ديمقراطي تعددي ينمو في ظل العلاقات الرأسمالية الحرة.
حدثَ هذا الانقلاب على صعيدي الجنوب والشمال بعد صراعاتٍ كبيرةٍ بينهما وبعد مقاربات للوحدة ومفاوضات ومواجهات دموية.
بالنسبةِ إلى مقاربةِ اليمن الجنوبي للوحدةِ والقبول بها، جاءتْ بسببِ العقليةِ الفكريةِ السياسية السائدة في الحزب الاشتراكي، فقد عاشَ على وعي (الاشتراكية) وإزالةِ الطبقاتِ والبرجوازية الاستغلالية خاصة، وشكلَ دكتاتوريةً سياسية عسكرية، جعلتْ السلطةَ في يدِ المكتب السياسي للحزب الاشتراكي، الذي راح أعضاؤه يتصارعون بشكلٍ مستمرٍ مدمر، مما عبر عن عدم وجود ملكية عامة كبيرة ومؤثرة، وعدم القدرة على تحويل نسيج البلد الاجتماعي البشري للتطور الحديث الديمقراطي، ولعدم وجود علاقات اجتماعية شعبية ديمقراطية مزدهرة.
إن العقلية القومية النخبوية كانت هي جذر تفكير القادة (الاشتراكيين) وهي التي أدت إلى المغامرات السياسية والقفز فوق الظروف الموضوعية، فغدت رؤيتهم للشعب اليمني بأنه شعبٌ موحد، يستطيع أن يشكلَ وحدةً فيما بينه، كأن ثمة عناصر من الدم هي التي تلعبُ الدورَ الحاسمَ في التكوينات الاجتماعية – السياسية.
إن غياب الوعي الديمقراطي الاجتماعي لديهم جعلهم يتعاملون مع شعبهم بطريقة نخبوية إدارية، وأحلوا قراراتهم محل الدرس الموضوعي لقوانين التطور الاجتماعي، وهذا بدأ منذ عمليات الصراع المسلح ضد الاستعمار، وترسختْ عقلية النخبة والمغامرة وقدرتها على تفجيرِ وتغييرِ العلاقات الموضوعية، في عالم الطبقات والبشر، عبر الشعار والحركة السياسية المفصولة عن قوانين الواقع.
لقد أسسوا حسبَ تصورِهم نظاما اشتراكيا، ثم توجهوا للوحدة مع نظام (رأسمالي) كما قيل وقتذاك. أما هم فقد أسسوا نظاما رأسماليا حكوميا عسكريا شموليا لايزال متشربا بالعلاقات القبلية، والحياة الاجتماعية الإقطاعية، وأعطوا كذلك الأغلبية الشعبية العديدَ من المكاسب كتشكيل ملكيات عامة وتحديد الأجور وتخفيض الأسعار والتعاونيات وغيرها.
لم يكن النظام الرأسمالي الحكومي وقتذاك يستندُ إلى ثروةٍ كبيرة، كما أن المساعدات من الاتحاد السوفيتي وألمانيا الديمقراطية كانت هي التي تبقيه حيا، مع معاركه المستمرة وعدم القدرة على تشكيل نظام رأسمالي ديمقراطي، يُصعدُ من مختلف أشكال الإنتاج، ويطور مستوى الحياة الاجتماعية والثقافية المتخلفة للشعب في الجنوب.
كانت المهماتُ الأولى لتشكيلِ نظامٍ رأسمالي ديمقراطي هي المطلوبةُ في بدءِ الاستقلال، وهو أمرٌ لم تفهمهُ هذه النخبُ اليساريةُ الطفولية وصارعتْ القوى التي طرحت ذلك.
وفي لحظةِ التوحيدِ مع الشمال عادتْ فجأة وبلا مقدمات إلى طرح النموذج الرأسمالي الديمقراطي وتجاوز تجربة (الاشتراكية)، وبشكل هو ذاته قفزة يسارية أخرى، ونخبوية مماثلة لطريقة عملها، بدلاً من أن تجعل ذلك فترة انتقالية مطولة ريثما تتركز هذه السمات التطورية في الجنوب وترى تطبيقها ونموها في الشمال كذلك.
هكذا قامتْ بالدخول في نظامٍ رأسمالي ديمقراطي موهوم عبر وحدة مع نظام إقطاعي عسكري.
أي أن تلك العملية التطورية التدريجية لم تكن قادرة عليها، وهي كانت سوف تسببُ تصدعاتٍ داخلية كبيرة، لهشاشة المبنى السياسي القائد، وكثرة المغامرين الذين سوف ينتهزون فرصة هذا التحول للوراء و(ضرب التجربة الاشتراكية) نظراً لعقلياتِهم المتخلفةِ في فهمِ الاشتراكية والديمقراطية، كما أن الظروف الاقتصادية كانت صعبة، ولهذا وجدت قيادة الحزب الاشتراكي اليمني في عملية الوحدة قفزة الهروب الكبير للإمام، وتحويل الأزمة إلى انتصار موهوم، وطمعت في البقاء على قمة السلطة وتقاسمها مع قوى الإقطاع العسكري وقوى الإقطاع الديني في الشمال.
وحين تحققت تلك التجربة – الكارثة تقاسمت النخبة الاشتراكية الحصصَ والكراسي مع قوة الدولة الحاكمة الحقيقية في الشمال التي أعطتها وهمَ الحكم، حيث أمسكت بالجيش والداخلية وتركتْ لها المناصبَ الشرفية، ثم أجرت لها عمليات الاغتيال الواسعة في ظرف زمني بسيط كانت استئصالاً مبرمجاً.
فالطبقة الحاكمة الإقطاعية سواءً العسكر الحاكم أم شيوخ القبائل وشيوخ الدين لا يمكن أن تتوافق مع تجربة نضالية شعبية مهما كان مستواها خاصة انها اتسمت بتاريخ من المغامرة والفوضوية والحدة، فجعلتْ من الوحدة مصيدة قاتلة.
كان تاريخ التحرر عبر الجبهة القومية يحملُ تلك الجراثيم ورفضَ هذا التاريخُ طريقةَ جبهة التحرير اليمنية الجنوبية عبر الليبرالية ونشر الديمقراطية بشكلٍ متدرجٍ واختارَ حكمَ الجملة الثورية المنتفخة فكان في الوحدة يحصدُ ثمارَ تلك التراكمات السلبية، وضاعتْ كلُ دروس الفكر التقدمي من توصيفِ الطبقات وعلاقات الإنتاج وقراءة وعي الجمهور
كانت فرصة لقوى الإقطاعِ المختلفة في اليمن الشمالي أن تحضنَ إلى درجةِ الصهرِ والإذابةِ الحزبَ الاشتراكي اليمني الذي افتقد رؤيتَهُ الطبقيةَ الشعبية، نظراً للفساد والتعالي على النضال مع الجمهور العامل.
وكانت قوى الإقطاع في الشمال تتصارعُ هي نفسُها، فشيوخُ القبائل وهم المادةُ الأرضيةُ المؤسسة للإقطاعِ العشائري المقسم لليمن إلى قطائع، وأسر ذكورية متخلفة، ونصوصية دينية صفراء، وفقر تاريخي، قد أنتجتْ العسكرَ الحاكمَ والدينيين المحافظين، فهم كلهم يمثلون عجزاً عن إثراء الواقع وعن تغييرِ حياةِ الناس، بل هي طفيلياتٌ تمتصُ رحيقه بأساليب عتيقة انتهى زمانُها وشاختْ أعمارُها، وتمكن العسكرُ بسببِ آلياتهِ الحربية من الصعود لمفاتيح السلطة والقبض عليها بشدة، وانهارت أحلامُ السلال والحمدي بتفتحٍ ونمو نهضوي ديمقراطي وطني، وجاء عسكرُ الهيمنة المطلقة، والعصبة الصغيرة والتوريث السياسي، وكلها تعفنتْ في الشكلِ المُستعاد لمَلكيةٍ أكثر قهراً للشعب من جمهورية مُصابة بفقر الدم الديمقراطي.
الثورتان في الشمال والجنوب رفضتا الثورةَ الحقيقية، أي تشكيل نظامٍ ديمقراطي علماني ليبرالي متدرج ينشرُ الحريات والتوحيدَ والوظائفَ قافزتين إلى سلطةٍ فردية مطلقةٍ لم تَتحققْ في الجنوب نظراً لعنادهِ الثوري المتأصل ولوجودِ حرياتٍ وليبرالية ومنظمات شعبية قوية، لكن راحَ الشمالُ القبلي المتخلفُ الفقير يحققها بمناوراتِ السلطةِ ذات الجيش الواسع الأمي، حتى وصلتْ إلى سلطةٍ مطلقةٍ فوق حُطامٍ وخرائب وثورانٍ شعبي في كل مكان!
زالتْ دولةٌ من الخريطة العربية، وتحطم الحزبُ الاشتراكي بالاغتيالات وقرار الانفصال المتشنج الذي هو تراكم لذات العقلية الانفعالية المغامرة، وبالحرب الشمالية التي كانت غزواً واستيلاءً على الأملاك العامة والغنائم.
هذا كله جعلَ الصراعات تنتقلُ للشمال كلية، وراح الفرقاءُ المتحدون لتذويب الجنوب يختلفون، وكل منهم يريدُ السلطةَ لنفسه.
في البدء وجدَ حزبُ الإصلاح المذهبي المحافظ ذو الشعبية الفضفاضة المكونة من القبائل والمثقفين الدينيين، ان الأرض قد خلت له، والكرسي في شوقٍ شديدٍ إليه، فجمعَ السحرَ واللغو السياسي، والجموع المسلحة، واندفع للسيطرة على الحكم الذي كان أشبه بالسراب إليه.
الإصلاح الذي استخدم شعارات الاخوان المسلمين وظهر نفسه المدافع الأوحد عن أهل السنة بخطاباتٍ مطلقة، حرك المشاعرَ الطائفيةَ النائمة، وأيقظَ النعرات الطائفية الأخرى غيرَ المسيسة والمؤدِلجةِ للصراع السياسي العنيف.
القوة الحاكمة الحقيقية وهي الضباط الكبار تبلورت قوتهم في الرئيس، الذي بدأ يقلد الرؤساءَ العربَ في الانقلابِ على الجمهورية وتحويلها لملكيةٍ، ولكن في وضعٍ رهيبٍ يخلو من أي أشكالِ الصلابة السياسية والاجتماعية لزملائه الآخرين الباقين، وفي بلدٍ مثل الجسد المقطع الذي ينزفُ من كلِ خليةٍ فيه دماً وجوعاً وفقراً وهجرةً وضياعاً.
الرئيسُ يؤسسُ مشروعَهُ التوريثي، ويكونُ فئةً مسيطرةً مهيمنةً على الاقتصاد والحياة الاجتماعية والسياسية، ويركزُها في الشمال فكان هدفها من الوحدة هو:
(السيطرة القبلية على نظام الدولة والإخلال بالأمن وتركين القانون واحتلال الجنوب وإلحاقه بالشمال والاستيلاء على ثروته النفطية والمعدنية والسمكية والزراعية والثروات الأخرى والقضاء النهائي على الحزب الاشتراكي اليمني وإنهاء نفوذه السياسي والعسكري وتحطيم مؤسساته بما فيها المؤسسات العسكرية وإنهاء القوى الوطنية والشخصية الجنوبية وسلب مواطنيه الحق المتساوي في المواطنة وتحقيق السيطرة والنفوذ للقيادة الشمالية على الجنوب، (د.عبدالله أحمد الحالمي: دراسة الأزمة) .
يقول أحد المواطنين الشماليين المعارض للحراك الجنوبي مقترحاً: إعادة الاراضي التي صُرفت للاخوان والأقرباء والمشايخ والسُراق ومحاسبة من أخذها ومن صرفها ومن استولى على أراضي عدن بالقوة (ومنهم قائمة الخمسة عشر في تقرير هلال باصرة) ومن لم ينفذ أوامر القضاء بإعادة الأراضي المنهوبة.
اضمنْ لي فقط تنفيذ هذه النقطة أضمنُ لكَ انتهاءَ الحراك الملعون الى الأبد.
إن عقليةَ الهيمنة على الثروةِ العامة من قبلِ الفئةِ العسكرية البيروقراطية التي تغلغلتْ داخلَ شيوخ القبائل وشيوخ الدين، وضعتْ حداً لشبه التماسك الوطني بعد الانتصار الدموي على الجنوب، فبدأ التمزقُ الشامل.
كان حراكُ الحوثيين مغايراً للحراكِ الشعبي الجنوبي من خلالِ جوانب عديدة.
فالصراعاتُ الشماليةُ اليمنية هي صراعاتٌ مريضة، هي تفسخاتٌ سياسيةٌ واجتماعية، هي مناوراتٌ ومؤامراتٌ في جسدٍ اجتماعي يتحللُ وبلا جذورٍ حضاريةٍ صاعدة مستقبلية.
إنهُ الإقطاعُ الديني السياسي القبلي يتحللُ دماً ويتناثرُ أشلاءً.
فليس صحيحاً القول إن الحوثيين شكلوا تطوراً من فكرةٍ دينيةٍ إلى فكرةٍ دينية أخرى متقدمة، وان الزيدية في فرقتِها المسماة(الجارودية) التي لا تؤمنُ بغيرِ إمامةِ سلالةِ الحسن والحسين، قد بدأوا يثرون أفكارَهم، فالفرقُ المعاصرةُ غيرُ قادرةٍ على التطورِ الديني العميق، غيرُ قادرةٍ على التأصيلِ الديني والدرس، فما هي سوى جماعات سياسية اجتماعية شعارية، توظفُ بعضَ الكلماتِ والشعاراتِ بسببِ نشوء أوضاعٍ سياسية جديدة تتيحُ التوظيفَ لها.
وهذا يعودُ عموماً إلى طموحِ زعماء فرديين جددٍ تم استغلالهم سياسياً وظهرت لهم مصلحة في أدلجة المذهب المعني، فحين كانت الزيديةُ بشيوخِ دينِها القدامى المعتقين عاشتْ مع فصائل الشعب اليمني الأخرى بسلاسة وتعاون ورفضت إدخال المقولات المذهبية المُسيسة تلك في حومة الحياة الاجتماعية الصراعية، وهذا ديدنُ المشايخِ الكبار وآياتِ الله العظمى، الذين يتخوفون من المغامرات السياسية وأخطارها على الدينِ والعباد.
لكن الحكومة الشمولية في صنعاء التي بعثرتْ النسيجَ الوطني الاجتماعي راحتْ تتلاعبُ بمكونات الشعب وخريطته السياسية الاجتماعية، فبعد أن قضتْ على تجربةِ الجنوب وامتدادها الديمقراطي المُفترض في الشمال، توجهتْ للقضاءِ على حزبِ الإصلاح الديني، الخصم الذي برزَ كبيراً بعد تحجيم الحزب الاشتراكي، واليمن تتقمصُ ظاهرات الصراع الشرقي بين الرأسمالية الحكومية والرأسمالية الخاصة، بشكلٍ كاريكاتيري دموي، فلم تقدرْ على تصعيدِ العناصرِ الديمقراطيةِ في الجنوب ولا قامتْ بزرعِها في الشمال وداخل حزب الإصلاح وفي الحياة الاجتماعية المتخلفة عامةً، بل عملتْ على ضرب تلك العناصر السلمية والمعتدلة وبذور الديمقراطية من خلالِ تصعيدِ وتغييرِ المنحى السلمي للزيديةِ المعروفة بتوجهاتِها المعتدلة السلمية، وتفجير الصراع بينها وبين السنة.
هنا ظهر الانقلابُ المفاجئ للجارودية الزيدية، التي حوتْ البذرةَ المناسبةَ للتآمرِ الحكومي، الدراماتيكي المفتعل، فالمدارسُ التعليميةُ الدينية العادية لها انقلبتْ إلى حزب، وبعد مدةٍ وجيزةٍ أعلت من شعاراتٍ حادة غريبة لم يسبقْ طرحها في اليمن، خاصة الهجوم على السنة في اليمن وما حولها من بلدان، وتصعيد الصراع مع حزب الإصلاح، ونزع تلك العناصر المختلفة في الانفصال المذهبي عن عموم المذهب الزيدي نفسه وتحويلها لعناصر كليةٍ مطلقة.
كان يترافقُ مع هذا تمركزٌ شديدٌ في السلطة وفرديةٌ قويةٌ فيها وبدء طرح مسألة التوريث، وظهرَ الصراعُ في العائلة الحاكمة، وهكذا فإن لعبةَ استخدام المذهبيين السياسيين في الصراع السياسي الوطني تواصلت واتسعت داخل الشمال نفسه.
إن تفككَ أجهزة السلطةِ هنا ترافقَ مع تفككِ أجهزتِها الايديولوجية، فهي لم تعدْ سنيةً محافظة، وهي كالحوثيين والإصلاح، الفاقدين للرؤية الديمقراطية العلمانية الإسلامية، بل غدتْ رؤيةُ السلطةِ برجماتيةً انتهازيةً ضيقة الأفق، تحاول فقط التشبثَ بالحكم وديمومته.
وبهذا فإن القوى المذهبية السياسية السنية لم يكن لديها قدرة على فهم الإسلام وتغيير السلطة أو الصراع معها بشكل قوي، وهي التي تعيشُ بينها وفي مدنِها وأريافِها، في حين توفر ذلك للحوثيين الذين أعطتهم تضاريسُ منطقتِهم الجغرافيةِ الوعرة وأعدادُ السكانِ وظروفُ الفقرِ وغيابُ الخدماتِ، الظروفَ المناسبةَ لتحويل (النزق) التسييسي المذهبي إلى ايديولوجيةٍ (متكاملة) زائفةٍ وتمرد مسلح.
السلطةُ التي استخدمتهم انقلبوا عليها، بعد أن شكلوا جنينَ سلطةٍ في الشمال، فهي التي دفعتهم للنمو والاستقلال، فصاروا شوكةً في خصرِها، وهي شوكةٌ داميةٌ صعبة النزع.
وبهذا فإن الحكومةَ قامتْ بحرقِ أرضِها السياسيةِ داخل الشمال، فأغرقتْ اليمن في أزمةٍ شاملة، وجرتْ المنطقةَ لأتونِ هذه الأزمة، فالحراكُ الحوثي غدا مستقلاً عبرَ آلتهِ العسكرية، ويمكن استخدامه لمن له أغراض أخرى، أي دخلَ الصراعُ اليمني الوطني في خريطةِ الصراعات الإقليمية والعالمية، وتم استثماره، نظراً لأن الدولةَ والأحزابَ اليمنية لم تقمْ بتصعيد البذور الديمقراطية ورعايتها بعدمِ توظيفِ المذاهبِ في الصراعِ السياسي، وبتعميقِ الوحدةِ الشعبية الإصلاحية، وباستقلالِ الأجهزةِ الحكومية عن الصراع الأهلي وبعدم شخصنة الحكم.
كان الحراكُ الجنوبي في اليمن يمثلُ طابعَ تاريخهِ النضالي، وتقاليد الناس المتحضرة في المعارضة، وعلى رغمِ قسوةِ السلطةِ وتعنتها ظلَّ العمالُ والبسطاء والجنود في جنوب اليمن يتبعون أساليب حضارية في رفضهم لغلواء الحكم وعدم إهتمامه بالناس وتوجه جماعتهِ للاستيلاء على الثروات والأملاك، وهي معارضةٌ إقتصرتْ بشكلٍ أساسي على المظاهرات السلمية.
الفرقُ واضحٌ بشكلٍ كبير بين معارضةٍ شمالية تمزيقية للوطن، ومعارضة بناءة جنوبية توحيدية، تدعمُ تشكلَ يمنٍ مختلف بعيد عن مركزية السلطة وشخصنتها.
كان جنوبُ اليمن ينعمُ رغمَ كل شيء بظروفٍ معيشية مستقرة، وبهذا إصطدمتْ رأسماليةٌ حكوميةٌ جنوبيةٌ متشددةٌ ومحدودةٌ النظرِ في البناءِ الاقتصادي وضابطة للأسعار وحدود الأملاك وأوضاع العاملين بالأجور وفي التعاونيات، بإقطاعٍ سياسي شمالي لديه بعضُ الحرياتِ الاقتصادية، وفوضوي في حراكهِ السياسي وبرغبتهِ التسريعية الحادة في إلتهامِ الثروات العامة خاصةً الجنوبيةَ منها، مما أدى إلى إصطدامِ تكوينين إجتماعيين مختلفين، فتفجرتْ الأوضاعُ خاصةً بعد غيابِ الضابط (الإشتراكي) الذي يخففُ من وقع الصدام بين البنيتين المتضادتين.
وقد صبر الجنوبيون طويلاً على هذه التعديات على الأملاك العامة، وأوضاعهم المعيشية، ومركزية الخدمات والمنافع لعاصمة الشمال، ثم إنفجرتْ الأوضاعُ بسببِ الأزمةِ العامة الاقتصادية التي تحولت إلى أزمة سياسية عامة، فلم يعدْ الشعب في الشمال والجنوب بقادرٍ على إستمرار العيش بهذه الظروف والأجور، لكن الشمال لم تكن لديه قوى ديمقراطية متجذرة، في حين كان الجنوبُ لديه تاريخٌ من النضالِ المطلبي ومن قوى النقابات التي هزتْ الاستعمارَ البريطاني.
بدأ الحراكُ الجنوبي بمطلبِ إعادة عسكريين جنوبيين مفصولين، بسببِ التمييز في الجيش بين شماليين وجنوبيين، وبعد تحقق هذا الهدف تنامتْ المطالباتُ في كلِ إتجاه.
حتى وحدة الجيش الصلبة تطرقَ لها الفسادُ، ولكن الجيشَ بقي كأداةٍ في يدِ القوى الشمولية الحاكمة، بسببِ التجنيد الواسع للأميين ووضع الميزانية في خدمته وصارَ الجيشُ أداةً للقمع ولتآمر الحزب الحاكم، وإختفى الجيشُ العقائدي الجنوبي المرتبط بتقاليد الجمهور اليمني النضالية.
لقد بانَ ضعفُ السلطةِ واضحاً في عدمِ قدرتِها على خلقِ طبقةٍ حاكمة موَّحدة ذات برنامج مستقبلي واعدٍ بأهدافٍ معقولة لعموم الشعب، بل هي نفسُها تصارعتْ وفتتْ صفوفَها، وحلتْ الفرديةُ المطلقةُ والإنتفاخُ السياسي وعبادة الفرد فيها، كما أنها لم تخلقْ قواعدَ في الفئاتِ المتوسطة تساندُها، التي تحولتْ هي الأخرى إلى فسيفساءٍ من الأحزابِ الصغيرة، وغابتْ المعارضةُ الحكيمةُ التوحيدية.
هكذا تحولتْ الصراعاتُ السياسيةُ في الطبقةِ السياسية العليا إلى أزمةٍ شاملة، أزمةٌ أدخلتْ كافةَ الطبقات والسكان في صراعات محمومة فوضوية.
وقد بانَ التباينُ الاجتماعي العامُ بين الشمال المميز وبين الجنوب المهمل، وتباين الشمال نفسه بين سنة وزيدية، بين عاصمة مسيطرة وأرياف مُستبعَّدة، بين جيش وعامة.
وإستمر مسلسل السلطة في الهروب للإمام، بدلاً من إعادةِ النظر في كل هذا التاريخ الانقلابي العائد للوراء، فإستغلتْ شبحَ القاعدة، وربما فتحتْ البابَ ليكبر ويتم توظيفه، فغدتْ الأزمةُ عالمية، وتم دغدغة مشاعر القوى الغربية المرهفة للمساعدة وتخويف دول الجوار وليتم وضع اليمن بين الدول المُعَّرضة للإرهاب والمحتاجة للمساعدات.
يتوجه قسم من الجنوبيين للانفصال وهدم دولة الوحدة بنفس الأسس التي قبلوا بها بالوحدة، أي بالتشنج العاطفي، وردود الأفعال الحادة، وعدم الاعتماد على تنمية العناصر الديمقراطية وتطويرها في كل اليمن، وأن ليس لهم سوى الصبر السياسي والإنتاج التراكمي النضالي الديمقراطي الطويل لهذه العناصر، وهي المهمةُ التي رفضوها في كلِ لحظاتِ تطورهم السياسي، حين إشتغلوا على القفزات وحرق المراحل. إن تغييرَ طابع الدولة المركزية وتشكيل حكومة ديمقراطية هو الهدف الحقيقي للمرحلة الذي ينبغي أن تلتف حوله كل القوى العقلانية، وبالحفاظ على المؤسسات الوطنية المختلفة، فليس الانفصال سوى مجموعة جديدة من الحروب والإقاليم المتصارعة أي جعل اليمن صومالاً آخر.
≣ اليمن من القبليةِ إلى الديمقراطية
2011/6/9
استمر الصراع الاجتماعي السياسي طويلاً خلال العقود الأخيرة في اليمن، كان اشتراكيا – قبليا في الجنوب، ورأسماليا – قبليا في الشمال فتوحد بشكلٍ دكتاتوري شامل.
فلا الاشتراكيون في الجنوب صعّدوا عناصرَ ديمقراطية وثقافة تنويرية، ولا حافظوا على تجربةِ رأسماليةِ الدولةِ الشمولية التي تخصهم.
والشمالُ لم يطورْ التجربةَ الرأسماليةَ لتكونَ مجتمعاً ديمقراطيا، فالرأسمالية كانت على ضفافِ القبائل، ولم تستطعْ اختراقَ النسيج القبلي المحافظ وتبديله وتحويله إلى اصطفافٍ اجتماعي بين تاجر وعامل، بين قوى العمل وقوى رأس المال، بين قوى الثقافة وقوى الإنتاج، بين قوى الدولة وقوى القبيلة، حيث قامت الزراعة والحرف بتقديم أغلب النتاج وأقعدتا اليمنَ في العصر الوسيط، وظلت القبائل هي النسيجُ الاجتماعي الأكبر التي تفرزُ مكوناتها في كل حين وفي كل انقلاب وفي كل ثقافة، وتحددت في قبائل قليلة مركزية مهيمنة على الوطن الموحد.
كان الحراكُ الجنوبي قد عادَ إلى وطنيتهِ الضيقة وإقليميته وكان هذا دليلاً على عدمِ نضجهِ السياسي، وعلى تقلباتهِ الفوضويةِ المغامرة، وهو الذي قاربَ الحداثةَ في ضفافِها البحرية الانفتاحية أكثر من الداخل الجبلي، فكان حراكه السياسي الانفصالي الذي زعزعَ البلدَ قد ولّد أزمةً ثورية، من دون أن ينجحَ في الانفصال، لكنه أطلق مخاضَ البحث عن هوية جديدة، وحشد القوى ضد عاصمة الطغيان، فدفع اليمنَ للتحول الجديد.
اللاعبُ الأساسي هو الشباب الذي وقفَ قليلاً خارجَ القبيلة ولم يتشربْ بعد كل جوانبِ لوثتِها المحافظة، ورأى أن يهربَ منها قبل أن تدفنهُ في رمالها المتحركة.
قَلدَ الثورتين التونسية والمصرية فجلبَ نموذجَ الثورة التوحيدية الديمقراطية الإسلامية- العلمانية المتجاوزة للقبائل والمذاهب.
الشباب الذي كان سيدفنُ شبابَهُ المأسوف عليه بين قبور التراث وجلسات القات والصراعات السياسية المجدبةِ لجماعاتِ البرجوازية الصغيرة الفارغةِ من كل وعي حقيقي بصراعِ الطبقات، حسمَ الخيارَ التاريخي بأن نقل اليمنَ للحداثة، لمؤسساتٍ منتخبة شعبياً، تضع دستوراً ديمقراطياً وتحيلُ اليمنَ عن سكة الربع الخالي نحو أوروبا والحداثة ذات الأنوار!
وبيّن هذا الشباب الشعبي أن أقدامَ بلقيس النورانية في سفرِها للشمال لها سلالة باقية، صحيحٌ انها طلعتْ من الكهوف وجنائن التحديث الأولى، إلا أن الفعل القومي العربي الجمهوري الخلاق له في أرض اليمن آباء وأمهات كثيرون.
وقد عصف الشبابُ بكل جلساتِ القات التي يعقدُها المؤتمرُ اللاشعبي، ويقررُ فيها سرقة أموال الشعب وأراضيه ونفطه المحدود وزراعته. حين ظهر النفطُ تمركزت السلطة في عائلة صغيرة وأرادت أن تكون الكل.
فالشعبُ لم يبقْ عليه إلا الإبداع والخرق والشبابُ مفتوحةٌ أمامه على مصاريعِها أبوابُ البطالة والتشرد والحروب الأهلية.
كانت الشراراتُ العربيةُ تنزلُ فوق حطب سياسي يمني يابس.
لقد نجح الرئيسُ علي صالح في نسف كل شيء إيجابي في اليمن.
هو تتويجٌ سلبي للعسكر الإيجابيين السابقين الواعدين المتواضعين المتفتحين، عبّرَ عن انهيارِ العسكرية الشعبية، وتصاعد العسكرية القبلية المغرورة المتجبرة، فجعل الدبابةَ أداتَهُ الأساسية في الحوار/الدمار، ومركزَ السلطة قبيلةً ومدينةً وأسرةً، ولم تظهر قوةٌ بديلة حقيقية، لأن أحزاب الفئات الصغيرة المتسلقة والانتهازية هي مدرسةٌ للمماحكات وجر الكراسي والفوائد للجيوب والمناطق والقبائل، فكان الشبابُ هم الفيض الوطني التوحيدي الذي عبر عن ألم اليمن عبر القرون لكي تصيرَ دولةً حديثة، ولكي تظهر مؤسسات ديمقراطية، وتدخل اليمن العصرَ العربي الديمقراطي.
هم فيضٌ وليس مؤسسات ولا أحزابا، وينبغي أن يظل حتى تتحقق الديمقراطية فعلا.
≣ اليمن: أصراعٌ قبلي أم تحديثي؟
2011/12/11
فيما تقوم القوى الشبابيةُ والمعارضةُ بمحاولةِ تشكيل يمنٍ ديمقراطي، تقوم قوى السلطة السابقة وعائلة الأحمر بالصراع على نفوذ القمة المتزعزعة.
القوى الشبابية والمعارضة تمثلُ درجاتٍ من الصفوف المتداخلة المتباينة في عملها لتجاوز اليمن السابق، المتجسد في نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
القوى الشبابية غيرُ الناتجة عن صراع المصالح والقوى القديمة، مثل شباب الثورة في مصر وتونس الذين خسروا الصفوف الأولى لصالح القوى المعارضة المغروسة في الحياة الاجتماعية السياسية لعقود سابقة، وهي ذات الخبرة والتغلغل في الخرائط الاجتماعية ولها شبكاتٌ قديمة في الاستحواذ على أصوات الناس من خلال المنابر الدينية والأحزاب.
وهذا التباينُ بين الشباب وقوى المعارضة يجسد الفروق بين الشعارات والعفوية السياسية وأحلام الديمقراطية المجردة، وبين التنظيماتِ البرجماتية (العملية) ذات المساومات والوصول إلى الكراسي وتنفيذ تغييرات محددة حسب طبائعها السياسية الاجتماعية، وخططها للهيمنة والتغيير المحدود.
جيلان مختلفان، وعقليتان متباينتان: أناسٌ ظهروا من البراءة السياسية، وأناسٌ نقعوا في الدهاليز الحكومية والمناورات السياسية، أناسٌ يعبرون عن قوسٍ اجتماعي واسعٍ من الفئات والطبقات المتداخلة، وأناس حزبيون يمثلون قوى اجتماعية شبه متحجرة.
لقد قامت إدارةُ الرئيس السابق ببناء اليمن في السنوات الأخيرة بشكل اقتصادي أفضل من عقود التخلف السابقة، وقد مرت اليمن بظروف رهيبة عبر تأييد الرئيس للغزو العراقي للكويت وآثاره الوبيلة على وضع اليمن الاقتصادي، لكن الرئيس تمكن من إعاشة أكثر من مليونين من اليمنيين الذين طُردوا من دول الخليج في ذلك الوقت، ووجه فوائض النفط لإعادة بناء البلد، لكن من خلال سيطرة حزبه وعسكره ثم من خلال سيطرة أسرته.
لم يقبل الاشتراكيون في اليمن (الجنوبي) نتائج تحولات الوحدة وسيرورتهم خارج السلطة، ولم يشتغلوا على التوحيد الديمقراطي ونشر ثقافة الديمقراطية والتعددية والتنوير، فكانت الحرب وكان الرئيس المنتصر، وكانت دكتاتوريته وآثارها السلبية.
فظهرَ جيلٌ جديد يتجاوز هذه المعسكرات الضيقة ويركز في إزاحة الرئيس وتكوين يمن ديمقراطي ذي مؤسسات فوق الرئاسة والقبيلة والأحزاب.
أرادوا ديمقراطية أوروبية من دون ركائزها من طبقة وسطى وعمال أحرار وثقافة ديمقراطية ذات شعبية، وحركوا الشعب طويلاً وبتضحيات جسام مريرة، حتى تحقق لهم هزَّ السلطةِ وتغيير بعض أحجارها الصلدة، وكانت الثغراتُ فيها لا تتسع لأحجامهم الكبيرة الجماهيرية والنقية، فتسللتْ من خلالها الجماعاتُ ذاتُ الملمس الناعم الدهني، وراحوا يستريحون على الكراسي في عملية إعادة ترتيب للطبقة القديمة-الجديدة، بعد أن وصلت الأوضاع في البلد إلى حد الانهيار.
يقول لي كاتبٌ يمني إن المظاهرات التي ترونها في بعض الفضائيات مقطعة مؤدلجة حسب أهداف هذه الفضائيات فلا توجد مثل هذه المظاهرات الهائلة وبهذه الأحجام، وأن الصراع الحقيقي هو بين عائلة الرئيس وعائلة الأحمر على السلطة، وحين ستأتي عائلة الأحمر لن تكون أفضل من عائلة الرئيس السابق!
فهل يلتقي حراكُ الشباب والسياسات الديمقراطية معاً لتجاوز مثل هذا الصراع العائلي المحافظ المتخلف لبناء دولة مؤسسات قوية؟
إن تجاوز الصراع القبلي في القمة هذا لن يكون سهلاً، لكون القوى الجديدة مليئة بالقديم والمحافظ والمتخلف، فسيحتاج الأمر إلى تطور عمل الشباب والقوى الديمقراطية خلال سنوات عديدة قادمة ..
https://www.dhal3.com/vb/showthread.php?t=41500


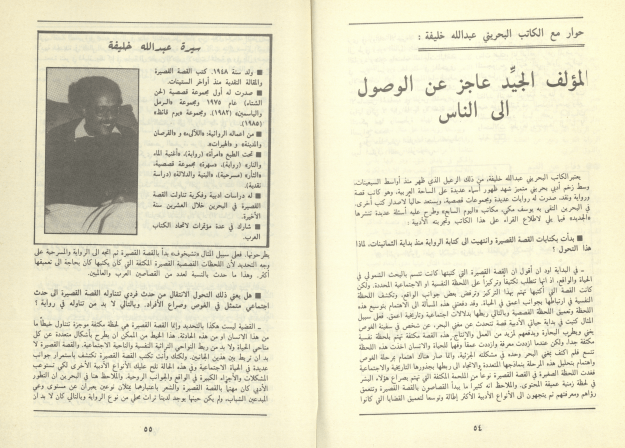





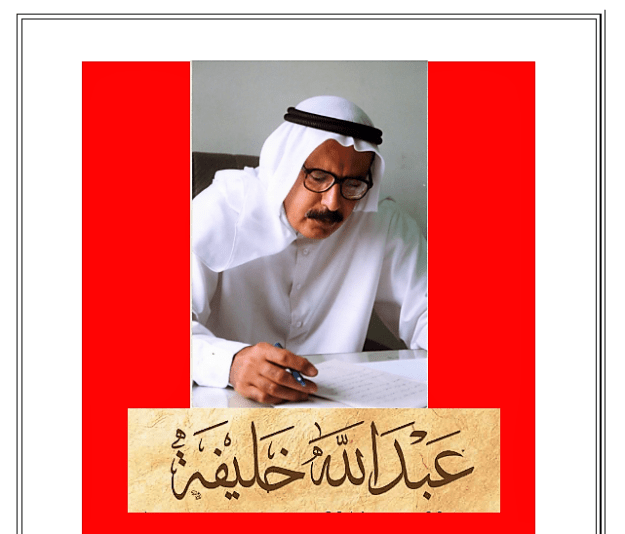




عبـــــــدالله خلــــــــيفة: المغامرات اللغوية أبعدت القارئ عن الرواية

علي الشرقاوي : قصائد الربيع ــ الموجه للأطفال

الموت في فينيسيا : توماس مان كتب : عبدالله خليفة

مسارات ـ حمدة خميس كتب : عبدالله خليفة

ويطول اليوم أكثر من قرن :جنكيز ايتماتوف ـ كتب : عبدالله خليفة


«الهولة» بين الإنجازات وعذابات التجنيس: كتب ـ عبدالله خليفة


مثقفو الأكاذيب والتزوير : بقلم ـ عبدالله خليفة


الطليعيون والتحول إلى الطائفية: كتب ـ عبدالله خليفة

العلمانيون وتوحيد المسلمين: كتب ـ عبدالله خليفة


جابر عصفور: الإصلاح وإشكالياته
جابر عصفور من الباحثين الدؤوبين في تاصيل الحداثة العربية والبحث عن أسباب انتكاساتها في العصر الحديث، وهو يبحث التنوير والإصلاح من خلال شخوص مركزية كالأفغاني ومحمد عبده وفرح أنطون وشبلي شميل وطه حسين، وهو يستعمل تعبيرات مثل المشايخ المجددين لتعريف الأفغاني وأمثاله من علماء الإسلام الذين حاولوا ربطه بالمدنية والحداثة، كما يستعمل مصطلح الأفندية المتنورين لتعريف أمثال فرح أنطون وطه حسين.
يقول:
(وكان على الشيخ المجدد أن يتحمل الاتهام بالابتداع والعمالة، وأن ينهال عليه من الاتهام ما يذكره بالاتهامات التي وجهها أبن قتيبة النقلى، داعية التقليد، في القرن الثالث الهجري، إلى معاصريه وأعدائه «المعتزلة».. ولكن مع فارق مهم أن داعية الابتداع (الذي جاء بعد ما يربو على تسعة قرون) كان يمضى مع الموجة الصاعدة للنهضة والترقي. وكان تضاده مع (الشيخ التقليدي) الآفل هو الوجه الآخر لتآلفه (أو تحالفه) مع نموذج الأفندي التنويري، من حيث الأهداف العامة التي جمعتهما حول أحلام النهضة: الحرية والعدل والتقدم.)، هوامش على دفتر التنوير، ص ١٧٧.
إن السياقات التي يضع فيها الباحث نماذج المشايخ والأفندية رغم فرديتها تشير إلى الشرائح أو الفئات، المنبثقة من الفئات الوسطى. فهنا اتجاهان ينبثقان من هذه الفئات: الاتجاه الديني والاتجاه اللاديني أو العلماني.
والاتجاه الدينى يقوم بتطوير مصطلحاته الدينية وشحنها بالتحديث المعاصر، باحثاً عن توجه فكري قديم يتأصل من خلاله، فيرى الاعتزال أقرب إلى محاولاته للجمع بين الدين والحداثة، حيث عُرف المعتزلة بجعل العقل معياراً لفهم الفص الديني والحياة.
أما الاتجاه التحديثي العلماني بأسمائه السابقة الذكر وغيرها، فهو يغرف من معين واضح ومبهر في العصر، وهو الغرب نفسه، ولكن لا يرى تضاداً مطلقاً حينئذٍ مع الاتجاه الإصلاحي الديني، رغم السجالات الكبيرة والهامه بين الجانبين، والتي اتسمت بالاحترام المتبادل.
وإذا قمنا بوضع الفئتين في سياقهما الاجتماعي، فكذلك لابد من وضعهما في سياقهما السياسي. فهذه الشرائح المنبثقة من الأعمال الحرة أو من بدايات التوظف في المؤسسات الحكومية، تعيش العصر الانتقالي بين تفكك الدولة العثمانية ونشوء الأنظمة التابعة والمستعمرة.
إن الطابع الفردي الحر لرجل مثل فرح أنطون يشكل مؤسسة صحفية خاصة، أو كالشيخ محمد عبده الرجل المستقل والثائروالذي يعود من منفاه لكي يعمل كمفتى، إن هذا الطابع الفردي غير المرتبط بمؤسسات سياسية واجتماعية مهيمنة إلى حد ما، يجعل لمناخ الفئات الوسطي المتفتحة في ذلك الزمن الانتقالي رموزاً استقلالية مناضلة واسعة الأفق.
فالماضي والراهن الإقطاعي للدولة العثمانية المتفسخة، والحداثة التي تلوح في الغرب كشمس مضيئة للسفينة العربية الإسلامية الغارقة في الظلمات، لا يتضادان بصورة حادة، وثمة آمال هنا بأن الدول العربية الإسلامية ستتجه للتقدم والحداثة، ومن المهم النقل من الغرب المتقدم، وعدم إهمال التراث والأصول المضيئة، معاً.
في هذا الزمن الانتقالي كانت المدن العربية تشهد فترة نهوض أو بداية تحول، وكان إلغاء الإقطاع الحكومي للأرض الزراعية علامة أخرى للتطور الاقتصادي. وفي زمن الاحتلالات في بعض الدول العربية تأكد في البداية مسار النمو هذا، مع انتشار المؤسسات الاقتصادية الخاصة.
إن كل هذا قد أنعش الفئات الوسطى وأدى نمو المدن وبعض الحريات السياسية والفكرية والاجتماعية، إلى الاعتقاد بأن المطابقة بين الدول المتخلفة المستعمرة والدول المتقدمة الاستعمارية أمر ممكن.
في مثل هذا الزمن التوسعي للفئات الوسطى ونمو المدن واستقرار العلاقات الزراعية، وعدم حراك الأبنية الإقطاعية العربية، كان من المعكن نشوء التعاون بين المشايخ المجددين والأفندية المتنورين، ولكن إلى حين.
إن الوعي التوافقي والتحديثي بين المشايخ المجددين والتنويريين الذي جمع الفريقين في الزمن الانتقالي بين تفكك الدولة العثمانية ونشوء الأنظمة الوطنية التابعة، يعبر عن تعاون شرائح من الفئات الوسطى الحديثة، لوضع القواعد الفكرية السياسية للتحرر الوطني القومي والديني.
إن نشوء التضاد بين البلدان التابعة والاستعمارية قد جعل الفئات الوسطى تبدأ بقيادة عمليات التحرر المختلفة، وكانت بحاجة لتجميع مختلف فئات السكان المسلمين بمذاهبهم المختلفة، وغير المسلمين، الأمر الذي جعل مثل الأفغاني يطرح وحدة أديان المنطقة، ودعك من مذاهبها.
إن (الإصلاح) الاستعماري الأول بعد الحرب العالمية الأولى، قد وضع بعض أسس التطور الرأسمالي الحديث، دون أن يزيل الهياكل الاقطاعدة، سواء في المستوى السياسي عبر إزاحة أسر الأشراف، والقوى المذهبية المسيطرة على إنتاج الدين وتداوله، أو الهياكل الإقطاعية على مستوى الحياة الاجتماعية كهيمنة الذكور المطلقة على النساء ونتائجه، أو على المستوى الثقافي بسيطرة الأبنية الخرافية والأمية والعاميات على الوعي.
إن (الإصلاح) الاستعماري الأول تركز على تنمية راسمالية التبعية لتحسين شروط تصدير المواد الخام وتوسيع السوق المحلية لبضائع المتروبول، وبهذا فإن الدول العربية التابعة كان عليها أن تعانى من جانبين: مشكلات الأقطاع والتخلف القديم؛ حيث تتوجه أسر الأشراف إلى تبذير المال العام، الناتج من ملكيتها السياسية المشتركة لجهاز الدولة، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يكون إلا بشكل مذهبي، أي عبر غطاء المذهب الديني السائدة الأمر الذي يؤدي إلى تنامي المذهب الديني المغاير، أو الدين المختلف، وبهذا فإن الإصلاح الاستعماري الأول غير علمانى، أي يقوم بتنشيط آلية العلاقات المذهبية / الأقطاغية.
وهكذا فإن شرائح الفئات الوسطى الحديثه الليبرالية، سواء في الوعي الديني، أو في الوعي الرأسمالي الغربي، تجد فضاءً اجتماعياً فكرياً مشتراكاً، عبر توسيع دوائر الحرية واحترام الدور الإنساني للأديان، وهو أمر يتشكل يرؤى مجردة، ولهذا سنجد لدى فرح انطون تلك الطوباوية الحالمة التي اقتطف منها جابر عصفور فقرة مطولة في روايته نشيد أورشليم متخيلاً نفسه مسيحاً جديداً علمانياً، ومنها:
أرى الشعب يرتقي باختراع الآلة الميكانيكية لأن المصنوعات لا غنى لها عنه وعنها فيصير شريكاً لصاحب العمل فيها، وبذلك ترتقي طبقه وتملأ الهاوية بينه وبين سيده صاحب العمل. أرى العمال الضعفاء يصيرون قادة الممالك بالانتخاب العمومى وتقديس الإنسانية.. أرى ملاجئ الشيوخ والمرضى .. وأكابر الأمم يتفاخرون بزيارتها وصنع الخير فيها… مرجع السابق، ص 153، 154.
أما الإمام محمد عبده فهو يدعو للتقريب بين الأديان قائلاً:
وإنما التقريب الممكن في هذا الزمان، زمان العلم والفلسفة، قائم بأن يحترم كل فريق رأي غيره ومعتقده، لأن الحقائق والفضائل غير خاصة بفريق دون فريق.. مرجع نفسه، ص ١٥٢.
إن هذه الكلمات الطيبة لم تستطع أن تزدهر على المدى الطويل، فهى عمليات نسخ من التجربة الأوربية ذات المسار المميز، الخاص بمعاركه وطرق تطوره، أي انها عمليات تنوير جاءت بعد عشرة قرون من تطور البرجوازيات الصناعية
العلمانية الغربية، في حين ان الفئات الوسطى العربية الإسلامية المسيحية كانت لاتزال ذيلية بلإقطاع السياسي والديني و(الاستعماري) المذهبي، أي لم تكوّن مصنعها الخاص ومعملها المغير للتخلف. وحتى المصانع والمعامل ستوضع تحت هيمنة القصور والرقابتين الشرقية والغربية الأقطاييتين.
إن أقساماً من الفئات الوسطى المتنورة هذه شقت الطريق لعمليات التحرر الوطنى، دون أن تقدرعلى طرح البديل الديمقراطي الواسع والعميق للأنظمه التقليدية، واكتفت بالمجرى المحدود الذي أتاحته لها قوى الإقطاع؛ وهكذا نجد في رؤية فرح أنطون السابقة وعياً دينياً مثالياً، فهو يغدو راهباً حالماً، بأن تتحقق الجنة الاجتماعية بمجرد الحلم والدعوة، لا أن يقوم بتحليل الشبكات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية للتخلف، ويضع برنامجاً نضالياً لتغييرها.
وفى الوقت الذي يقوم الإمام محمد عبده بالدعوة للإخاء والمساواة الدينية، ويغير الأشكال المتطرفة من الجمود الديني، لكنه يرفض أن يتحول إلى لوثر الشرق الإسلامي. أي داعية للفصل بين الدين والدولة.
وعدم الفصل هذا راجع لعدم رؤيته للفروق بين الثورة المحمدية التأسيسية وبين سيطرة الإقطاع على الإسلام، وبالتالي فإن إصلاحاته بقيت فى شباك الإقطاع المذهبي.
إن العلمانية المستندة إلى نضال المسلمين، كان لابد أن ترتكز كذلك على تحرير الفلاحين والنساء والدين من هيمنة الأقطاع.
وكما رأينا فإن طبقة الأفندية كما يتفضل جابرعصفور بتوصيفها، هي فئات وسطى مشدودة بألف حبل للإقطاع الشرقي والغربي، أي مع الإقطاع المذهبي ومع الهيمنة الاستعمارية، وكي تتحرر كان لابد أن تكون ملكيتها الاقتصادية والفكرية مُحررة من نفوذ الطبقة المسيطرة.
وبعدم فعلها ذلك، أي بعدم قدرتها على إنجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية، وبعدم قدرة التاجرالنهضوي الحديث على ان يمد يده لتحرير بلال وعمار بن ياسر من سيطرة الملأ الحديث، أي بعدم قدرته على التجييش الديمقراطى للعامة عبر تنفيذ الإصلاحات لها، وبالتالي انخراطها فى النضال لهزيمة الملأ ، أمكن للقوى اللاديمقراطية والشمولية أن تنتصر.
إن علينا أن نرى هذا الديالكتيك المركب للتاريخ: إن تحرر الفئات الوسطى العربية من شباك الإقطاع، يعني تشكلها كطبقة قادرة على تشكيل المجتمع الديمقراطي الحديث، الذي لا يكون إلا بالنضال في المواد التراثية والواقعية المعاصرة في كل بلد عربي، وعلى مستوى الأمة، وسواء في زمن الإصلاح الاستعماري الأول بعد الحرب العالمية الأولى، أم في زمن (الإصلاح) الاستعماري الثاني الراهن.
ولا شك ان خبرة سياسية وفكرية ثمينة تحققت بين (الإصلاحين)، فاذا كان الإصلاح الأول بريطانياً فرنسياً، وبأشكالب الإمبريالية القديمة، فإن (الإصلاح) الراهن هو أمريكي بحت، ولم تعد الرأسماليه المهيمنة عالمياً معتمدة على جلب المواد الخام بشكل كلي، أو على شق مجارٍ محدودة للعمليات الرأسمالية، لقد تغير الموقف كثيراً. وأدى سقوط رأسماليات الدولة القوميه في العالم الاشتراكي والثالث إلى نشوء رأسمالية العولمة الكونية، حيث السيطرة الاقتصادية والسياسية لدى الرأسماليات المتطورة.
وقد كانت الخبرة العربية على مدى العقود الماضية هي تشكيل رأسماليات دولة دكتاتورية، وقد أدت هذه العملية إلى إفراغ الخزائن الحكومية من المال العام، الذي انهال على البيروقراطيات السياسية والاقتصادية التي هي الشكل المستمر للإقطاع السياسي السابق.
إن الفئات الوسطى العسكرية والسياسية المتشددة التي استلمت الحكم في الأقطار العربية الشمالية، قضت على المسار الليبرالي الديمقراطي وإمكانيات التحول اليساري معاً. وبهذا أصبح الغزو الغربي علامة جديدة على إخفاق العالم العربي في الدخول إلى العالم الرأسمالي الحديث. لكنها علامة خطيرة تتجه للتدخل المباشر في كيانات الدول (المستقلة)، الأمر الذي يمكن أن نسميه (الإصلاح) الاستعماري الثاني.
وهذا الإصلاح هو رسملة إجبارية للعالم العربي، اي توسيع جديد للعلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الرأسمالية، وهو كذلك توسيع لأسواق الدول الغازية، بدرجة أولى، لكن إلي أي مدى يحقق الثورة الديمقراطية الوطنية العربية ؟
ومن المؤكد ان (الإصلاح) الاستعماري سوف يثير من البلبلة الفكرية والاضطراب السياسى الكثير في الوعي العربي، وحتى الان فإن (الإصلاح) الأمريكي قد حقق مهمة كبيرة بإزاحة نظام صدام حسين الدموي؛ ولكن تبقى الإصلاحات السياسية بالتعددية والعلمانية والتطور الاقتصادي مبهمه، ولكن الحفاظ على القسمات التحديثية العصرية من قبل القوى الوطنية العراقية تبقى ضرورية وأساسية مع إزالة الاحتلال الأمريكى على مدى السنوات القادمة.
لقد أصبحت قسمات الحداثة عملية إجبارية في التطور العالمي الراهن، فى رأسمالية العولمة الكونية، لكن لا بد للقوى الحديثة العربية التقدمية ان تأخذها باعتبارها إزاحة للأبنية الإقطاعية المذهبية المفرقة للعرب والمسلمين وبضرورة تشغيل رأسماليات عربية حديثة متآزرة وديمقراطية وعلمانية.
وهذا لا يتناقض مع الحفاظ علي جذور المجتمعات العربية الإسلامية المسيحية، بل ان هذا سوف يفتح أفاقاً جديدة لتطورها الديني والاجتماعي عموماً.

لسانُ الشاعرِ المقطوع : كتب ـ عبدالله خليفة

الأبطال والفرح: كتب ~ عبدالله خليفة

رجل في الظلام ـ بول أوستر: كتب ـ عبدالله خليفة

مسلسلات رمضان : كتب ـ عبدالله خليفة

إعادة تقييم التجربة السياسية : كتب ـ عبدالله خليفة

أسباب تدهور وعينا : كتب ـ عبدالله خليفة

الأم والكتاكيت السياسية : كتب ـ عبدالله خليفة

الثورة والكهنوت: كتب ـ عبدالله خليفة

دولة «الحشاشين»: كتب ـ عبدالله خليفة

المتقدمون وغزو الفضاء: كتب ـ عبدالله خليفة

إصلاح أم ضياع : كتب ـ عبدالله خليفة

التقدميون يتغيرون: كتب ـ عبدالله خليفة

مناضلون بلا قواعد: كتب ـ عبدالله خليفة

توسع الفلسطينيين الإنساني : كتب ـ عبدالله خليفة

فلسطين: الأديان والطبقات : كتب ـ عبدالله خليفة

أمدنيةٌ أم علمانيةٌ؟ : كتب ـ عبدالله خليفة

أية ديمقراطية مرجوة؟! : كتب ـ عبدالله خليفة

النقد وتبعيته المزدوجة : كتب ـ عبدالله خليفة

الفردية والفردانية : كتب ـ عبدالله خليفة

شهادة من جمال عبدالناصر: كتب ـ عبدالله خليفة

التقدم في زمن مختلف : كتب ـ عبدالله خليفة

انحطاط الغناء.. انحطاط السياسة : كتب ـ عبدالله خليفة

محمد باقر الصدر: كتب ـ عبدالله خليفة

الفلسفة الغربية والنهضة العربية : كتب ـ عبدالله خليفة

وحدة فكر النهضة : كتب ـ عبدالله خليفة


(الطفولية) والنضال المعاصر : كتب ـ عبـــــــدالله خلـــــــيفة

isa.albuflasa@gmail.com

سر التعويذة
لا تختلف الأفلام الغربية الخرافية كثيراً عن ثقافة الشرق السحرية، فكلتاهما تصنعان البطل الخارق، الذي يساعده طقسٌ ما، أو تعويذة، أو قوةٌ قادمة من الفضاء، لكي يقوم بافعاله العجيبة، ويقدم للبشر الأعمال الفذة والبطولات.
هذا البطل الفرد الخارق هو من صناعة الوعي الإنساني التالي له، حيث يهيل عليه الحكايات الفذة، ويطهرهُ من كل دنس، ويجعل بطولته بلا أسباب اجتماعية أو طبيعية. وفي العصر الحديث تأسس العلم التاريخي الذي يبحث أفكار الشعوب وعاداتها، للعثور على فعل هذه الشعوب في صنع أبطالها وجعلهم مثالاً وأيضاً قيوداً لحركتها المعاصرة.
تبدأ الحكاية من البنت التي تعثر على سمكة فتقوم السمكة بتلبية أحلامها، أو حين تساعد القوى الخارقة الطفل اليتيم على التطور والانتصار على أعدائه، أو حين يُلهم الجن البطل باكتشاف النار وتقديمها للجماعة.. الخ.
وقد كانت القوى المستغلة والمستفيدة من تاريخ البطل الأسطوري هي التي تواصل قطع شرايين حياة البطل عن الظروف حوله، وتصويرها بأشكال خارقة أسطورية، وكأن الفعل الإيجابي لا يمكن أن يتحقق ثانية، إلا من خلال إرادتها، وعبر الرسوم المدفوعة لها.
وقد كان شكل الوعي الإنساني يتم بهذه الصورة منذ أن اكتشف الإنسان النار، حتى قيام صناعة الأفلام في هوليوود. فكل تاريخ الإنسان مشكلات وحلول، والمشكلات تتأسس بسبب ظروف الإنسان الصعبة، المتعددة الأشكال، وتؤدي هذه المشكلات إلى الكثير من النزيف والخسائر وأيضاً فإنها تصنع الأحلام لتجاوزها والحلول للتغلب عليها، ولهذا يظهر بضعة أفراد تتراكم في وعيهم هذه المشكلات، وتصبح جزءا من حياتهم، فيفكرون فيها ليلاً ونهاراً، ويحاولون ابتكار الحلول لها، إما أن تكون طيراناً بأجنحة ملصوقة بالشمع، وإما أن تكون استخداماً للآلة وتكييفها لكي تحمل الإنسان في الفضاء.
إن الإنسان الخارق هو إنسان عادي قام بتحريك وعيه وإرادته لكي يغيرا صعوبات معينة يواجهها الناس، وبفضل هذا الإنسان واستيعابه للظروف وللقوى البشرية حوله وكفاءته في قيادتها واستثمارها وتطويرها، يفلح في اختراق الظروف الصعبة التي بدت لمعاصريه أنها مستحيلة التغيير، وحين يموت هذا الإنسان يحوله اتباعه والمستفيدون منه إلى إنسان خارق. فيقومون بقطع عملية التراكم الحقيقية التي تمت في تاريخه، والمجاهدات الكبيرة التي فعلها ليكتشف الواقع، والثغرات التي من الممكن أن ينفذ منها لتغييره، فيغدو البطل الذي اكتشف النار عند الإغريق الإله بروميثيوس سارق النار ومقدمها للبشر، الذي قامت الآلهة بمعاقبته وربطه في صخرة لتنهش الطيور أحشاءه.
في حين أن عملية اكتشاف النار تمت من خلال ملايين الأفعال البشرية العادية وهي تراقب الصواعق، وهي تضرب الأحجار، وهي تحك الأعواد من أجل خلق شرارة تنمو في أوراق يابسة.
لكن كيف تحول هذا المخلوق الشعبي الواسع العديم الأسماء، إلى بروميثيوس، البطل الخارق، وكيف تم تجاهل الملايين ورفع الفرد الخارق إلى مصاف المعبودات، فإن هذا هو فعل الثقافة السحرية الشعبوية نفسها، حين تلغي جهودها وتاريخها، وتضع بدلاً منها رموزاً مشبعة بكل تاريخها الخفي.
وفي حين اعتادت الثقافة الفلكلورية الشعبوية هذه وضع الزيوت في هذه القناديل، وتزويق الأبطال الخارقين، وتصنيف المؤلفات حول خوارقهم، تقوم الثقافة الحديثة على اكتشاف بطولاتهم الحقيقية، ورؤية مسار التفكير الشعبي الخارق الذي قيد نفسه بنفسه، وتحريره بهذا واطلاق قدراته لخلق بطولات جديدة تحت ضوء الوعي والفعل الجماعي.
isa.albuflasa@gmail.com
-
اشترك
مشترك
ألديك حساب ووردبريس.كوم؟ تسجيل الدخول الآن.



