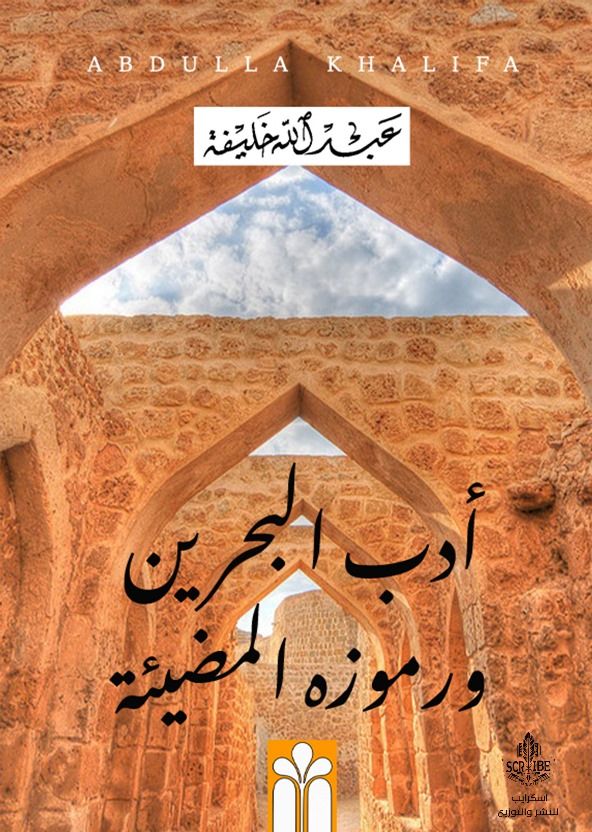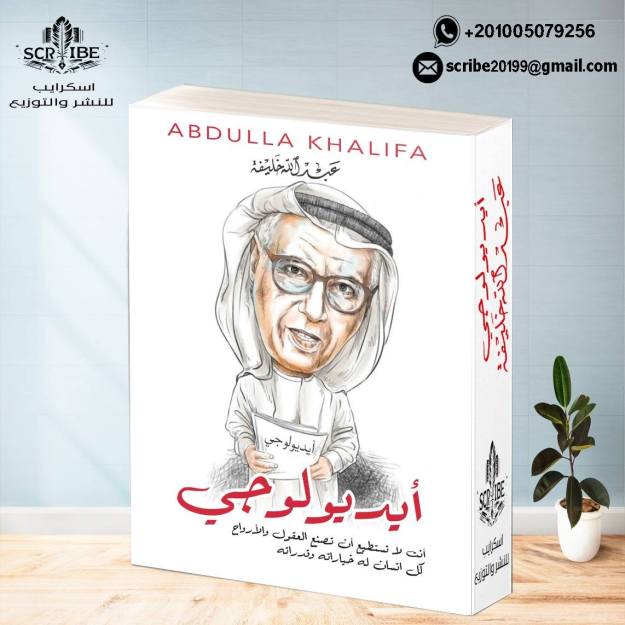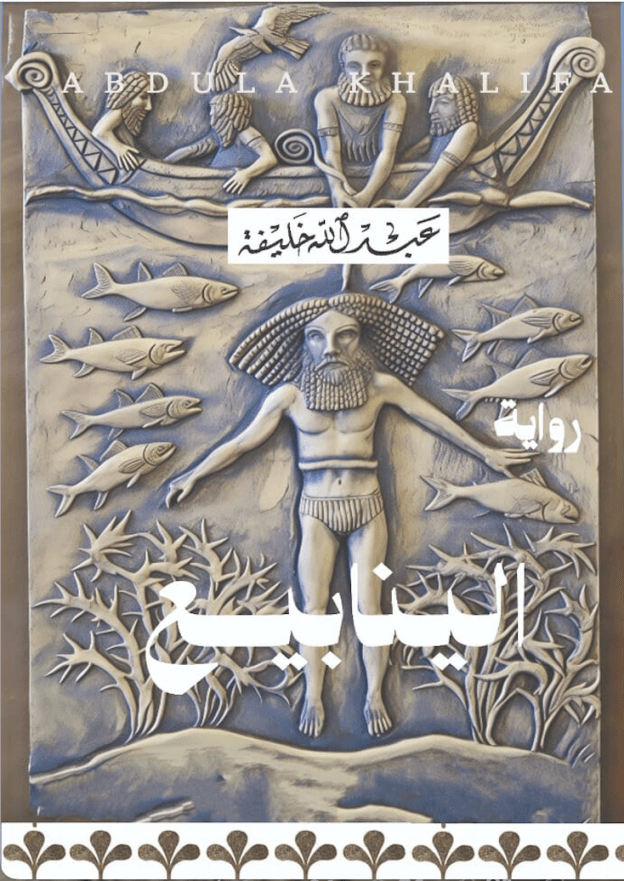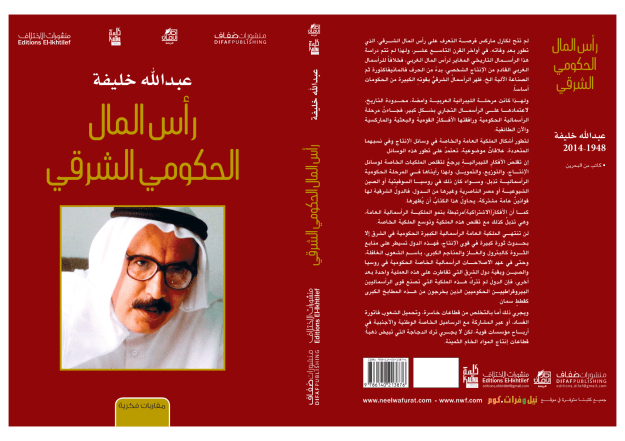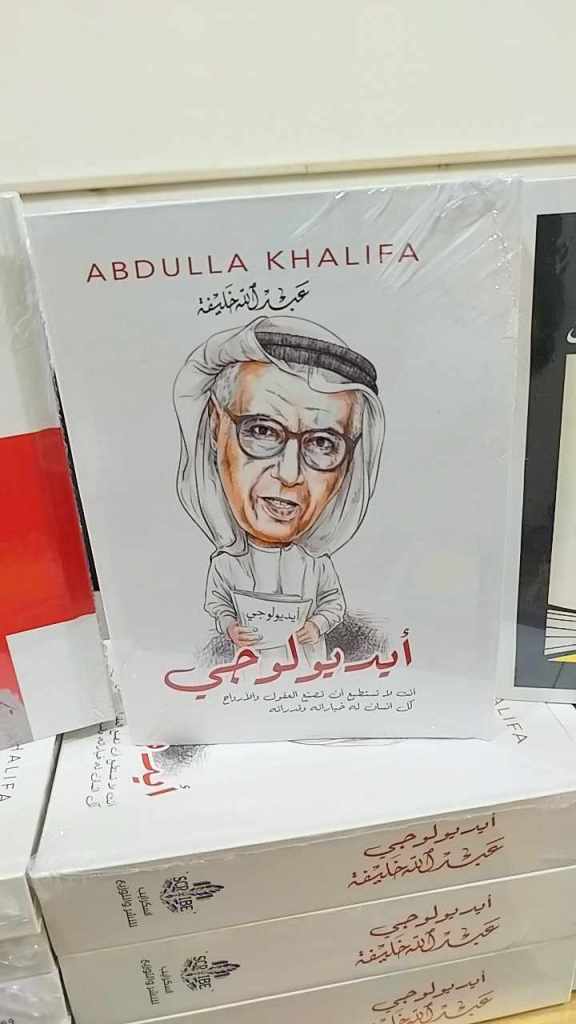مثل أي نظام عربي يعتبر الديمقراطية مناورة سياسية غير مرتبطة بوجود نظام علماني راسخ، قامت السلطة الفلسطينية بإجراء إنتخابات تشريعية جاءت على رأسها حركة حماس في مفاجأة كبيرة للجميع.
هذه المفاجأة تعكس تناقضات الوضع الفلسطيني، فقد قامت حركة فتح بقيادة النضال الوطني وتقدمت به إلى آفاق كبيرة، وكأي حركة سياسية وطنية في الشرق كانت حركة شمولية، ذات شعارات فضفاضة، غير راسخة في مسائل الحداثة المحورية؛ وهي العلمانية والديمقراطية والعقلانية، لكنها لم تخلُ من ملامحٍ منها، تبدو على شكل شعارات، وكان أهمها مشروع تشكيل دولة فلسطينية على أي تراب فلسطيني مُحرَّر وتكون دولة علمانية وديمقراطية مفتوحة لكل السكان فيها.
كان هذا الخيار ذاته صعباً في ظل منظمات فلسطينية متطرفة قومياً، تنادي بدولةٍ من النهر إلى البحر، وتستخدمُ الكفاحَ المسلحَ فقط، وهو أمرٌ يعكسُ مستوى الوعي السياسي الفقير في هذه المنظمات، وعدم معرفتها بالواقع الذي تريد تغييره، سواءً من حيث عدم معرفة القوة الإسرائيلية أو واقع البلدان المحيطة بها أو آفاق نضال شعب فلسطين في الداخل.
وأهم نقطة في هذا عدم درسها لتناقضات الدولة العبرية وكون هذه التناقضات هي قاعدة التحرك المنتظر، لكنها كانت ذات نظرة متجوهرة، غير تاريخية، وغير طبقية، فهناك فلسطين وهناك إسرائيل، هنا أبيض وهناك أسود، ويجب أن يسود الأبيض ويُسحقُ الأسود، وهي نظرة دينية شرقية جامدة ضاربة في القدم، لا ترى في الدول والحضارات تكوينات تاريخية مرحلية متناقضة، يكمن العمل السياسي الثوري في كشف تلك التناقضات وحركيتها وتوظيفها لصالح الأغلبية الشعبية.
لكن كانت حركة فتح أكثر هذه المنظمات مقاربة للظروف الموضوعية، عبر طرحها شعار الدولة العلمانية الديمقراطية، مما كان يفتحُ الأفقَ لجذب أقسامٍ من الإسرائيليين للعمل المشترك، وكان هذا يضربُ جوهرَ الصهيونية بشكلٍ عميق، وقد زواجتْ فتح بين العمل العسكري والنضال السلمي، وانفتحت على كل الجمهور الفلسطيني والدول العربية، وهذا كله أكسبها حضوراً قيادياً رائداً.
لكن من جهة أخرى ظهرت القيادة الفردية وشكلت بيروقراطية داخلية، وهيمنت على فتح، وعلى منظمة التحرير، وعلى الدخول النقدية فيها، معطية أدواراً ثانوية للقوى السياسية الأخرى.
كذلك لم تكن بعيدة عن المغامرات العسكرية، حيث كان الواقع الفلسطيني والكيان الإسرائيلي يبدوان لها في حالة سكونية، ومادة فعلٍ سلبية، وأنها هي صانعة التغيير، وهي ثقافة موجودة بقوة لدى الفلسطينيين في الداخل كما في الخارج.
وكان الحراكُ الطويل لهذه القوة النضالية في الخارج عاملاً جاذباً للكثير من القوى السكانية المشردة بفعل المجازر الإسرائيلية والغزو الفاشي، وهي الطبعة الأولى من الصهيونية، مما أدخل في فتح وغيرها من المنظمات جمهوراً بلا خبرة سياسية وقابلاً للنضال ولكل المغامرات المجنونة كذلك.
وكما ظهر الخط الوطني المعتدل في فتح ظهر الخط الوطني المتطرف في (الجبهة الشعبية) وغيرها من المنظمات القومية، ووجدت بعضُ الدول العربية في هذا الانقسام فرصة لاستثماره وتقرير حركة الشعب الفلسطيني من خارجه، ووجدت دولٌ أخرى صيغة مغايرة عبر ترسيخ منظمة فتح كقائدة للشعب الفلسطيني، وجعل رئيسها رئيساً للدولة التي تعيش حالة مخاض الولادة العسير.
ولكن كل هذا الحراك السياسي الخارجي البطولي والمغامر والنازف آلاف الشهداء، والمؤجج لصراعات المنطقة ومشاكلها، لم يثمر عن تحريرِ بوصةٍ واحدة من التراب الفلسطيني!
وكان الحوار الفلسطيني – الإسرائيلي البداية الحقيقية لفتح الطريق للتحولات، وهو أمرٌ كان يبدو كخيانةٍ عظمى، وكارثة قومية لدى المتجوهرين وأصحاب الرؤى الساكنة الدينية، فظهرت في وجهِ هذا الحوار منظماتٌ متخصصة في الأغتيال كأيلول الأسود وغيرها، وشاركتها المخابراتُ الإسرائيلية في قطعِ رؤوسِ الوطنيين والمثقفين البارزين الذين كان بعضهم يقود الحوارات وبعضهم يقود العمليات العسكرية.
لقد أدى الجدبُ السياسي في النضال الخارجي، وتشتت الجيش الفلسطيني في المنافي البعيدة بعد إحتلال لبنان، إلى أن يبرز العاملُ الوطني الداخلي في كل من فلسطين وإسرائيل، ليغير هذه الصفحة التي استمرت عقوداً.
لقد بدأ وعي وطني علماني ديمقراطي يتغلغلُ في صفوف جماهير هاتين الدولتين، حيث بدأ الشعبُ الفلسطيني في الضفة وغزة يدرك كونه شعبَ دولةٍ مغيبة، وأن الشعوب الأخرى لا تستطيع تحريره، وعبر الحجر الذي يملكه كلُ ولد فلسطيني بدأت عملية التغيير الشعبية، وكان الجمهور الإسرائيلي قد تعب من الحروب ومن سيطرة قوى العسكر والمال المغامرة بمصيره وظروفه خدمة لمشروعات دينية متطرفة أو لمؤامرات غربية فاشلة.
لقد بدأ تاريخٌ آخر، وقامتْ الطليعة الفلسطينية الخارجية بدورها في التحريك السياسي، لكن الآن بدأت الأرض هي التي تتكلم.
وغالبية الفلسطينيين هم من المسلمين فيما يمثل المسحيون ما يقارب 10%، والمذهب السائد هو المذهب السني، حيث تداخلت المذاهب السنية في نسيج واحد خاصة في الدول خارج الجزيرة العربية خاصة.
ولهذا فإن الصراعات المذهبية لم تتواجد داخل الحركات السياسية الفلسطينية، لكن هذه الحركات تأثرت ببلدان النزوح المختلفة، فأكتسب بعضها طابع اليسار المتطرف، خاصة التي تواجدت في سوريا ولبنان، فيما نشأت حركة فتح في الكويت متأثرة بجوها السياسي الديمقراطي العلماني السني في ذلك الوقت، وراحت تمتد في الأردن والأرض المحتلة.
ولكن تجربة الشعب الفلسطيني في بلدان النزوح اتسمت بالاضطراب الشديد، بسبب القمع والتضييق العربي الحكومي، وتعدد بلدان النزوح وتبعية أقسام من الفصائل لبعض الحكومات العربية التي إستغلت ظروف الهجرة والفقر في خلق قوى سياسية تابعة لها داخل النسيج السياسي الفلسطيني ثم قامت هذه القوى بالانقسامات والصدامات والتبعية البوليسية لتلك المراكز ففجر ذلك العديد من المواجهات.
وعموماً كان الاضطراب في تجربة فلسطيني النزوح أكثر بكثير من الداخل، وخاصة في قطاع غزة المتضخم بالسكان والذي تغلغلت فيه حركة حماس خلال عقود طويلة.
والتقت تأثيرات الاضطراب السياسي في الخارج وعدم المعرفة الدقيقة بأحوال الشعب الفلسطيني من قبل القيادات العائدة من المنفى بالمحافظة الشديدة في غزة وأنتج ذلك إنقساماً على صعيد الأرض المحررة المستعادة!
مثلما أن القوى الحاكمة في إسرائيل تمكنت من بعد تطوراتها العسكرية والاقتصادية الكبيرة من التحكم في الأرض الفلسطينية وتحديد إتفاقيات السلام وربطت قسماً كبيراً من العمالة العربية بها، ووضعت المتشددين الفلسطينيين في زاوية ضيقة، توجهاً لرسم خريطة سياسية متطابقة مع مصالحها وأفق تطورها.
وبهذا فإن القوى الشعبية الفقيرة الفلسطينية هي أكثر القوى معاناة في المنطقة، عبر الأجور المتدنية الحضيضية، وبغياب الموارد في الضفة والقطاع، وسوء الحياة المعيشية وترديها في مخيمات النزوح في لبنان وسوريا والأردن.
وهذه المناطق والمخيمات قادرة على توليد سياسات متطرفة تستغلها الحكومات المختلفة من أجل تفجير الصراعات السياسية مثلما يحدث في لبنان.
أو أن يغدو الفلطسينيين الفقراء كبش الفداء في الصراعات السياسية العربية كما حدث في العراق على مدى حروبه المختلفة، وفي الأيام الأخيرة كانوا ضحايا السلام مثلما تم لجؤهم على الحدود العراقية.
لم تكن سياسة الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات على رغم العديد من إنجازاتها حكيمة في العلاقة مع بعض الدول العربية الشمولية التي أضرت بالقضية، بخلاف الرئيس الحالي أبو مازن الذي وجه السياسة نحو الاعتدال وإقامة علاقا جيدة مع كل الدول العربية.
عكس التوجه الفلسطيني لخلق مؤسسات منتخبة رغبة الإدارة الأمريكية في زمن الرئيس بوش تحقيق مسحة ديمقراطية لأصدقاء الحكومة الأمريكية في المنطقة العربية، وإذا كان هذا هدف أصيل كذلك للشعب الفلسطيني إلا أن التطورات الداخلية الفلسطينية الإيجابية هذه جاءت بتسريع لم يـُنضّج له على مستوى البُنى الاجتماعية والسياسية، التي هي مثل غيرها في الدول العربية بُنى تقليدية ماضوية لا علاقة لها بالديمقراطية الحديثة.
وإذا كانت فتح ذاتها قد إستغلتْ هذه البنى في سيطرتها السياسية، ووضعت رجلاً أخرى في الحداثة كذلك، فإن عملية التسارع في السيطرة على الضفة والقطاع بعد الإنسحاب الإسرائيلي، تنفيذاً لإتفاقيات أوسلو، لم تتشكل عبر جبهة حداثية فلسطينية علمانية ديمقراطية بقيادتها.
عبرت هذه الإتفاقية عن مستويين؛ مستوى الحوار الفلسطيني – الإسرائيلي، ومستوى القوة الفلسطينية المحدودة على الأرض.
ولثاني مرة يحدث إنسحابٌ إسرائيلي من أرض عربية كبيرة (بعد مصر)، ويخلف إنفراجاتٌ سياسية وتقدماً اجتماعياً مهماً، مما أكد أهمية سياسة السلام في خلق التحولات بعد كل تلك الكوارث للحروب السابقة.
ومن جهة أخرى فإن الانسحابات المحدودة التي لا تحل مخلفات الأحتلال الإسرائيلي بالكامل، تعني بقاء سيطرة القوى العسكرية – الدينية المتنفذة في إسرائيل، واستمرار المواجهة مع أطراف عربية أخرى، وهو أمرٌ يؤدي إلى عدم حل القضية الفلسطينية ذاتها.
إن التسويات المنفردة رغم تمثلها للتقدم الهام إلا أنها تحوي بذور الصراعات والحروب أيضاً، فالصراع العربي – الإسرائيلي يحتاج إلى تسوية تاريخية عميقة شاملة، على مستوى تعاون الأديان السماوية، وعلى مستوى تصالح الشعوب، وعلى مستوى إزالة الإحتلال.
وبهذا فإن توجه فتح لحكم الضفة والقطاع وجعل أجهزتها تهيمن عليهما، بعد عقودٍ من الأحتلال الذي خلف الكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فجعلها هذا التسرع المتعدد الوجوه تتعرض لانتقادات كبيرة من الجمهور الفلسطيني، الذي بعد أن فارق نشوة التحرير أرجعته صرخات البطون والبيوت والحشود الفقيرة إلى الأرض الحادة.
وكان التسريعُ (الديمقراطي) يعتمدُ على تلك المنظمة الفتحاوية الجماهيرية العريضة، غير الراسخة في بناها العلمانية الديمقراطية، والتي قبلتْ وجود الأحزاب الدينية، وبجعل تنظيم سياسي آخر يمثل الإسلام وحده، وبهذا فقد نزعتْ صفة الإسلام عنها وعن بقية الأحزاب العلمانية.
ولم يكن فضاء نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين مثل أزمنة الستينيات فقد غاصتْ المجتمعاتُ العربية في أزمة فشل التحديث الرأسمالي المحافظ بعجز تلك الأنظمة عن مقاربة الحداثة، وصعد محور دول العراق وإيران والجزيرة العربية، النفطي المحافظ الأكثر من السابق، وراجت الشعاراتُ المذهبية السياسية كشكلٍ لتدفق سكان القرى والبوادي على المدن العربية، طارحة فضاءً غيبياً لحل الأزمات السياسية والمعيشية.
وقد استثمرت منظمة حماس التكوين الإسرائيلي الأولي لها كمنظمة يكمنُ دورُها في شقِ صفوف الفلسطينيين، وخاصة شق منظمة التحرير، وكذلك بقائها الطويل المهادن على الأرض خلال عقود، وذلك الغياب للوعي الديمقراطي والعلماني وسط الجمهور الفقير الحاشد الذي امتلأت به أزقة غزة خاصة، وبهذا فقد كانت الانتخابات التي قلبت الأوضاع السياسية وشقت الفلسطينيين على مستوى المؤسسات وعلى مستوى الأرض، هي جزء من المتغيرات الفلسطينية التي جرت في الجمهور، وجزء من متغيرات المنطقة.
لقد جمدت فتح منظمة التحرير التي كانت مؤسسة مهمة لصقل الفكر الفلسطيني الديمقراطي العلماني المفترض والإسلامي العميق كذلك، وتحولت إلى تنظيم فضفاض، راح كوادرهُ يستولون على موارد مهمة، وبطبيعة الحال لم تكن قادرة على أن تكون معبرة عن برجوازية فلسطينية قوية، لضعف الصناعة ولعوامل الشتات، وحروبها، التي كانت كلها ضرباً للرأسمال الفلسطيني وللعمال.
وكان قادة حماس قد سيجوا الفقراء حولهم بشعاراتِ الغيبِ (الإلهية)، المؤدلجة لمصلحة بعض قوى الأرض الفاسدة، واستثمروا خطاب العنف الفلسطيني الإلغائي الطويل، (دولة من النهر إلى البحر) والذي تكرس بقوة في انفعالات الشعب العاطفية الحادة، وعلى بحار الدم الفلسطينية، فانتصروا انتخابياً وعمقوا أزمة الشعب الفلسطيني أكثر فأكثر.
وبهذا كانت الضربة لدكتاتورية فتح، وتبياناً لخطورة الخطاب العنفي الفلسطيني العاطفي، ولعدم التحضير المطول لإنشاء دولة علمانية، ولعدم تكريس سياسة السلام، ولعدم قراءة الإسلام بعمق.
وقد سارعت فتح في الحفاظ على سلطتها الحزبية، فأصدر المجلسُ التشريعي المنتهية صلاحياته والذي تسيطر عليه فتح عدة قرارات كبيرة محورية، وهي صدور مرسوم رئاسي بتعيين رئيس الموظفين كتابع لديوان الرئاسة، ومنع الحكومة المقبلة من تعيين أو فصل الموظفين، وتعيين أمين عام للمجلس التشريعي الجديد من فتح، وإنشاء محكمة دستورية يعينُ الرئيسُ الفلسطيني قضاتها، ونقل مسئولية الأجهزة الأمنية للرئيس مباشرة وليس لوزير الداخلية كما يُفترض، ونقل الإذاعة والتلفزيون إلى إدارة الرئيس كذلك، وبهذا قامت فتح بإفراغ سلطة حماس من نفوذها الأمني والإعلامي، رغم إنها حكومة منتخبة.
ولم تتقبل حماس هذا التحجيم ولم تقبل بدور العمل لتغيير أوضاع الشعب الفلسطيني الحادة، وابتعادها عن سلطات الرئيس التي غدت رسمية قانونية، فتوجهت للصراع مع مؤسسات الرئاسة ومن ثم الأنقلاب على السلطة العليا، وعدم القبول بقرارات الرئيس، ثم فصل قطاع غزة عن الضفة.
كان عدم توجه حماس للتركيز على أوضاع الشعب المعيشية التي كان ينبغي أن تكون بؤرة نشاطها الحكومي المفترض والتي أُنتخبت على أساسها، يعبر عن رؤية متضخمة لذاتها، ولكونها تتجاوز أطروحات فتح والقوى الوطنية الأخرى، فهي تحمل هوية (إلهية) قادرة على هزيمة إسرائيل عسكرياً، بعد أن عجز عن ذلك فارس الفرسان، وتمخضت تلك الهوية الميتافيزيقية عن إنصراف عن الأمور المحورية الاقتصادية للسكان، وجرهم إلى معارك غير متكافئة مع الجيش الإسرائيلي، وتخريب وضعهم المعيشي السيء. ومن هنا فهي تخاف من أية إنتخابات جديدة بعد أن تم كشفها على صعيد الممارسة السياسية الضعيفة على الأرض.
ومن الواضح بأن ذلك كله جرى وليس في حماس إهتمام جدي بعملية السلام المحورية في حياة الفلسطينيين والإسرائيليين، وقد جاءت على أجنحة رؤية تصادمية هي إستمرار للماضي العنفي، وحاولت أن تجعل من الضفة وغزة الخارجتين بصعوبة من الأحتلال منطقتي حرب وبداية لتحرير فلسطين.
وقد توافق هذا مع سياسة المحور الإيراني – السوري، ومع صقور المؤسسة العسكرية الإسرائيلية والحركات الدينية اليهودية المعادية للسلام، وهي قوى تشترك من خلال مواقعها المختلفة في تأجيج التدخلات في الدول والنزاعات وتوتيرها خدمة لأهدافِ كلٍ منها الخاصة.
وبهذا أصبح لفلسطين جسمان جغرافيان منفصلان، عوضاً عن ضم الجسم الثالث السليب.
وبدلاً من رئيس واحد صار لها رئيسان.
وصارت لها دولتان وعلمان، العلم الفلسطيني الرسمي والعلم الأخضر. وصار لها نشيدان الخ..!
وإنشغلت الضفة بطلب المساعدات وتغيير أوضاع الناس الاقتصادية وأنشغلت غزة بإطلاق الصواريخ، ومقاومة الحصار، وضاع برنامج التحرير والسلام إن لم يكن قد ضاع وجود الشعب.
لا بد من القول كلمة هنا حول استثمار حماس للإسلام، وهو بخلاف الاستثمار الفتحاوي الانتهازي النفعي السابق الذكر، فهو إستثمار رجعي متضخم، فقد حاولَ قادة حماس أن يضعوا أنفسهم مقاربة لمنزلة النبوة في صراعها مع اليهود، فكأنهم في نفس النزال ونفس المكانة! وقد كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يواجه مجموعة ليست بضخامة اليهود الحاليين، ولا بعدتهم ولا بعلاقاتهم الجبارة مع قوى الهيمنة في العالم، وكان بقربه مئات الآلاف من العرب إستطاع أن يحركها ويوظفها، فكان صراعه معهم صراع اقتدار وانتصار ولغاية (تأسيسية) للأمة، وبعد ذلك جاء التعامل المغاير معهم ومع غيرهم بحسب إنسانية وديمقراطية الحركات والدول الإسلامية، أما صراع حماس الراهن مع إسرائيل فهو صراع إنتحار وكوارث على الشعب الفلطسيني!
فلا يجب توظيف آيات القرآن توظيفاً خاطئاً شرعاُ وسياسة، وإجراء عمليات المماثلة بين تاريخين مختلفين، في وضعين مغايرين، فتكون إساءة مزودجة لتاريخ الإسلام ولرموزه وللوعي والمسئولية في السياسة المعاصرة.
كانت الأوضاع الاقتصادية متردية في الضفة والقطاع منذ بداية القرن العشرين فيما تكشفه الأرقام، فيصف تقرير للأمم المتحدة الأوضاع بالصورة التالية:
(ذكرت بعثة منظمة العمل الدولية في تقريرها أن عمليات إغلاق الحدود الإسرائيلية ونقاط التفتيش بين الأراضي المحتلة وإسرائيل والبلدان المجاورة أثرت تأثيراً مأساوياً على اقتصاد المنطقة. فهبطت الأجور الحقيقية للعمال الفلسطينيين في إسرائيل بنسبة 46% تقريباً في 2001 مقارنة بالعام السابق، في حين تدنت إيرادات السلطة الفلسطينية بنسبة تزيد عن 70%.
وذكر التقرير أن تصعيد العنف والاحتلال العسكري للأراضي تسببا في أضرار مادية كبيرة بالبنية التحتية والأراضي الزراعية. وتقدر الأرقام الأولية تكلفة إعادة بناء المباني العامة والخاصة والبنية الأساسية في الضفة الغربية وحدها بنحو 432 مليون دولار أمريكي.
وأضاف التقرير أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالمناطق الفلسطينية هبط بنسبة 12% في عام 2001 كما هبط الدخل القومي الإجمالي الحقيقي – وهو مجموع الناتج المحلي الإجمالي وعامل الدخل المكتسب في الخارج (أجور العمال الفلسطينيين المكتسب في إسرائيل) بنسبة 18.7%.
ولاحظ التقرير أن أكثر من 90% من السكان الفلسطينيين يعتمدون على شكل من أشكال الدخل الناتج عن عمل في الأراضي المحتلة. وأضاف أن ” أي هبوط في الاستخدام في الدخـل الناتج عن العمل يترجم فوراً إلى هبوط في الاستهلاك والرفاهة”. وتشير التقديرات الأوليـة للمكتب إلى أن “البطالة يمكن أن تصل إلى قرابة 43% في الأراضي المحتلة خلال الربع الأول من عام 2002. وقد ازدادت النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون في فقر (اقل من 2.1 دولار أمريكي يومياً) من 21% عام 1999 إلى 33% عام 2000 وإلى 46% عام 2001. وذكر التقرير أن الرقم يمكن أن يصل إلى 62% عام 2002. ووفقاً لما ورد في التقرير، فإن إسرائيل لم تنج من الانتفاضة. فقد عانى النشاط الاقتصادي في إسرائيل من انكماش حاد خلال عام 2001 بهبوط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% خلال عام 2001 بعد زيادة بلغت 6.4% عام 2000.
وقد تضرر الاقتصاد الإسرائيلي بشدة نتيجة ثلاث صدمات اقتصادية: تباطؤ الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من العام 2000؛ وتدهور الوضع الأمني لنشوب انتفاضة 2000؛ وعواقب أحداث 11سبتمبر.
واستطرد التقرير قائلاً “وكانت الصناعات عالية التكنولوجيا هي الأشد تضرراً من جراء تدني النشاط في الاقتصاد الأمريكي، يليها هبوط بنسبة 50% في عدد السائحين في 2001 نتيجة أحداث 11 سبتمبر، وتدهور الوضع الأمني الداخلي. وتعرض النشاط في قطاع البناء لفوضى حادة نتيجة الانسحاب المفاجئ لنحو 000 55 عامل فلسطيني، فضلاً عن هبوط الطلب المحلي والاستثمار العام. وامتدت هذه الصدمات التراكمية إلى الاقتصاد برمته.
وارتفعت البطالـة بشكل متواصل خلال عام 2001، من 8.1% في الربع الأول إلى 10.5% في الربع الأخير – أي ما يساوي 000 267 شخص. وأضاف التقرير أنه “تم استدعاء نحو 000 30 من قوات الاحتياط للخدمة العسكرية في الربع الأول من عام 2002، الأمر الذي قد يحدث أثاراً ضارة على أنشطة. واختتم تقرير المكتب قائلاً “يدفع السكان الفلسطينيون والإسرائيليون ثمناً باهظاً للاحتلال والعنف. ويشهد الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الأراضي المحتلة تدهوراً يومياً مع ارتفاع مستويات الفقر والبطالة التي أصبحت عملياً أزمة إنسانية سائدة).
لقد غدت البنية الاقتصادية الفلسطينية معتمدة على البنية الاقتصادية الإسرائيلية، وليس ثمة إمكانية للتفكيك بينهما، وأي علاقات توتر تنعكس على المعيشة بين الشعبين، كما يجري ذلك أيضاً على المستويين المصري والأردني بدرجتين أقل.
ولهذا فإن غالبية الشعبين تتطلع إلى علاقات جديدة بينهما، وبهذا فإن الأوساط المتطرفة في كلا الجانبين خفتت لكنها لا تزال قوية كذلك، فالقوى اليمينية المتطرفة الإسرائيلية ترفض أي إنسحابات وتقوم بتوسيع المستعمرات، وتعزز الجدار الفاصل، وتريد حدوداً تختلف عن حدود 1967، في حين تقوي حماس والجماعات الدينية المتطرفة في غزة التوتر وترفض الحلول السلمية لهذه الأزمة الرهيبة الطويلة التي إستنزفت الشعب الفلسطيني بدرجة خاصة لأسباب غدت واضحة.
ومن المؤكد بإن الحل النهائي للأزمة لن ينهي العلاقات بين الجانبين بسبب اعتماد العمالة الفلسطينية الكبير على الاقتصاد الإسرئيلي، وبسبب تدني أجور هذه العمالة وتفاقم الهجرة اليهودية من إسرائيل المضطربة نحو الغرب.
وفي دراسة أمريكية إستطلاعية عبرت شريحة من المواطنين العرب والإسرائيليين في داخل إسرائيل عن تأييدها للتعايش المشترك بين الجانبين:
(أظهرت نتائج استطلاع الرأي أن أغلبية مهمة من المواطنين اليهود والعرب يؤيدون التعايش، إذ عبرت الغالبية العظمى من المواطنين اليهود (73 %) والمواطنين العرب (94 %) عن رغبتهم في أن تكون إسرائيل مجتمعاً يقوم على الاحترام المتبادل بين المواطنين العرب واليهود وعلى تكافؤ فرص.)، (عن شبكة العلمانيين العرب).
إن نمو الفلسطينيين داخل إسرائيل يتزايد وهم يشكلون 20% من السكان، ويزاد حضور اللغة العربية وتدريسها في الجامعات الإسرائيلية.
ومن المؤكد إن نمو علاقات سلمية سوف يزيد الحضور السياسي للجمهور المدني وخاصة القوى العاملة المتضرر الأكبر من الصراع، وبالتالي فإن هذا سوف يزيد من حضور الأحزاب الديمقراطية والتقدمية في الجانبين.

صراع الطوائف والطبقات في فلسطين
أضف تعليق