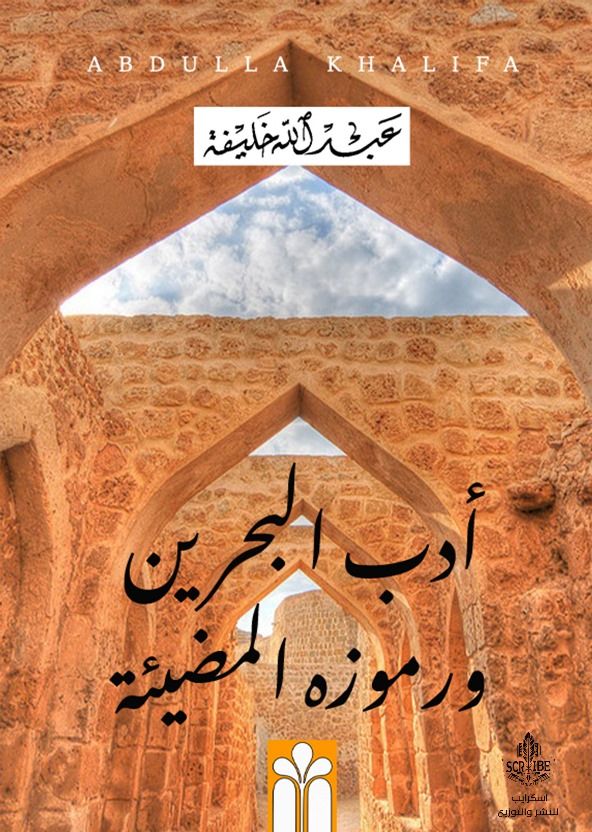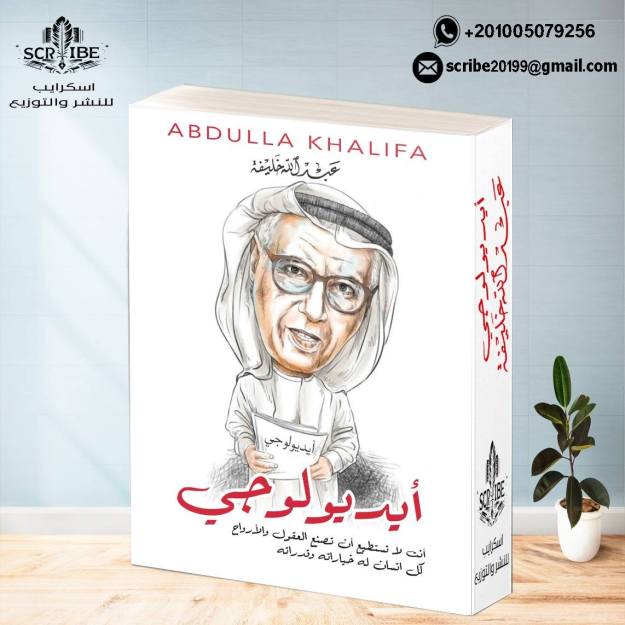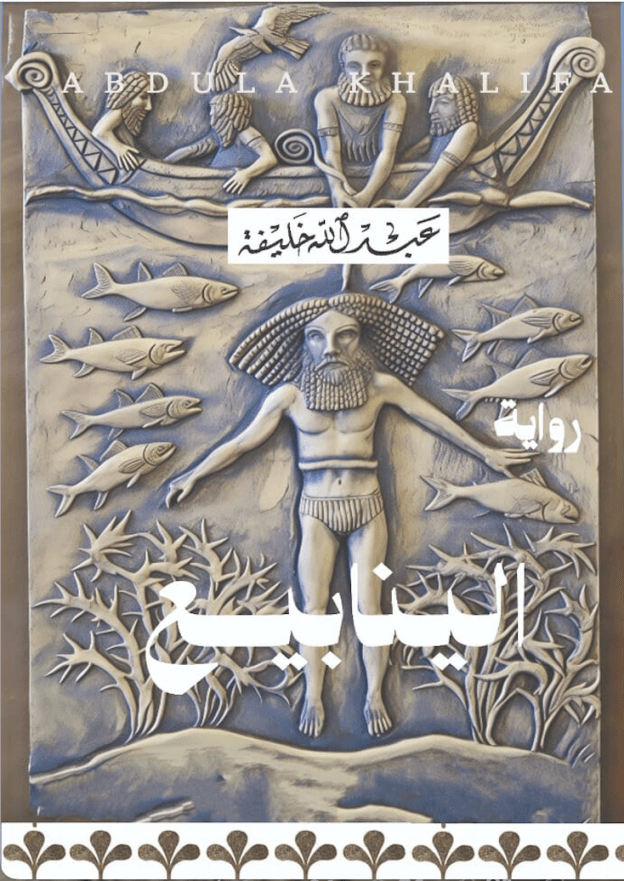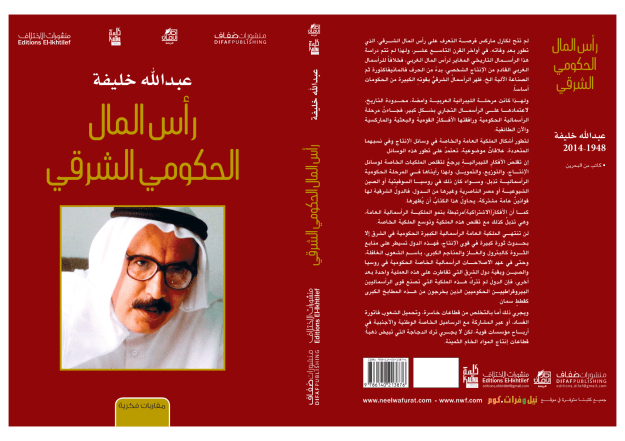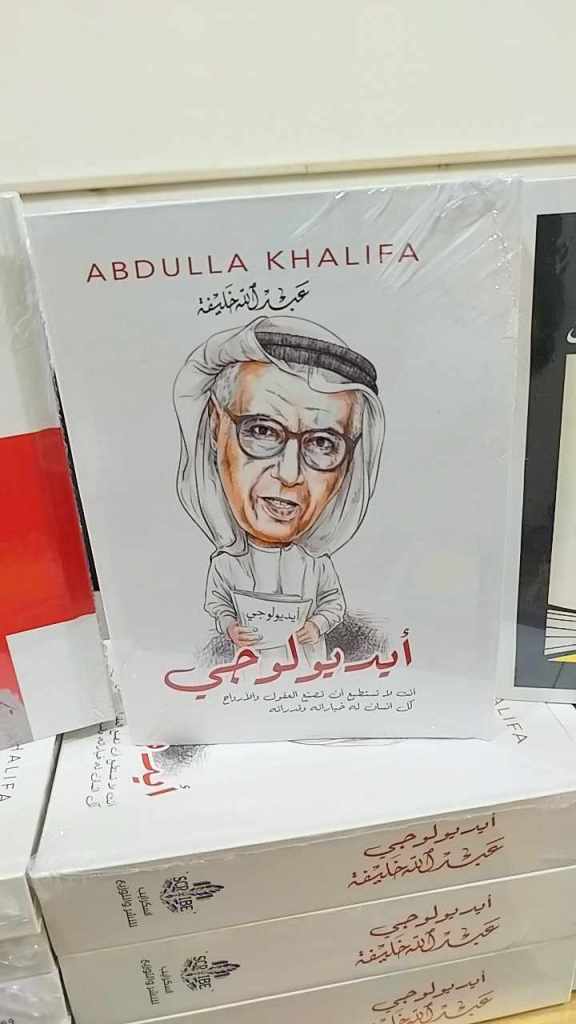قوة الثقافة وقوة المال
تتجسد قوة الإسلام الأول، قوة التغيير العربي الإنساني، في تحول الثقافة إلى ثقافة تغيير، وهي لم تتحول إلا بسبب دخولها في عقول الناس.
والثقافة حين تصير قوة تغيير كبرى لا بد أن تلتحم بمصالح الجمهور الواسع، لهذا فإن الدعوة السرية المكية المخصصة لتشكيل الكوادر الأساسية، تصيرُ في المرحلة المدنية قيادة جمهور القبائل الواسع المنخرط في العملية التحولية التاريخية.
لكن الثقافة ظلت في هذه المرحلة القصيرة من عمر الزمن قصيرة، رغم إشعاعها الواسع، فهي لم تلتحم بأداة الملكية العامة، إلا في لمحات من عهد عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، ثم هجم عليها الملأ مرة أخرى كما هجم في السابق على الثروة العامة.
قوة الثقافة خطيرة وأعجازية، لكنها تغدو بلا جدوى حين تغدو ثقافة محضة، نخبوية مفارقة للجماعة، ولا تقيم العلاقات الوطيدة مع الجمهور، وحين تتصدى لمهام التغيير فلا بد أن تجعل العامة أداة التحويل لها، لكي يصير الخاصة في علاقة ديمقراطية مستمرة مع العامة.
لقد استطاع الملأ المكي الذي استعاد السيطرة على مقاليد السلطة أن يفكك سلطة الثقافة، عبر سلطة المال.
إن سلطة المال أقوى في كل العصور، وليست سلطة الثقافة سوى لحظة تاريخية أستثنائية ومبهرة بقوتها وإنجازاتها، لأنها تقوم على المشاركة والتضحية والأخوة الإنسانية، لكنها لا تحكم طويلاً، لكونها تبتعد عن العامة، وتهمل الملكية العامة، وتهمل تجنيد العامة وتحويلها إلى أساس للسلطة.
وسلطة المال لا تكتفي بإغراء الذهب والفضة بل هي تريد التحكم كذلك في الثقافة وتدجينها وتحويلها إلى دجاجة من دجاجاتها التي تبيضُ ذهباً!
ومن هنا حين تمكنت من السيطرة على مقاليد الحكم أخضعت الثقافة بشتى ألوانها لتغلغلها ولسيطرتها، فغدت الثقافة مهتمة بمصالحها الذاتية، فصار الفقيهُ مستأجراً، والشاعر مرتزقاً، والعالم تابعاً، والناثرُ كاتب رسائل سلاطنية، والكيمائي يبحثُ عن تحويل المعادن لذهب الحكم، الذي أضاع كل الثروات على شهواته وخدمه..
تفككت عناصر الثقافة المتوحدة في القرآن، فصارت تعادي بعضها بعضاً، مثلما أن المثقفين يتصارعون فيما بينهم، والشاعر يعادي الناثر، والعالم يتجاهل الشاعر، والفقيه يحتقر ثقافة غير المعّممين، وهكذا استطاعت الطبقة الحاكمة التي ركزت السلطة والثروة بين يديها، أن تفكك عناصر الثقافة التي لم تستطع أن تروضها كلها بين يديها!
ولا تستطيع أن تعود الثقافة لمكانتها العالية دون أن تستعيد وهج المراحل الثورية العظيمة السابقة، بأن تعود للناس، وأن تصبح قوة تغيير كبرى.
وقد حدث ذلك في كل ثورة كبيرة، فالثورة الفرنسية التي أسسها المثقفون سرعان ما التهم خيراتها الصناعيون والماليون، وغدت الكتب التي كانت مشاعية وتنويرية، خاضعة للسوق، ولتحكم دور النشر الكبرى، وانقسمت الثقافة إلى ثقافة سوداء خاصة بالجمهور وتعني بالجنس والأبتذال والجريمة الخ ويقرأها الملايين، وثقافة للنخبة غامضة وصعبة، وذات أشكال غير مرتبطة بمعارك العيش، ومغتربة ..
وكما هي قوانين الثقافة والمال، فالثقافة العربية الجديدة في رحلة تغييرها للحياة، لابد أن تعود لتنصهر في معارك الجمهور لتعريب واقعه وتحديثه، فتتوجه للسيطرة على المال العام، لخلق ثورة صناعية علمية، ففيء المسلمين الأول والذي صادرته الأرستقراطية يعود لها الآن عبر السيطرة على القطاع العام، وتوجيهه نحو تطورها المعيشي والثقافي.
الثقافةُ كرأسِ مال
حين إنفصلَ العملُ الفكري عن العمل اليدوي غدتْ الثقافةُ رأسَ مالٍ.
المثقفون في تعبيرِهم عن العمال والحرفيين يضمرون رأسَ مالٍ من خلال هذا التعبير.
فهم يتولون القيادات في الوظائف والمصانع والشركات والأحزاب، فهم يرتفعون على حساب الشغيلة أو يسرقونهم فيما بعد عبر أنظمة رأسمالية الدولة.
ومن هنا فلا يوجد حزب بروليتاري بقيادة مثقفين.
أو دولة إشتراكية بقيادة مثقفين أو برجوازية صغيرة.
هذه الأوهامُ نتاجُ عدمِ معرفةِ المستقبلِ الاشتراكي للإنسانية وكيف يتحقق. فهي كلها أحزابُ برجوازيةٍ صغيرة وما فوقها وما اليها.
حين يقود المثقفون أي دولة أو حزب فهذا يعني أن طبقةً غير العمال هي التي تسّيرُ الدولةَ أو الحزب.
في المستقبلِ حين سيتحولُ العمالُ إلى مثقفين تكون الإشكاليةُ قد رُدمتْ.
وتعني أن تناقضاتَ الوجودِ الاجتماعي في تجسيداتِها الكبرى مثل التناقض بين العمل اليدوي والعمل الفكري، بين الريف والمدينة، بين الثقافة والإنتاج، بين المالكين والأجراء، قد حُلت.
وتكونُ الإنسانيةُ قد وصلتْ إلى مستوياتٍ من الرقي مختلفة كلياً عما نعيشُ فيه.
الحزب البروليتاري بقيادة المثقفين هو حلم أكثر منه واقعا.
والحزب البرجوازي بقيادة مثقفين موظفين ممكن.
هل يقوم أغنياءٌ بالدفاع عن الفقراء وبشكلٍٍ حقيقي مستمر؟! هذه فكرةٌ مثالية نادرة، (رسولية) نابعة من فكر الأديان المثالي. وفي الحياة تتبخر. ولم تستطع الدعوات الدينية مع قداستها الأولى وتضحياتها أن تستمر في العدالة.
لكن يُقال هنا ألا ترى المثقفين يناضلون ويدخلون السجون؟ وهذا أمرٌ صحيح، لكن حين يضحون، ولا يعتبرون الأفكارَ سلعاً، أي لم يُدخلوا في وعيهم أنهم يعيشون مجتمعات رأسمالية تحسبُ المشاعرَ والأفكارَ بالعملة الرخيصة، ولا يزالون في زمنِ الحلم الاشتراكي. أي حين لا يزالون يؤمنون بفكرةِ الإشتراكية الخيالية الراهنة، ويدافعون عن الطبقات الفقيرة بدون مقابل.
ففي العالم الشرقي النامي ليس ثمة ظروفٌ حقيقية للاشتراكية ولكن بعض الناس يناضلون في شروطها المستقبلية التي لم تُوجدْ بعد ويناضلون من أجل طبقات شعبية يشعرون بفقرها وإستغلالها وضرورة تطورها.
لكن علينا أن نقيسَ ذلك بالفترة التاريخية، كم صمد هذا المثقف أو ذاك، كم بقي ينتجُ الفكرَ بشكل تضحوي، ولم يوظفه في تجارة، أو في دسائس سياسية، حينئذ سنجد بعضاً من ذلك، ولكنها نماذج نادرة لا تصلُحُ للقياس العام.
فنحن لا نستطيع أن ندخلَ اللوحاتَ الفنيةَ العبقرية والتماثيل الخالدة والروايات العظيمة في ميزان التجارة. رغم أن الظروفَ الملموسة العابرة تضعُ هذه (السلعَ) في السوق.
ولو كان ذلك الحلمُ واقعياً وممكن التطبيق على العام، فلماذا هذه الخيانات المستمرة من المثقفين ومن تحولاتهم وإنتهازياتهم، وتلاعباتهم بين الطبقات وإستغلال الثقافة للخداع والصعود ثم تشكيلهم بيروقراطيات إستغلالية في الأنظمة التي سُميت إشتراكية أو قومية أو وطنية؟ وها هم يدافعون عن إمتيازاتهم بالمدافع!
الفكرةُ وصناعاتُها وإنتاجُها هي قوةُ عملٍ، وحين يتشكلُ ذلك في مصنعٍ أو إدارةِ مؤسسة، يَخضعُ ذلك للمقاييس الكمية؛ وأهمها طبيعةُ العملِ وتصنيفاته، ويتحددُ الراتبُ أو الأجرُ حسب ذلك مع قياسِ الزمن وكيفية تجديد قوة العمل الفكرية إجتماعياً، حيث أن تجديدَها يتطلبُ مواصفاتٍ غير تلك التي تجري في تجديد قوة العمل اليدوية.
وشقاء المنتجات الفكرية والإبداعية في عالمنا أنها تتشكلُ في سوقٍ غير رأسمالية متطورة.
أما قوةُ العملِ الفكرية حين تَخضعُ للسياسة فهي تخرجُ عن دائرةِ البضاعة العادية، وتدخلُ دائرةَ السلطة.
الثقافةُ السياسيةُ أو الفلسفيةُ أو الاقتصادية أو القانونية حين تدخلُ العملَ السياسي تخضعُ لطبيعةِ الدولةِ المعنية التي تُعلبُ فيها هذه المنتجات، ويحددُ ذلك وضعُ الدولةِ التاريخي، فهل هي ديمقراطيةٌ أم شموليةٌ، أهي على طريقة رأسماليات الشرق الحكومية أم هي ديمقراطية تبادلية للسلطة؟
في رأسمالياتِ الدولِ الشرقية السلعُ الفكريةُ المُسيَّسة تخضعُ لتوجيهاتِ الحكم، ولكيفيةِ صناعتهِ للسيطرة السياسية الاجتماعية، فمثقفٌ يحركُ الرأيَّ العام ويوجهُ الناسَ من خلال جريدة أولى أو تلفزيون، هو غيرُ كاتبِ زاويةٍ مغمور.
في الرأسمالياتِ الديمقراطية تخضع الثقافة إلى السوق وتداولاته، وللشهرة وللقرب أو البعد من قوى السوق العملاقة المؤثرة. فالمثقف يرتفع وينخفض حسب التداول مثله مثل السيارات والثلاجات.
الثقافة والديمقراطية
خرجت الثقافة الحديثة المضادة للتقليدية من المنظمات السرية البحرينية، وكان لهذا الميلاد جوانب إيجابية وسلبية، فقد ربط هذه الثقافة بقضايا الناس وبالصراع السياسي الدائر، ووهج صوتها، وأعطاها زخماً ديمقراطياً، سواء بالانفتاح على الواقع وتاريخه وفلكلوره وبناه التحتية التعبيرية والفكرية المتوارية ، أو بتجاوز الأشكال التعبيرية التقليدية التي كانت تعبرُ عن مواقف متعالية على الجمهور والواقع، فأوجد أشكالاً تعبيرية جديدة غدت مفتوحة على تطورات لاحقة، حسب مدى متابعة دينامكية الواقع والتحولات الفكرية والإبداعية في العالم..
ولا يمكن أخذ العلاقة الجدلية بين الثقافة والواقع، كعلاقة سنوات أو فترة محددة، بل هي تعلو على هذه الانعكاسية المباشرة، ومن هنا فقد كانت الثقافة الإبداعية وهي تنشأ مخلوقة من أصداء بعيدة للحركة الوطنية المحطمة في منتصف الخمسينيات، وقلة هم من عاشوا بشكل واعٍ حركة الهيئة ومطالبها بالديمقراطية، وحين استوت المنظماتُ السرية الوطنية على عرش الحياة، كان صدى حركة الخمسينيات في الأدب الجديد خافتاً، وكان ثمة زخم ثقافي جديد قادم من الدول العربية ومن المعسكر الاشتراكي، وهو كله يكرس ارتباط الثقافة بالصراع السياسي.
وبين الغموض الشديد والوضوح الشديد، وبين التعرية السياسية الحادة وبين الهموم الفردية الخافتة، بين أن يكون الأدب منشوراً وبين أن يكون لعبة، بين أن يكتسب أدواته الخاصة وبين أن يكون تابعاً للسياسة، خاضت الثقافة الجديدة سنوات طويلة من المعارك والمحاولات والتجارب والاستيرادات الخارجية الفظة والتفكير الداخلي العميق، حتى بدت تفرز بعض الوجوه والملامح والنتاجات..
كان الارتباط بالحياة معبراً عن ذلك الهاجس العميق الشعبي المتواري بالصراع ضد الاستبداد في شتى أشكاله، ولم تكن للديمقراطية ملامح سياسية واجتماعية قوية ومحددة، وكان الارتباط الفكري للمنظمات السرية بالحركات والأنظمة (الاشتراكية) يجعل فهم الديمقراطية عسيراً ومضطرباً، فتغدو الديمقراطية متوارية في ظل توجه للثورةِ بأي شكل، والهجوم على الاستغلال الأجنبي والداخلي بطريقةٍ سياسية ساحقة.
من هنا والحركاتُ السرية تعملُ من أجل ديمقراطية غير واضحة المعالم، كانت تكرسُ دكتاتورية كذلك، وكانت تشيعُ مناخاً من أجل الحريات بأدوات الاستبداد، وكانت وهي تؤسس أبنيتها الهرمية، وتخلقُ قواعدَ للتبعية والانضباط والنضال والبيروقراطية السياسية، وتحجيم الفكر..
إن هذه العملية المركبة من التأثير الإيجابي والسلبي، ومن الاستفادة مما هو نضالي وديمقراطي وتجديدي عربي، وبتسربِ ما هو استبدادي وشعارات مسطحة، وهي أمورٌ تتداخل بقوة، وتنسجُ نفسها في الأفكار الأدبية والنتاجات.
ولهذا حين تظهر مؤسسة أدبية تبدأ تلك الجوانب المتعاكسة في البروز، فيظهر استبدادُ جماعةٍ سياسية بأسرة الأدباء، وهو الكيان الثقافي لتلك المنظمات الوطنية السرية، في حين تقاوم هذا الاستبداد منظمة أخرى، توجه الأمورَ نحو إشاعة مناخ تعددي، كما توجه تلك الجماعة الثقافة إلى الربط المباشر بالسياسة وقضاياها وبشعارات منظمتها فتقوم الأخرى بشيء مضاد.
وفي حين إن النتاجات تأخذ مساراً معقداً إلا أن المؤسسات تغدو مكاناً لصراع المنظمات والدول، ويحدث تشابك بين الجانبين وهما النتاج الشخصي ومسار الحركة الثقافية وعلاقاتها بالمؤسسات الكبرى.
يتوجه الأدب إلى تحليل ونقد ركائز الاستبداد في جوانب الحياة المختلفة، ويعتمد ذلك على مدى تطور رؤيته الديمقراطية العميقة المتوارية، ولهذا فإن ارتباط الأدباء والفنانين بمؤسسات استبدادية وتقليدية يعرضهم للتدهور الإبداعي على المستوى البعيد، وقد يأتي هذا على شكل أفكار تبدو مجردة، وقد يأتي على شكل نزعات فنية، وعلى اربتاط إداري، وهي أشياءٌ تتداخل فيها التجربة السياسية والعمل الفني المستقل، والوظيفة والطموحات الشخصية، والتضحية والحياة والموت !
وهكذا أخذت قوى استبدادية قومية وتقليدية بالتدخل الواسع في الحياة الثقافية نفسها وتوظيفها لخدمة تلك الجهات، وكانت عملية محاصرة الثقافة الوطنية الديمقراطية الهشة التي تكونت فيما بعد أوائل الستينيات من القرن الماضي، ذات مظاهر متعددة. فكان إصدار كتاب واحد يعتبر عملية تضحية، فلا سند ولا قراء كثيرون، ومنطقة إصدار هذه الكتب بعيدة، وبالتالي كان دخول هذه الكتب إلى وعي الناس، محدوداً، وإذا كان ذلك أسهل في الشعر حيث يعوض عن خسائره تلك بإقامة الأمسيات، فإن القصة والرواية، تغدو صعوباتها أكبر وأفدح.
ومع ذلك فإن النوعَ القصصي ثابر على التطور، بسبب أن مواجهاته مع الواقع كانت أكبر ومستمرة ومتصاعدة، سواء من النوع القصصي القصير إلى الرواية.. لكن الصعوبات كانت موضوعية، فحركة أدبية وفنية ذات عمر قصير، في بلد صغير، ومحاصَّرة، وبعيدة عن مراكز الإنتاج والسوق العربية.. كان لا يمكن ألا أن تكون في وضع صعب.
والحركة الفنية تغدو مشكلاتها أكبر هنا فهي مرتبطة بمعارض، مشمولة برعاية رسمية، وبأمكنة فندقية بارزة، فغدت أما جزءً من السياحة، أو من الفلكلور السياسي الاحتفالي، فتم أحتواؤها، وتوجيهها أما لالتقاط فوتغرافي مباشر من الواقع، وأما لغموض شكلاني فعجزت عن التعبير العميق عن الواقع والإنسان.
ومن هنا عجزت المعارضة عن الدخول الهام إلى الحياة التشكيلية، في حين كان المسرح واعداً، وظهر من قلب حركة المعارضة في الخمسينيات عبر الأندية، ودخل في لعبة المغامرة السياسية والفنية في أوائل السبعينيات، بالتصدي النقدي لقضايا الفقر والسلطة والسياسة بأشكال حادة، لكن كانت هذه مراهقة الشباب، فسرعان ما راح يتسربُ إلى موضوعات تقليدية، كقضايا الأسر، والزواج مثل المسرحية التي صورت كيف أن الشاري كان يريد شراء بقرة لا خطبة الأبنة كما ظن الأهل! أو راح المسرح يعلجُ قضايا الغوص، ويجسد الأمثال الشعبية البائتة، ثم ظهر مسرحُ الخريجين فجدد في الحياة المسرحية بموضوعاته وقضاياه، ولكن القبضة الدكتاتورية وصلت إلى عنقه فتوجه إلى عروضٍ غامضة، وانسحب من العلاقة مع الجمهور، ثم انفصم بشكلٍ كبير عبر التجريب، وكان البعضُ يريدُ تحويلَ التجريب إلى طاقةٍ نقدية جديدة فتم ذلك بشكل نادر، لكن كانت المسألة المحورية غائبة وهي علاقة هذا المسرح بالديمقراطية وقضايا الجمهور . .
لكن نستطيع أن نقول مع ذلك إن بعض جوانب الأدب كانت تزدهر في السجون، فكان بعضُ الشعر والقص يمر في مرحلة إعادة نظر للعلاقة المباشرة التسطيحية بين الأدب والواقع، ويجدد على ضوء تجارب الحياة وانجازات الصمود وانهيارات السياسة، لكنه مثل هذا الأدب لم يدرسْ بعد العلاقة العميقة بين الديمقراطية والإبداع ويكرسها بشكل واسع راهن وقادم..
وفي الصفحات الثقافية وبتجمعات المعارضة الأدبية راحت أقلامٌ عدة تقومُ بتحليل مختلف قضايا الأدب والفن، فجرى في الصفحات واللقاءات مناقشة التجارب الضعيفة المنعزلة الأدبية والفنية عن زخم الواقع، وانفجرت حوارات ومجابهات حول عروض مسرحية ومعارض وحول ثقافة تعيش حالة من الاحتضار، لكن هذه المجابهات النقدية والكتابات النقدية لم تستطع شفاء ثقافة مريضة متجهة للموت شيئاً فشيئاً.
وإذا كانت بعض التجارب الفردية قد نجت من طوفان التلوث، نتيجة أصرارها على إنتاج مستقل، لكنها لم تستطع أن تخلق حركة ثقافية كما ظنت في البداية، لأن ارتباطها بدكتاتوريات المنطقة كان عائقاً كبيراً في تشكل هذه الحركة، فهذه الدكتاتوريات خربت الثقافة السياسية والأدبية كذلك.
إن تخريب الدكتاتوريات للثقافة كان يعود في جزءٍ منه إلى النظام العراقي السابق. ولقد تشكلت علاقة الثقافة البحرينية بالنظام العراقي عبر عمليات النشر في البداية ثم اتسعت إلى المشاركة في المؤتمرات الأدبية والمهرجانات التي كان النظامُ السابق يغدقُ عليها بكرم حاتمي.
ونظراً لأن النظام العراقي كان يوظف هذه الفعاليات من أجل التوسع السياسي، ومد نفوذه في منظمات ودول المنطقة فقد وظف العديدُ من المثقفين والأدباء والفنانين من أجل هذا التأييد والتفعيل لدوره.
والارتباط بالنظام العراقي بحدِ ذاته يمثل عملية انهيار للوعي الديمقراطي، ليس فقط بالخضوع لإغراءاته المالية التي كانت حركتان سياسية وثقافية معوزتين بحاجة إليها، بل لكونهما فقدتا ملامح الوعي الديمقراطي ولم تؤسساه في ذاتيهما، فكان التاريخ السابق يخلو من هذا التبلور الديمقراطي على مستوى إنتاجِ وعيٍّ فيه، وعلى مستوى تشكيل رموز مجسدة له. كانت القطيعة مطلوبة مع النظام العراقي، أو العلاقة النقدية على الأقل، وبغياب ذلك فإن الحركة الثقافية توجهت للسقوط في مستنقع كبير.
إن هذا السقوط كان علامة كبيرة على التردي الفكري والأخلاقي، وكانت نتائجه فظيعة على مستوى تقزم الحركة الأدبية وتشتتها، وفقدانها للقيم المضيئة السابقة، وتدهور إنتاج الكثيرين فيها، لأنه بدلاً من تجذير قيم الديمقراطية الموعودة غدا تكريس أسوأ قيم الاستبداد، فكان اهتراؤها متمثلاً في تضخم فرداني، وبتحجر النقد، وبعدم مقاومة الشموليات بمختلف ضروبها.
هذا ما كان مغذياً للجماعات الطائفية فيما بعد والتي كانت تنمو في رحم المجتمع، فقد كان نضوب المضمون الديمقراطي العميق للحركة الثقافية؛ اتصالاً بالناس، وتعميقاً للنقد وتكريساً للعقلانية، قد جمد الحركتان السياسية والثقافية الوطنيتان، وأضعف من دورهما، إضافة إلى الظروف الخارجية القاسية ضدهما، فجاءت الجماعات الطائفية كوريثٍ لمختلفِ الجوانب السلبية.
لكن بدلاً من الارتباط بالنظام العراقي السابق حدث ارتباط بأنظمة استبدادية جديدة لا تقل قهراً وهي أشد تخلفاً، فتم وراثة السلبيات دون الإيجابيات، فازداد تدهور الثقافة، ولم تستطع الحداثة الشكلانية الغربية المستوردة أن تعوض عن مثل هذا الفقر الفكري، لأنها خالية من المضمون النقدي والتحليلي للواقع، وغدت مجرد انتهازية وزئبق ثقافي قابل للتمدد في مختلف الجهات السلبية.
لكن الجماعات الطائفية كان لها ضررها على الثقافة الوطنية الحديثة من جوانب أخرى، فقد تحولت إلى قامع للثقافة العصرية بدلاً من أجهزة الدولة السابقة، التي تبعاً لذلك غيرت من مواقفها تجاه الثقافة فأدركت مضمونها الوطني، بخلاف الجماعات المذهبية التي وجهت الجمهور نحو أنماط تقليدية من الثقافة، ولهذا نجد الوعي الشبابي يعود إلى أنماط أدبية تجاوزها الزمن، وإلى استخدام الموروث المذهبي..
وإضافة إلى عواملٍ أخرى ساهم صعودُ الحركات المذهبية السياسية في تجفيف منابع الثقافة، وتقليص جمهورها الحديث، وضعف الفنون الحديثة.
إن احلال ثقافة مذهبية هو مؤشر للتبعية لأنظمة الاستبداد في المنطقة، ولفشل مشروع الثقافة البحرينية الوطنية في تجذير نفسه داخل واقعه، وهو أمر ينعكس في كافة أشكال الثقافة من أدب وفن إلى تعليم الخ..
هناك جوانب مضادة لثقافة التبعية هذه، تتمثل في صمود التجارب الإبداعية الفردية الكبيرة، وفي تعزز أنواع أدبية معينة، وتنامي دور الكتابة السياسية الوطنية، وظهور عمليات مراجعة للفترة السابقة..
لكن تشكيل ثقافة جديدة ديمقراطية يحتاج إلى استعادة القوى الاجتماعية المحلية دورها، وإعادة إنتاج وعيها المحدود والمرتبط بالشموليات، عبر الإضافة إلى ما تم إنجازه من موروث ديمقراطي وطني سابق، وهو أمر يحتاج إلى دراسات في هذا المجال، وصدور أرشيف واسع للكتابات الجيدة في صحافة البحرين على مدى نصف قرن، وقراءة النتاجات الأدبية والفنية التي تاهت في تلك الصحافة أو في المكتبات.
الثقافة والصراع السياسي
مع تفاقم العملية السياسية المفتوحة على اتجاهات متعددة، فإن الثقافة لا بد أن تدخل في هذه العملية السياسية، من خلال ما تشكلت عليه خلال العقود الماضية، فالاتجاهات المذهبية المحافظة استمرت في نشر ثقافتها التقليدية، دون تطور يذكر، أي أن العملية التحولية السياسية لم تحرك مياهَها التحتية الراكدة باتجاه أسئلة الحداثة والتغيير الوطني.
كذلك فإن الثقافة الشكلانية والذاتية التي تشكلت داخل أجواء المصالح والبيروقراطية، استمرت في حداثتها المقطوعة عن معارك التغيير المحلية، غير قادرة على أن تستوعب مشكلات الناس داخل أبنيتها، فتشكل مساران ديني محافظ، وتجديدي شكلاني ذاتي.
فتجد أن صحيفة محافظة مذهبية تساند بقوة ظاهرة ثقافية شكلانية، ليس لشيء سوى لعوامل ذاتية لا علاقة لها بتحليل تلك الظاهرة الثقافية وكشف جوانبها المختلفة.
أو على العكس حين تظهر ثقافة ديمقراطية داخل التراث الإسلامي، فإن المحافظين والشكلانيين على حد سواء، لا يظهرون أي حماسة لمثل هذه الظاهرة، لأن مثل هذه الظاهرة تشكل تعرية من جانبين، تعري المحافظين وتخليهم عن الثقافة الديمقراطية الإسلامية، وانضمامهم للأجهزة، وتعري الشكلانيين التحديثيين وعدم تجذرهم في ثقافتهم العربية الإسلامية وعدم اتخاذ مواقف نضالية في مجتمعاتهم.
وهم إذ يفرغون الثقافة من أبعادها الموضوعية يريدون تحويلها إلى أداة في مشروعاتهم السياسية المتخلفة، مرة بعدم قراءة ضرورات الحرية في التعبير الثقافي المستقل، ومرة أخرى بتجاهل أهمية الاستقلال الثقافي وضرورة فصل الفكر عن التكيتكات السياسية المحدودة والهزيلة.
كذلك تعبر عن شكلانية مشتركة فمسائل الميزانية والصرف الباذخ على أعمال بهذا الشكل المحدود، وتضييع وقت المؤسسات المنتخبة في صراعات جانبية، كلها لا تسترعي الانتباه، بل تسترعي انتباهها جوانب الشكل الخارجي، فما دام يوجد رقص فهذه حداثة، ومادام يوجد رقص فهذا انحلال. رؤيتان متنضادتان متحدتان في العمق.
وهذه جوانب تعبر عن ارتباط التيارات السياسية بأجهزة حكومية متنفذة، أو بمؤسسات دينية متدخلة تريد فرض هيمنة شمولية على المجتمع وعدم قدرتها على تشكيل صوت ديمقراطي وطني مشترك.
إنها لا تستوعب عملية طرح ثقافة ديمقراطية وطنية إسلامية خارج الطوائف فهي مشدودة إلى ثقافتها التقليدية، وتعتبر أن التطرق ذاك لا بد أن يكون عبر رؤاها الطائفية، وإلا كان مروقاً.
إن التحاق المثقفيين الدينيين أو التحديثيين الشكلانيين بالأجهزة المحافظة، يقود إلى شكلنة الثقافة، أي جعلها أشكال، خارجية، وشعارات برانية، ويتحول المثقفون الدينيون والتحديثيون إلى موظفين، ويشتغلون كلٌ من جهته على عدم تحويل الثقافة إلى موقف نضال وطني مشترك يغير الواقع.
لقد ضعفت الثقافة الوطينة الديمقراطية خلال العقود الماضية ولم تتسلح بتحليل الواقع، وباتخاذ مواقف نقدية عميقة منه، فغدت هشة يسودها الطابع الذاتي، فهي استيرادية غربية أو استيرادية نصوصية تراثية جامدة، وهما وجها العملة التابعة.
إعادة تشكيل الثقافة الوطنية الديمقراطية مسألة طويلة، تتطلب انفضاض المثقفين عن القوى الشمولية المختلفة، ومراعاتهم للصدق والمسئولية والحرية والنقد للواقع، دون أن يأبهوا بالقوى الخارجية وبالمكاسب المادية.
الدكتاتورية في الثقافة
حاولت الثقافة الوطنية أن تتصدى للبناء الاجتماعي المختلف المتكلس بالعديد من الأفكار الديمقراطية، لكنها كانت هي ذاتها نتاج ذلك البناء المتكلس.
إن ظهور الشخصيات المتضخمة المهيمنة هو نتاجُ هياكلٍ اجتماعية وسياسية متخلفة، وليس هو فعل فردي محض فقط، ومن هنا كان نضال الثقافة الوطنية الديمقراطية هو نضالٌ داخل صفوفها، التي تعكسُ الكثير من المؤثرات العامة، وهو أمرٌ تجسد في الكثير من الصراعات الثقافية والأدبية لجعل الجدل مع الواقع يلغي الدوران حول الشخوص، وتكون أهمية النصوص لا بسبب منتجيها بل بقدر ما يقترب المنتجون من نقد الواقع ويشكلون حراكاً تحولياً فيه.
ومن هنا عانت هذه الثقافة من هذه الشخصية الفردانية ومن الهجمات البيروقراطية الإدارية ضدها، وهي الهجمات التي تسببت في عرقلة تطور الفنون العامة كالتشكيل والمسرح والدراما التلفزيونية التي خضعت لتلك الشمولية بسبب من كونها فنوناً جماعية تخضع للرقابة بخلاف القصيدة والقصة والرواية التي لها حراكٌ لا يمكن ضبطه والسيطرة عليه!
ومن هنا كانت بذور الديمقراطية في التجمع الأدبي أكثر وأخصب، وقد تطورت هذه البذور من أجل جعل الثقافة تحترم التنوع داخلها، بعد أن جف ضرع الثقافة انفصالاً عن الواقع واهتماماً بالذوات الفردانية في طيرانها للرحيق المادي والعلو.
لكن ذلك لم يكن نفس مسار الإعلام الرسمي وخاصة الإعلام المتخصص في مراقبة الثقافة، والذي عكف على تحنيط وتجفيف منابع نمو الثقافة الوطنية الديمقراطية حتى كان له ذلك مع تضافر الجهود السياسية العامة، فأنتج ظاهرة (الثقافة) الطائفية بكل فسيفسائها.
ولم تكن محاولات الثقافة الإعلامية الرسمية في تجاوز هذا الواقع المتردي، ورفع بعض الشعارات الليبرالية، وتحريك بعض النتاج الثقافي، إلا محاولات تستندُ على جهود فردية مختلفة ومتضاربة، وعبر أشكال نخبوية، واستعراضية، وبإهدار في ميزانية تتجه للتظاهر أكثر ما تحفل بالعمق والناس.
حتى تصاعدت العناصر الذاتية في هذه البنية الرسمية الثقافية التي لا تصب كثيراً في الواقع المحلي، فهي لا تتوجه إلى تطوير العناصر الوطنية الديمقراطية في هذه الثقافة بل تلجأ للاستعراضات والاهتمام بالنجوم المستوردة، أما أن يُنتَج شيءٌ داخلي مؤثر فهو ليس من اهتامها، خاصة إن العناصر التي تشكلُ هذا الواقعَ لم تأتِ من نتاج مهم في الثقافة المحلية، ولم تكابد عناء النصوص واللغة والأفكار، بل جعلت حلبة الثقافة ميدان استعراض وتضخم فرداني، وبهذا يتحول كل ذلك إلى هدر إن لم يكن إلى مشكلات وصراعات حادة، لأن مثل هذا الوعي لم يكن تتويجاً لتطور ثقافي شخصي أو عام، وهي نفسها النجومية التي عرقلت تطور المؤسسات الثقافية الأهلية، كما أنه لم يكن بهدف تغيير شيء سلبي داخل الواقع.
ولهذا فهو نتاج أعمال شخصية تتشكل بطريقة غير ديمقراطية، وبصورة ذاتية، ولا تقيم حواراً مع الزخم الثقافي المتنوع الذي تكون على مدى العقود السابقة.
وهي أمور تشاركها فيه بعضُ المؤسسات الثقافية والسياسية التي ترى في تحجيم دورها وتقليص شخوصها أسباباً إضافية في الصراع معه والتصدي له.
إن الإدارة الثقافية العامة تحتاج لشخصية قيادية منفتحة وديمقراطية، ترى البذورَ الوطنية العقلانية في النتاج الثقافي وفي المؤسسات الأهلية، وتقوم بالحوار معها، وتساعدها على الظهور وزيادة الإنتاج، ومن مواقع التعاون فيما هو مشترك بين الحكومي والأهلي، تاركة لها مساحات الحرية والاختلاف.
إن غياب الشخصية القيادية الثقافية من هذا الموقع القيادي هو العامل الهام في الصراعات المجانية التي تشهدها الساحة الثقافية، وفي تضييع الوقت والمال على المهرجانات والدعوات المحدودة القيمة، وترك ما أهلي يعيش البوار والأهمال!
المنبتون من الثقافة الوطنية
واجهتْ الثقافة الوطنية الديمقراطية تحدياتٌ كثيرة في سبيلِ تشكيل نفسِها، وزرعِ وجودِهِا في الأرض، لهشاشةِ الجذور الثقافية لها، وعدم ترسخ الأنواع الأدبية والفنية، وقد تنامت بذورُهُا مع تنامي الحركة الوطنية الديمقراطية، أي بقدرِ ما تتخلص الحركات السياسية من جمودها وشموليتها، وبقدر ما يقدر المبدعون على تحليل العلاقات الاجتماعية التقليدية ونقدها وتجاوزها.
وقد تنامت الرؤى الشمولية في هذه الثقافة عوضاً عن ضعفها وزوالها، بسببِ تحكم المؤسساتِ العامة البيروقراطية في مصائر الثقافة، وخلخة تماسك المبدعين وحفرهم في الواقع ونقده، وهو الشرط الضروري في تنامي أي إبداع.
وكل هذه المؤثرات لعبت أدوارها في زعزعة الثقافة الوطنية وتقزمها، وتنامي دوران الكتاب والفنانين والمثقفين حول ذواتِهم ينسجون شرانقَ من وهم، ويكرسون أنفسهم وقد انعزلت عن عمليات تحليل الواقع ونقده، سواء عبر عوداتهم لوعي الطوائف وأندماجهم في مشروعاتها السياسية التفكيكية، ومزايداتهم على هذا الوعي أحياناً، عوضاً أن يتغلغلوا إلى نواته الوطنية ويبرزوها وينقدوا تجلياتها الطائفية ويخلقوا التلاحم بين الجمهور.
أو جعلهم ذواتهم هي البؤرُ الوحيدة في الكون الثقافي، فلم يعدْ ثمة وطنٌ ولا جبهاتٌ ثقافية يمكن أن تكرس شيئاً من الوعي الديمقراطي الحقيقي في الجمهور، فجربوا حتى ضاعوا، وانعزلوا عن القراءة وتطوير أدواتهم، أو راحوا يكررون ذواتهم الجامدة بصور شتى، حتى فقدتْ التجاربُ التي يقومون بها أهميتها ودورها، ولم يعد ثمة فارق بين مبدع كرس نفسه لعقود وبين ناشيء، بل قدرَ الناشىءُ أن يبز المعتق عبر أساليب هزيلة وإدعاءت بخلق فن جماهيري وما هو بجماهيري بل تخديري، يعتمد التسلية الفجة.
وهناك مظاهر شتى لذلك فكلها تعبيرٌ عن خلخلة وعي فئات وجدتْ إن مصالحَها هي كلُ شيء، ورنتْ إلى كراسيها وأرصدتها، وباعتْ تاريخاً، وتخلتْ عن تقنياتٍ وأدوات توصيل وحولتْ المنابر الفنية والأدبية إلى تكريس لشخوص وشلل وليس لمراكمة وعي ديمقراطي ثقافي يعيد بناء الثقافة الوطنية الخربة.
وتتشكلُ معطياتٌ جديدة لتجاوز ذلك عبر الدفاع عن مصالح الفنانين والكتاب ومؤسساتهم ونتاجاتهم، وتغيير هذا المستوى المتدني لظروف إنتاجهم الثقافية والشخصية، بشكلٍ جماعي وليس بأشكالٍ فردية، بحيث يتم تغيير جوانب هامة من الوضع الثقافي كدعم مغاير لهذا الدعم الهزيل الراهن، بحيث يزيل دور مؤسسات الثقافة المتسولة، ويضع قانوناً للتفرغ وليس لشراء بعض المبدعين، ويقيم مسارح ومكتبات وثقافة منوعة كبيرة للطفولة، ويحرر التلفزيون من سطوة الشلل، ويجعل للفنانين والأدباء ضماناً اجتماعياً مواكباً لدورهم الوطني، ولا يجعل من المثقفين منبوذين في أرضهم محتفى بغيرهم من كل الأصقاع!
وأن لا يأتي ذلك عبر التسول كذلك بل عبر استخدام الأدوات النضالية المتوفرة من مجالس منتخبة ونقابات، وإذا حدث أن لم تستجب الدوائر البيروقراطية لهذا وفضلت العمل عبر الشلل وتكريس المثقف المهرج والشاعر الشحاذ، والفنان المتعطل من الموهبة، فلتتواصل اللجان المشتركة للمثقفين، وتحفر في الواقع سواء عبر تعضيدها لنواب ديمقراطيين، أو بتصعيد نتاجها وتغيير طابعه الانعزالي غير المفيد وتتعلم مرة أخرى كيف تتكلم مع الناس.
الفئات الوسطى بين الثقافة والسياسة
بدأت البحرين والكويت وغيرهما من دول الخليج بقيادة الفئات الوسطى التجارية الثقافية بقيادة حركة التغيير والتحرر الوطني في المنطقة، للأسباب المماثلة التي حركت الفئات الوسطى العربية، فلم يؤسس الاستعمار البريطاني أجهزة دولة إقتصادية تمنع التجار من الحراك الواسع، بل ركز على تغييب النشاط السياسي، وعدم وجود أسلحة ومنع الرقيق، ومنع السخرة في الزراعة، وهذه الجوانب ساعدتْ على صعود الفئات التجارية وحراكها الذي بدأ فكرياً عبر الأندية والتجمعات الثقافية وصار سياسياً.
هذه العقود أعطت الفئات الوسطى التجارية أفضل نتاجاتها الفكرية والسياسية، لكن لغياب الجذور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية العريقة أصيبت الحركات بالمراهقة، وهو أمرٌ لم يقتصر على مدن الخليج الصغيرة بل تعداها إلى البلدان العربية الكبيرة، فإن هذه الموجة الليبرالية العربية التي تشكلتْ في ظل الاستعمار الغربي لم تدم طويلاً، وما لبثت القوى الوطنية التحررية ذات النزعات الشمولية أن تصاعدت، وفي البحرين كان الأمر شبه كارثي في 1956.
انسحب قادة التجار بعد هزيمة الحركة الوطنية في الخمسينيات، وكان أولئك القادة قد انغمسوا في الحركة القومية ذات النزعة الشمولية، والتي لم تتضافر مع التوجهات الليبرالية إلا في مسالك شخصية، مما جعلها حادة عنيفة، غير قادرةٍ على خلقِ تراكم ديمقراطي لا في الثقافة ولا في السياسة.
كان هؤلاء القادة قد جاءوا من الفئات الدنيا من التجار، ولم يظهروا من البيوتات التجارية القديمة، وكان هذا تعبيراً عن سيادة نزعة المغامرة في التجارة والسياسة، فهذه الجذورُ غيرُ القويةِ في الاقتصاد والتي لم تكون ثرواتٍ كبيرة، وجاء دخولـُها للعمل التجاري سريعاً، لم يتحْ لها الزمنُ أن تتجذرَ في فهمِ الليبرالية والديمقراطية على مختلفِ أصعدها، وركبتْ الحماسَ الشعبي الذي أخذها بدوره إلى ما لا تريده، إلى الفلتان السياسي.
ولهذا فقد سادت البيوت التجارية الغارقة في الهموم الاقتصادية المنفصلة كلياً عن السياسة والثقافة، وهو أمرٌ أدى إلى التصحر الفكري وغياب المواقف الاجتماعية والوطنية.
بطبيعة الحال فإن تسربات الصراع الوطني كانت تتسلل من تحت المجاري الخلفية، عبر بعض الأبناء الذين يدخلوا التيارات السياسية المختلفة.
ومهما كانت طبيعة الحركات السياسية التي تتالت بعد ذلك فقد كانت في ذات المناخ الشمولي سواء في القومية أو اليسار، ولم تظهر إمكانيات وقدرات تراكم تجربة ديمقراطية، وهذا قد عبر إلى أي مدى كان رأس المال ضعيفاً، تابعاً للأجهزة، خائفاً منها، ذائباً فيها، منكمشاً عنها، واعتبر بعضه إن وجود الاستعمار ضرورة حيوية، وذهب بعضهم لمعارضة الانسحاب البريطاني من المنطقة.
لقد ساهمت الأجهزة والاتجاهات الشمولية في تشكيل مناخ التصحر السياسي هذا، وزاد الأمرُ سؤاً عندما لم تقدمْ الدولُ العربية بديلاً ديمقراطياً، وحين اقتربتْ نارُها من الخليج شكلتْ نظامين استدعيا القوى الغربية الحربية تحت يافطات شتى وإدعاءات مختلفة قائمة على الهياجين القومي والديني.
وإذا كانت الثروة النفطية قد استدعت تحشد القوى الغربية ونفوذ أجهزتها، فإنها كذلك أعطت لرأس المال المحلي قفزات في وضع التجارة والصناعة والبنوك، وغدا التصحرُ السياسي للتجار مركباً على غيابِ الأفكارِ الوطنية المتجذرة في الأرض، التي صارتْ مجردَ حصالات، لا يُعرف ما وراء وجودها الحديدي من مشكلاتٍ عميقةٍ ومن تضاريسَ سياسيةٍ معقدةٍ متضاربة، وهذا توافقَ مع النزعةِ الأمريكية السائدة بتحرير الاقتصاديات من هيمنة الدول، من أجل تدفق سيولتها عليها، فتبخرت الوطنيات أكثر من السابق.
تكسير النزعة الوطنية له جذورٌ في تربةِ الجزيرة العربية ودولها المتفتتة، القائمة على تاريخ الترحال والظعن وحب الموارد، ومن هنا يقيم كبار التجار فللاً متجمعة أشبه بالمضارب البدوية السابقة، ولها شيخ القبيلة، وبخلاف القبائل العربية فهذه القبائل منقطعة عن محيطها، معتمدة على قوى العمل الأجنبية، تقوم بطرد اللغة العربية من أجوائها وأجيالها بشكل مستمر، فتغدو جزءً من العولمة الغربية الحديثة، في أشكالها الخارجية المبهرة وغياب مضامينها الثقافية والفكرية العميقة.
ولكن هذه المضارب البدوية التجارية ليس لها حتى مجلس منتخب أو قدرة على الحوارات وفهم التاريخ والمستقبل.
وإذا كانت السياسة هي قمة مواقف الإنسان وحضوره في الحياة، فإن السياسة آخر شيء يُشتغل به في هذه المضارب المرفهة.
إن التاجر العادي الكبير عادة هو كائن غير سياسي. كل وجود يتركز في هذا رأس المال وتناميه، وهو رأس مال منقطع عن جذوره وصلاته الاجتماعية، متوحدٌ في الفواتير ونتائجها، مجردُ كمٍ نقدي يجب أن يتنامى بشكل مستمر، ربحه هو وجوده ووطنه.
ومن هنا فإن التاجر الكبير السياسي نادر، وإذا ظهر فهو مع السائد، رغم إنه يفهم السائد بطريقته الخاصة، وبما ينمي التجارة الخاصة.
لكن كيف تحول فجأة هذا التاجر غير السياسي، غير الوطني، إلى رجل مهتم بالسياسة ومعارض؟
تشكلت الخريطة العامة للرأسمالية المتنامية من جانبِ الرأسمالية الحكومية المسيطرة على الموارد الاقتصادية ومن الرأسمالية الخاصة المسيطرة على السوق التجارية، وإذا كان رأسمالُ الخاص غير سياسي، فإن رأس المال الحكومي سياسي تماماً.
ونظراً لسيطرة رأس المال الحكومي وتشكله بسرعة كبيرة حيث وصل إلى إدارة موحدة في شركة، وتنامت فوائضه مشكلة البيروقراطية وذيولها المختلفة الكبيرة المتنامية في التجارة، فإنه ذو اهتمام كبير بالتطورات السياسية والاجتماعية وعدم وصولها لتناقضات حادة، وينبثق لديه برنامج خاص للإصلاحين السياسي والاقتصادي متضافرين برؤية معينة تنطلق من المفهوم الأبوي وغير الحر للاقتصاد. وبالتالي فإنه يحاول توجيه الرساميل نحو تخفيف تلك التناقضات الاجتماعية ضمن إدارته التي هي ذاتها قضية عليها أسئلة كبيرة.
وحين ظهر منديلُ الأمان وصار بإمكان التاجر الصامت أن يتكلم فإنه انطلق من تاريخه الخاص المنزوي، غير السياسي، المهتم بالأرباح فقط، ووجد الوزارات تفرض التغييرات من مواقعها السياسية غير مراعية لأوضاعه، في حين أنها تتوجه لتخفيف التناقضات الاجتماعية، لكن بحيث يتحمل التاجر تكلفة التخفيف و(الإصلاح)!
وأدى صمت التاجر وإنعزاله إلى أنه لا توجد لديه أدوات تأثير وضغط على هذه الإجراءات، وإذا كان قد ربح من صمتهِ فإنه الآن يخسر من ذلك الصمت الطويل، ولعدم تكوين جماعات الضغط الخاصة به، وما كان مفيداً صار مضراً، فطلع على الناس وهو في حيرة يتخبط هنا وهناك، وتقيم الفئات الدنيا فيه تحركات وإحتجاحات لا يهتم بها أحد، وغير مرتبطة بجمعيات وتيارات ذات شأن في المجتمع، نظراً للانعزال عن التيارات وعدم المساهمة فيها، والتقاط فرص العلو للمكاسب الاقتصادية والسياسية بدون إنتاج عميق، ولعدم تشكيل كوادر مدافعة عن عالم التجارة الخاصة وحرية السوق، وإذا دخل بعض هؤلاء عالم السياسة فهو من الباب الحكومي كمجلس الشورى، أو المقاعد السياسية الأخرى.
وعموماً فإن الضعف السياسي للقطاعات الخاصة التجارية والصناعية والمالية هو ظاهرة عامة في دول الشرق، فهي تخلت بنفسها عن السياسة، وحلت تنظيماتها وغرقت في عالم المال المعزول، بحيث إن أي (ملا) في حارة لديه اتباع أكثر من كل مؤسساتها الاقتصادية، وقادر على التأثير في السوق بالمظاهرات أو باعتماد العنف ليكون زعيماً، ولهذا فإن عودة التاجر للوطن من الباب السياسي، تحتاج للكثير من التحولات وإعادة التفكير وتشكيل المؤسسات الاقتصادية بشكل مؤثر وطنياً.
الطائفيةُ وتدهورُ الثقافةِ
هناك علاقاتٌ خفيةٌ بين تفاقم الطائفية وتدهور الثقافة، فقد صعدت فئاتٌ وسطى صغيرة خاصة من البوادي والأرياف والحارات المكتظة، وكانت تتواكبُ مع أزمات إقتصادية في النمط الخراجي الجديد، حيث الأجهزة تنفصل عن الناس، والفئات الوسطى الكبيرة تبحث عن الأسواق بأي شكل في وسط مزاحمات من العمالقة السياسيين الاقتصاديين.
القوى اليسارية والقومية القديمة تفككتْ علاقاتُها بالثقافات العميقة، وكانت أدواتُ التسطيحِ والأدلجة الموظفة للشموليات غيرَ قادرةٍ على الحفر المعرفي الثقافي، ولهذا فإن مواكبتها للأدب والفن التقدميين إضمحلت. ومن هنا عدم قدرتها على التصدي لفهم ظاهرات إبداعية كبيرة، وحماية المراكز الثقافية التقدمية المتداعية في المجلات والصحف ودور النشر والمواقع الإلكترونية، رغم أن عناصر نادرة في الاتجاهات التحديثية واصلت الإنتاج وسط طوفان من الأمية الثقافية ونتاجات العولمة. ودعك من إمكانية أن تقوم هذه المنابر بالتحول لمحطاتٍ ناقلة للكهرباء الثقافية وسط الجماهير، عبر الاحتفاء بالكتب والآداب والفنون والظاهرات الثقافية عامةً كما كانت تفعل في زمن جذورها النضالية التي كانت ذات ظروف شظف وحصار وقلة إمكانيات!
في تحللِ رأسمالياتِ الدول الشرقية تحللٌ للخرائطِ الوطنية، وجسدَ هذا فشللَ نمطٍ بيروقراطي إستغلالي أدى إلى بروزِ الثقافات العتيقة للمذاهب والملل المختلفة تفكيكاً لأقطار ومجتمعات المسلمين والمواطنين عامة، حيث راحت تجرُّ التفسخات التي جرتْ بعد إنهيار الحضارات العربية الإسلامية المختلفة وليس أن تعي ماهية تلك الثقافات العالمية وقتذاك. أي أدى هذا إلى سيادةِ النصوصية والمواد اللاعقلانية والقشورية الدينية والعودة لأزمنة ما سُمي عربياً بعصور الانحطاط. ولن تجد من كتاب المذهبيين السياسيين من يقوم بالحفر المعرفي ولو كان بسيطاً في ظاهرات الحياة والثقافة والتاريخ، بل يكرر ما هو موجود من نصوص يعرفها الجميعُ عن السور والدين والمواعظ.
وقد حدثَ تصدٍّ من بعضِ كبار المثقفين العرب للتفسخ الطائفي الاجتماعي ومحاولاته تصدر المسرح السياسي الاجتماعي، عبر قراءاتٍ كثيرة موسوعية للآداب والفنون والفلسفات القديمة، لكن أغلبها ضخم الحجم ويُصاغ بأدواتٍ منهجية ولغوية فوق مستوى الجمهور العادي، كما أنه لا يحتفي بهذه الجهود في أجهزة الإعلام لمنع التسطيح في فهم التاريخ العربي.
مثلما أن أنظمة الرأسمالية الحكومية لم تقم بأي ثورة ثقافية لمحو الأمية ولتقدم العلاقات بين النساء والرجال ونشر العقلانية والعديد من المهمات الاجتماعية الثقافية، كما أن هذه القراءات العقلانية لا تُسوق عبر أدواتِ الرأسمالياتِ الحكومية المتحللة الراهنة، ولا تحصل على دعم الرأسماليات الخاصة المتصاعدة التي توجهتْ لمطبوعات الربح وفضائيات البث التجاري الساحق ونشر الثقافة السوداء كثقافةِ العنف والجنس والفن الرخيص. وصارت تفاهات هذه(النجوم) مواداً يومية تُنشر في كل مكان ونموذجاً لإحتذاء الأجيال، وترافق ذلك مع نشر السموم والعداء للثقافة والكتب وحصار المكتبات!
ولهذا فإن أميي الثقافاتِ الدينية هم الذين تولوا البثَ الجماهيري، حيث ظهرت هذه الفئاتُ من شقوقِ فسادِ الرأسماليات الأولى، وإحتضان الرأسماليات الخاصة الأخرى، وهي تدبجُ النصوصَ المتعالية من فوق المنابر الشعبية، وقراءاتُها لحقائق التراث العربي الإسلامي الإنساني معدومة، فهي قراءةُ طوائف تمزيقية لا قراءةَ موحِّدين، قراءاتُ يومية وعظية تحريضية ذاتية في شتى الجهات، وتشيعُ الانقسامات والتسطيحَ الفكري أكثر فأكثر. والغريب أن شباب هذه الجماعات لا علاقة لهم بالثقافة العربية الإسلامية وتجد هذا في عدم معرفة الجذور للإسلام والفرق ومشكلات التطور التاريخي للأمم الإسلامية ولا يعرفون الآداب العربية الإسلامية وغزارة إنتاجها بكل تأكيد.
لهذا فإن العلاقات الكبرى العظيمة التي نشأت بين الإسلام والاتجاهات الفكرية السياسية وبين الآداب والفنون، مقطوعةٌ هنا، منسوفةٌ، في ظل أناسٍ يعيشون على المواد الخام الرثة للانهيارات الاجتماعية السابقة، ومن هنا نجد هذا الانفصال العدائي عن الآداب والفنون، فالطائفياتُ مسطحةٌ، أميةٌ، متحفزة، قصيرةُ النظر، تعيشُ على شذراتِ نصوصٍ نارية، وتصّعدُ القوى السياسية الاجتماعية المتعصبة، وتخربُ العلاقات الإسلامية والإنسانية، لكونها بلا فكر ديمقراطي إنساني رحب، وقد غيبتْ التوحيدَ فأُصيبتْ بالأنيما الوطنية القومية.
التراجعُ واسعٌ عن الإرث الإنساني، والتمحور والانغلاق على الذوات الماضوية، يتبعه عداءٌ للأشكال والأنواع الفنية والأدبية، ولروح الحرية والفرح والتوهج، وتغدو النصوص الإبداعية ملغاةً منبوذة، لأنها تحملُ وهجَ الحياة المتنوعة، وعطاءات الإنسانية التعددية العصرية حيث البشرية معمل روحي خلاق مشترك.
إنهيارُ العقلانيةِ في الثقافةِ البحرينية
كان الهجومُ على الواقعية الاشتراكية ملفتاً للنظر لدى بعض أفراد النخب الثقافية في بدايات الحركة الثقافية البحرينية فقد ظهر ذلك كخوف من تنامي العقلانية ومن خلال أدوات تطوراتها الواقعية المحتملة، وبشكل معاد مبالغ فيه، رغم إن هذه الواقعية الاشتراكية لم تكن سوى كتابات حماسية شبابية.
لكن كانت كراهية التجذر في قراءة الواقع، والارتباط الحميم بثقافة الشعب والأمة، وتحويل العقلانية إلى فعل ثقافي، هي ما يغورُ في الاتجاهات المتذبذبة للفئات الوسطى والصغيرة السائدة في عالم الوعي، وخاصة في عالم الثقافة.
هناك ما يبررُ هذا الخوف جزئياً حين كانت الواقعية الاشتراكية قائمةً على نسخ مشوهة للوعي التقدمي، والتي إعتمدت على الدعاية وتقديم أبطال من ورق.
ولكن مع ذلك كان هذا الوعي الوطني الجنيني الذي يرصد ظاهرات بلده أمراً مهماً، في حين كان التخويفُ يستبطنُ موقفاً إجتماعياً سياسياً معادياً لثقافة الشعب نفسه، رغم اليافطات الكبيرة المرفوعة لهذا.
الابتعادُ عن تحليل الواقع، وعدم متابعة التجارب الحقيقية، ورفدها بالخبرة الثقافية البشرية، سوف يسوقُ الألعابَ الأدبية والفنية التي ازدهرت، وخلخلت ثقافة المواقف المسئولة، ويجعل التجريبية الثقافية في القصة القصيرة والقصيدة، والمسرح، والنقد، تعيش حالات من الاضطرابات وعدم تكوين تجربة ثقافية وطنية عميقة، وهذه تتوافق مع وعي سياسي مضطرب يسوق مواقفَ غيرَ عميقة وغير قارئة لقوانين التطور الاجتماعي.
إن الهشاشة، وإضطرابَ الأجناس الأدبية، والأحكام النقدية، وتهافت الدراسات التاريخية، ستكون وعياً نفعياً ذاتياً مستعداً لعملية الانهيار الفكري السياسي في مرحلةِ الطائفية السياسية.
ففي المرحلة الوطنية منذ الستينيات والسبعينيات حين كان ثمة طبقة عاملة بحرينية واسعة، وفئة وسطى نهضوية، وهو ما تجلى في دستور 1973، كانت الارهاصات الأدبية الواقعية والفنية تشير إلى تبلور إبداعي واقعي نقدي، وتنامت هذه حتى في مرحلةِ زوال البرلمان، في تجارب معينةٍ ولزمن معين.
وكان يمكن أن تكون الروايةُ الواقعية تعبيراً عن هذا التنامي العام، لكن بدلاً منها كان المسرحُ التجريبي الذي لم يخلق ثقافةً إبداعية إلا فقاعات من الفوضى والإدعاءات، فكانت ثقافةُ الانكسار تتصاعد: التقوقعُ في القصيدة، وخفوت تطور القصة القصيرة، وإنكسار النقد وتحوله لمقاولات ثقافية شخصية، وسيادة الفوتغرافية في الفن التشكيلي.
كان إنكسارُ العقلانية الوطنية في شتى أشكالها، يتجسدُّ في تصاعدِ لغة المصالح الخاصة: الطب الخاص، التعليم الخاص وغيرهما كثير، فظهر الإبداعُ الخاص!
هي مرحلةُ التقلص من الروابطِ الفكرية المرتبطة بالطبقات، فتغدو المحاولةُ الروائية تجريبيةً داخلية لا تتغلغلُ في تحليل الواقع، ولا يغدو ل(الروائي) مشروع تحليل للواقع، ثم تزداد(الخصوصية) فتصير إرتباطات بالرأسمالية الحكومية.
إن الفئات الوسطى المفكَّكة تكونُ مصالحَها الخاصة، وتشكلُ لغاتٍ مفارقة، فثمة جملٌ يسارية صاخبة، وعلاقاتٌ مصلحية مع الوزارات، فيما يغلبُ التخثرُ الإبداعي في التيارات الأخرى، حيث لا مواقفَ تحليلية، وتسود تذبذباتٌ في إتجاهات عدة، وفي المجموع تتكسر تلك الموجات النقدية الوطنية التي ظهرت من تحليل الغواصين وعمال الجبل والتاريخ الوطني عامة، ولهذا حين تظهر الطائفيةُ السياسيةُ تكون واقفةً على أرضٍ منهارة فكرياً سياسياً، وتغدو البديلَ الزائف للوطنية، مستخدمةً عبارات يسارية صاعقة، ولاعقلانية دينية، وفاشية غائرة تعادي كل تفتح ثقافي وإختلاف.
ولهذا تكون نتائجها مدمرةً على صعيد الأجناس الإبداعية والتنظيمات الأدبية، وتطور الوعي الثقافي الوطني عامة.
ولم تدشن المرحلة الجديدة دعماً للثقافة الوطنية خاصة في السنوات الأخيرة حيث عانت الإصدارات المحلية من أزمة طباعة، وتوجه الكتاب للإصدارات على نفقاتهم الخاصة، مع صعوبات النشر والتوزيع وقلة الاهتمام بالأعمال الأدبية.
تدهورت الثقافة الوطنية عبر التفكك وندرة النتاجات وصعوبات إصدارها وتوزيعها وغياب الاهتمام بها.